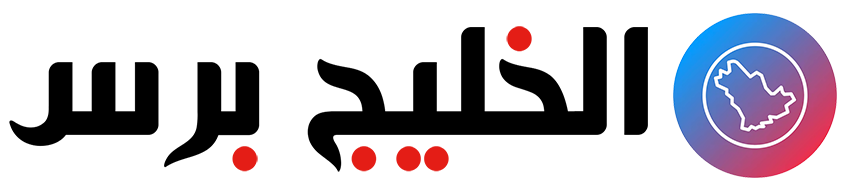حياة السفر في حضارتنا.. عرفت جوازات المرور وقوافلها مدن متنقلة أدارتها النساء وتضمنت 12 ألف جمل وخدمات طبية وأنشطة علمية

وصف شيخ الرحّالين في الحضارة الإسلامية ابن بطوطة المغربي (ت 779هـ/1377م) ما توفره بعض “محامل” السفر في عصره من رفاهية لراكبيها؛ فقال إنه “يَرى الذي بداخلها الناسَ ولا يرونه، ويتقلّب فيها كما يحبّ وينام، ويأكل ويقرأ ويكتب وهو في حال سَيْره، والتي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من هذه العربات يكون عليها [محمل] شبه البيت…، وعليه قُفْلٌ”!!
والواقع أنه لو أتيح لك أن تعاين شبكات الطرق وخرائط حركة المسافرين التي كانت تمسك بعُقَد الجغرافيا الإسلامية في الأزمنة الأولى؛ لوجدت نفسك قبالة عالم مشغول بالحركة والنشاط، مفعم بالحيوية والتواصل، فلم تكن الحضارة الإسلامية لتبلغ ذلك الشأو من التميز والتفرد العالمي لولا تلك الطرق الآمنة والسُّبُل المُذلَّلة والمعابر الممهَّدة، والحركة التي لا تعرف التوقف بين حواضرها المركزية، وبين الأخيرة وجوارها الحضاري في الجهات الأربع.
لقد استمع المسلمون إلى القرآن الكريم فوجدوه يدفعهم نحو السعي في الأرض والمشي في مناكبها، ورأوه يحدثهم عن بسط الرزق وضرورة الخروج لطلبه في أرض الله الواسعة، وحثهم على الهجرة إذا ضاقت أمامهم أوطانهم أو ضُيِّق عليهم في عقائدهم وشعائرهم، كما عَدَّ القرآنُ حمْلَ بني آدم في البَرّ والبحر من أسباب التكريم والارتقاء الحضاري، لما يحققه ذلك من وفرة في العيش ورافد للعقل وزاد للروح.
والحق أن المسلم في زمنه الحضاري الأول لم تكن تكتمل شخصيته العلمية ولا التجارية والسياسية إلا عبر تجواله في جنبات الأرض، واختراق الآفاق طلبا للخبرات بالمعارف والخيرات بالصفق في الأسواق؛ فبسبب هذا التجوال اغتنى العالم الإسلامي بالحواضر الزاهرة بعمرانها المادي والمعنوي، فلم تحتكر الحدودُ المنافعَ والثمرات، ولم تحبس المؤسساتُ القُطْرية المواهب والكفاءات، وقلما عاش عالم أو مثقف في القرون الأولى منعزلا في بيته أو بيئته، بل انساحت العقول في البوادي والحواضر تؤثر وتتأثر، مبرهنة على أن “الرحلة في طلب العلم” قيمة كبرى في الحياة العلمية الإسلامية.
وإذا كان المسلمون قد جاؤوا إلى مواطن حضارات فألْفَوْها قد أقامت سلفًا شبكات الطرقَ والجسور، وتوسعت في تهيئتها وتيسير معابرها للمسافرين؛ فإنهم أضافوا إلى ذلك الميراث الحضاري الإنساني بصماتهم الخاصة، فقاموا بتطوير وصيانة ما ورثوه من منجزاته، ثم رفدوه بالجديد على كل الصُّعُد ذات الصلة بعوالم الأسفار وحياة المسافرين.
فقد شهدت العصور الإسلامية نهضة عمرانية في البنى التحتية لخطوط السفر والتجارة والممرات الدولية، واتسعت وانتعشت في أزمنتهم -عبر تلك الخطوط والشبكات- التبادلات الثقافية والتجارية، وتيسرت روابط التواصل الاجتماعي، وتمهّدت قنوات التفاعل السياسي والدبلوماسي بل والعسكري.
وازدهرت كذلك حركة السفر البحري بين المشارق والمغارب والجنوب والشمال، وعبر مختلف الأنهار والبحار والمحيطات، ثم أضيف إلى مهمة البحارة المسلمين وظائف أخرى تتعلق باستكشاف الأقاليم واقتحام المجاهل، ومحاولة فهم العالم ورسم خرائطه، وتدوين تقاليده البحرية وأشهر معالم أممه وملامح ثقافاته.
والسفر في القديم كان حياة مستقلة ومتكاملة لأصحاب القوافل وهي تجوب المفازات والمسافات الشاسعة طوال أسابيع وربما أشهر، وهي تكاد تكون موازية لحياة التوطن والاستقرار؛ فكان المسافرون يقضون فيها شطرا معتبرا من أعمارهم تتناقلهم القوافل في حلقات أسفار لا تعرف التوقف، لذلك كانت هناك حاجة ملحة لمدّ الطرق بكل الخدمات الممكنة، وتزويد محطاتها بوسائل الراحة والتأمين المتاحة.
ففي هذه الحياة المتنقلة كانت تمارَس الأنشطة الإنسانية على تنوعها واتساعها، ولذا تجاورت في يوميات القوافل أنشطة الأكل والنوم والعبادة والتعليم والمسامرة واللعب، واكتسى كل ذلك بآداب السفر وأدبيات العشرة فيه، والتكافل بتقاسم الزاد وتبادل المنافع والخدمة، والتضامن في لحظات المنغصات من عطش وتيه وعواصف وأمطار وحوادث نهب وسطو، بل وحتى المرض والوفاة.
ويمكن القول إن الأسفار والرحلات في الخبرة الإسلامية كانت تتوفر لها أجهزة إدارية احترافية، تنظم عملها فتخطط حركة القافلة وتضبط أنشطة حياتها رغم تشعبها وضخامة أعدادها وتنوع أعضائها من الرجال والنساء والصبيان، وتضبط مواقيتها انطلاقا ومسيرا ووصولا، وتوفر خدماتها وتسهيلاتها في الحَل والمُرتحَل للمسافرين ودوابهم، وتراعي معايير اتخاذ محطات الطريق أمنيا ولوجستيًّا وخاصة في المسارات الطويلة.
وكان القائمون على تسييرها يملكون خبرة واسعة في إدارة حشود المسافرين ومرافق خدماتهم، وفهم التضاريس البيئية والإلمام بأحوال الطقس والمناخ، وكذلك مراقبة خريطة التوترات السياسية والتحسب للمفاجآت التي تحفل بها الطرق وتوفير البدائل اللازمة، وبالتالي ترتيب آليات حماية القافلة -خلال مراحل التحرك وفي محطات الاستراحة- من قلاع وحصون ودوريات ثابتة ومتحركة، لصدّ عوادي قطّاع الطرق من قبائل الأعراب والجماعات المسلحة كتنظيم القرامطة وعصابات الصليبيين.
كذلك زُودت القوافل باللوازم الطبية الإسعافية، وبشتى احتياجاتها التموينية اليومية، كما عرف مراكب الزمن القديم درجات السفر التي تراوحت من “الدرجة الاقتصادية” إلى “الدرجة الأولى”، وكل ذلك كان ينعكس على مستوى التكلفة المادية، حيث كانت تخصَّص لذلك رواحل الركوب الفارهة، وإقامات الاستراحة الجيدة، وخدمات الطريق والفندقة المميزة.
وفوق ذلك كله عرفت السلطات المحلية الإسلامية تعقيدا إداريا في إجراءات السفر قريبا مما يجري في عصرنا؛ فرغم وحدة دار الإسلام على المستوى الشعوري والمعنوي، فإن أنظمة البلدان الإسلامية وضعت قواعد لتفتيش القوافل العابرة، والتأكد من هُوِّيّات وغايات مرافقيها، وتحصيل الرسوم الجمركية، ومنح الموافقات والتراخيص اللازمة للدخول والمرور والإقامة، على نحو يشبه الترتيبات المعاصرة لإجراءات السفر ووثائقه من جوازات وتأشيرات.
ولئن كان السفر ظل “صناعة” مكتملة الأركان؛ فإنه -مع ذلك كله- كان عملا معرفيا يرفد الحياة العلمية بنقل كل جديد في عالم التأليف من إقليم إلى آخر، ويتحف الأوساط الثقافية بطرائف “أدب الرحلات” الحاوي لتجارب الرحالين الشخصية في السفر والإقامة.
كما سعى المؤلفون المسلمون إلى وضع لطائف المدونات العلمية الخادمة لحياة السفر بكل تعقيداتها؛ فتولّد من ذلك الاعتناء بكتب الجغرافيا الطبيعية والبشرية في جميع عهود الدول والعصور ومختلف أقاليم جغرافيا الإسلام. وقد ظلت تلك الأدلة دومًا بمثابة أدلة إرشادية للمسافرين بما قدمته من معطيات جغرافية عن شبكات الطرق ومسافاتها، ومرافق خدماتها وتسهيلاتها، ومخاطرها وتحدياتها، وبما سجلته من إحصائيات عن تكاليف الرحلات وخاصة أسعار كراء المراكب والأدلّاء والمؤمِّنين لرحلات القوافل.
وبالتالي فقد ظهر مبكرا في حياتنا العلمية والثقافية ما يمكن تسميته بـ”مكتبة المسالك والممالك” التي أنتجت لنا العديد من المصنفات بهذا العنوان، وكانت مصمَّمة لخدمة موظفي الدولة ومؤسسات البريد والاستخبارات وبيت المال، إضافة إلى رجال الأعمال ذوي التجارات العابرة للقارات، بل وعامة ذوي الهوايات في الأسفار والرحلات. وقد عززت معطياتِها تلك نصوصٌ وافرة عن حياة السفر تضمنتها مدونات الرحلات والبلدان والتراجم والتاريخ والنُّظُم الإدارية والمؤسسات الأهلية والرسمية.
هذه ملامح عامة لعوالم “حياة السفر في حضارتنا”.. تلك الحياة التي تحولت إلى ثقافة غنية وصناعة زاهرة ومؤسسية مُحْكَمة؛ وهو ما تسعى هذه المقالة إلى كشف خباياه وإبراز خفاياه، آخذةً بيد قارئها في دروب سَفَر تاريخي وحضاري ثريّ في معطياته بالجدة والطرافة، ومفعم في سرديته بالإمتاع والانتفاع!
أغراض وأنواع
السفر ظاهرة إنسانية عرفها البشر -بجميع أعراقهم وآفاقهم- منذ أوجدهم الله تعالى في هذه الأرض، وامتنّ عليهم بتيسير سُبُله وطرقه فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾؛ (سورة نوح/الآيتان: 19-20)، وتفضل عليهم بتسهيل وسائله ووسائطه فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾؛ (سورة الإسراء/الآية: 70)، وقال مبينا وسائل السفر المعروفة للناس وقت التنزيل وتلك التي ستأتي بها المخترعات في المستقبل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ (سورة النحل/الآية: 8).
كما أرشدهم إلى ما يرتبط بالسفر من منافع وفوائد تعود على الإنسان؛ فقال: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآخرُون يُقاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ﴾؛ (سورة المزمل/الآية: 20). وفي هذه الآية قرن الله تعالى بين السعي للتجارة والنفير للجهاد طلبا لفضله المادي والمعنوي، ومساويا بينهما في كونهما سببا لتخفيف التكاليف على المسافرين مراعاة لحالهم لأن «السفر قطعة من العذاب»؛ كما ورد في الحديث النبوي المتفق على صحته.
وقد تنوعت أهداف وغايات السفر في فضاءات الحضارة الإسلامية وتعددت حتى شملت مختلف الأغراض الإنسانية؛ فكان بعضها لدواعٍ دينيّة كالجهاد والحجّ وطلب العلم، وأخرى لدوافع سياسية أو تجارية، أو لغايات سياحية واستكشافية خالصة.
فعن النوع الأول مثلا؛ يخبرنا المؤرخ ظهير الدين ابن فَنْدَمَه البيهقي (ت 565هـ/1170م) -في ‘تاريخ بَيْهَق‘- عن استمرارية “القوافل القادمة مما وراء النهر الذاهبة لزيارة الكعبة” المشرفة، كما يفيدنا ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) -في ‘معجم الأدباء‘- بأن معاصره الإمام شرف الدين محمد بن عبد الله ابن أبي الفضل المُرْسي السُّلَمي (ت 655هـ/1257م) ربما كان آخر الأندلسيين ذوي الأسفار الواسعة ذات الصبغة العلمية.
فهذا الإمام الموسوعي الجوّال “خرج من بلاد المغرب سنة سبع وستمئة (607هـ/1210م)، ودخل مصر وسار إلى الحجاز، ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغداد وأقام بها يسمع ويقرأ الفقه والخلاف والأصلين بالنظامية، ورحل إلى خراسان ووصل إلى مَرْو الشَّاهِجَانِ (= اليوم عاصمة منطقة ماري بدولة تركمانستان)، وسمع بنيسابور وهراة ومَرْو ولقي المشايخ، وعاد إلى بغداد، وأقام بحلب ودمشق، ورأيتُه بالموصل، ثم حج ورجع إلى دمشق، ثم عاد إلى المدينة [النبوية] فأقام على الإقراء، ثم انتقل إلى مصر… سنة أربع وعشرين وستمئة (624هـ/1227م)”.
وعن السفر لأغراض التجارة؛ فقد كانت القوافل التجارية من الكثرة في كل اتجاه بحيث يتعذر حصرها، وفقا لما يصوره لنا مثلا الرحالة الأندلسي ابن جُبير الكِنَاني (ت 614هـ/1217م) في طريق واحد للتجارة الدولية، كان يربط بين مدينتيْ قُوص وعَيْذاب (= ميناء كان على البحر الأحمر) جنوبي مصر، وذلك بقوله في كتاب رحلته: “ورُمْنا في هذه الطريق إحصاءَ القوافل الواردة والصادرة فما تمكن لنا، ولاسيما القوافل العَيْذابية المُتحمِّلة لسلع الهند الواصلة إلى اليمن، ثم من اليمن إلى عَيْذاب”.
وأما السفر للأغراض السياحية؛ فقد زودتنا كتب التاريخ والتراجم والبلدان بكم وافر من المعطيات بشأنه، ولاسيما ما تعلق منها برجالات التصوف الذين كان لهم باع كبير في هذا المجال، حتى إنهم كادوا يختصون بالسياحة في الأرض من بين الناس باعتبارها “طريقة قدماء الصوفية المحققين وذوي السياحة المتجولين”؛ على حد تعبير الحافظ المحدِّث ابن أبي نصر الحُمَيدي الأندلسي (ت 488هـ/1095م) في كتابه ‘جذوة المقتبِس في ذكر وُلاة الأندلس‘.
كما حفلت مصنفات “الزيارات” و”المزارات” بطائفة واسعة من أخبار وقصص المسافرين المغامرين في أسفار ذات دوافع سياحية واستكشافية، ولعل في طليعة تلك التصانيف كتاب «الإشارات إلى معرفة الزيارات» للصوفي الجوال في الآفاق أبي الحسن علي بن أبي بكر الملقب بـ”السائح الهَرَوي” (ت 611هـ/1214م).
ويذكر قاضي القضاة المؤرخ شمس الدين ابن خلّكان (ت 682هـ/1281م) -في ‘وفيات الأعيان‘- أن الهَرَوي هذا كان مولعا باستكشاف الآفاق والكتابة على الجدران، فيقول إنه “لم يترك بَرًّا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلًا من الأماكن -التي يمكن قَصْدُها ورؤيتها- إلا رآه، ولم يصل إلى موضع إلا كَتَبَ خَطَّه في حائطه. ولقد شاهدتُ ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها”!!
ويضيف ابن خلّكان أن الهَرَوِي “من كثرة زياراته وكَتْبِ خَطِّه” على الجدران في البلدان والمزارات -التي وصل إليها- صار يُضرب به المثل في التطواف والسياحة، حتى قال أحدهم يصف آخر:
قد طَبّق الأرضَ مِنْ سَهْل إلى جَبَل * كأنه خَطُّ ذاك «السائحِ الهَرَوِي»!!

السفر البري
بطبيعة الحال؛ لم يعرف الأقدمون السفر إلا برًّا أو بحرًا، فأما السفر البري فغالبا ما يتم عبر مصاحبة القوافل التي كانت الوسيلة الأنسب للسفر الآمن من الآفات والعقبات، وخاصة قُطّاع الطرق “ممّن يعترض الرفاق (= القوافل) ويُفسد السبيل”؛ وفقا للوزير الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي (ت 776هـ/1374م) في ‘الإحاطة في أخبار غرناطة‘.
وتفاديا لمعظم تلك العقبات ولحرارة النهار -وخاصة في البلاد الصحراوية- فإن “الْمُسَافِر -فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ- إِنَّمَا يَمْشِي فِي اللَّيْلِ وَفِي أَوَّلِ النَّهَارِ”؛ طبقا للإمام الفخر الرازي (ت 606هـ/1209م) في تفسيره ‘مفاتح الغيب‘.
وكانت وسيلة النقل البري الشائعة -مع القوافل أو بدونها- هي الجمال والخيل، وربما استُخدمت في السفر البغالُ والحمير والبقر في البلدان ذات التضاريس الجبلية أو الثلجية، كما هو حال سكان وسط آسيا الذين يذكر الرحالة ابن بطوطة (ت 779هـ/1377م) -في كتاب رحلته- أنهم يستخدمون في أسفارهم “عَجَلات (= عَرَبات) تكون للواحدة منهنّ أربع بَكَرَات (= جمع بَكْرَة: خشبة/حديدة مستديرة داخلها محور تدور عليه) كبار، ومنها ما يجرّه فَرَسان، ومنها ما يجرّه أكثر من ذلك، وتجرّها أيضا البقر والجمال على حال العربة [الحاملة للمسافر] في ثقلها أو خفّتها”.
بل إن هذا الرحالة الجوال يخبرنا أن بلاد روسيا في عصره “السفرُ إليها لا يكون إلّا في عجلات صغار تجرّها كلاب كبار، فإن تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدميّ ولا حافر الدابّة فيها، والكلاب لها الأظفار فتثبت أقدامُها في الجليد…، والدليل (= مرشد الطريق) بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مرارا كثيرة، وتنتهي قيمته إلى ألف دينار (= اليوم 200 ألف دولار أميركي تقريبا) ونحوها، وتُربط العَرَبَة إلى عنقه ويُقرن معه ثلاثة من الكلاب، ويكون هو المقدَّم وتتبعه سائر الكلاب بالعربات فإذا وقف وقفتْ” الكلاب الأخرى!!
وقد يبلغ حجم القافلة أحيانا آلاف الجمال المحملة بالمسافرين والأمتعة التجارية وغيرها؛ ففي مطالع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي يخبرنا الفقيه الرحالة ابن فضلان البغدادي (ت بعد 310هـ/922م) -في كتاب رحلته إلى جنوبي روسيا- أنهم باغتهم مطر شديد في بعض مراحل الطريق “فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلاف رجل”!!
وفي نهاية القرن الثامن الهجري/الـ14م؛ يروي المؤرخ ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) عن أحد أعيان منطقة الغرب الأفريقي أن قافلة لـ”تجار المشرق [وصلت] إلى بلد مالي [فـ]ـكانت ركابهم اثني عشر ألف راحلة”!!
وحتى في العصور المتأخرة من تاريخ التجارة القديمة بالعالم الإسلامي؛ ظلت القوافل التجارية ت ضم أعدادا ضخمة من الجمال حتى إن الجبرتي يروي أنه في سنة 1202هـ/1787م “نهب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة من السويس [إلى القاهرة]، وفيها شيء كثير جدا من أموال التجار والحُجاج، ونُهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل ما بين قماش وبَهَار (= التوابل) وبُنٍّ وأقمشة وبضائع، وذلك خلاف أمتعة الحجاج”!!
وفي الأسفار الرسمية قد يخصَّص ألفُ جمل لحمل متاع شخص واحد من كبار رجال الدولة؛ فقد حكى القاضي أبو علي المحسن التَّنُوخي (ت 384هـ/994م) -في ‘الفَرَج بعد الشِّدة‘- أن الوزيرين العباسييْن الفضل بن الربيع (ت 208هـ/823م) والحسن بن سَهْل (ت 233هـ/851م) كان كل منهما يحمل “ثِقَله (= متاع رحيله) على ألف بعير”!!
وقد يكون لأحد التجار الكبار عشرات المراكب لحمل مؤنة سفره وحدها؛ حسبما يفيدنا به ابن بطوطة في وصفه لمنطقة شمالي القوقاز وجنوبي روسيا التي قصدها لزيارة سلطانها المغولي المسلم محمد أوزبك خان (ت 742هـ/1341م)، فقال إن تلك البلاد “لا يدخلها إلّا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدهم مئة عَجَلَة -أو نحوها- مُوقَرَة (= محمّلة) بطعامه وشرابه وحطبه، فإنّها لا شجر فيها ولا حَجَر ولا مَدَر (= الطين الصلب)”!
واقتداءً بالهَدْي النبوي في السفر الآمر بأن يكون للركب “أمير” يكون ذا سيرة حسنة ومعروفا بالكفاءة والأمانة، ويتولى اتخاذ قرارات الرحيل والإقامة أثناء السفر؛ فقد كان لكل قافلة مدير يسمى “أمير/شيخ الركب” أو “رئيس/شيخ القافلة”، يقوم بإدارة شؤونها والسهر على حمايتها ورعاية مصالحها، ويساعد الأشخاص فيما يعترضهم من نزاعات ومشكلات أثناء سفرهم.
ولتمكينه من تحمل تلك الأعباء الإدارية؛ قرر الفقهاء أن “أمير القافلة… له سلطنة” على من تحت إمرته في القافلة شأنه في ذلك شأن الوالي الإداري الرسمي في منطقة ولايته؛ وفقا للفقيه الحنبلي منصور بن يونس البُهُوتي (ت 1051هـ/1641م) في ‘كشاف القناع عن الإقناع‘. ولعل الفقهاء قاسوا غمارة القوافل في العموم على إمارة ركب الحج الرسمي خاصة التي يسمونها «ولاية الحج»، وقد ذكر الإمام أبي الحسن الماوردي (ت 450هـ/1059م) -في ‘الأحكام السلطانية‘- أن مسؤولية “تسيير الحجيج… ولايةُ سياسةٍ وزعامةٍ وتدبيرٍ، والشروط المعتبرة في المُولَّى [عليها] أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية”.
وكما هو الحال اليوم؛ فإن سفر الحجاج خاصة كان يرتبط بالدولة التي يتبعون لها سياسيا، ويتولى عادة قيادة ركب الحج موظف كبير معيّن من السلطة، بعد أن تتوفر فيه الشروط التي نقلناها آنفا عن الماوردي الذي يحدد مهمات قائد قافلة المسافرين للحج في الأمور العشرة التالية، وهي تصلح -في العموم- لأن تكون اختصاصات لرؤساء القوافل الأخرى أيا كان غرضها ووجهتها؛ قال الماوردي:
“والذي عليه (= أمير قافلة الحج) في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء:
1- جَمْعُ الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا، فيخاف التوى (= الهلاك) والتغرير (= الضياع).
2- ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا (= رفقة)، حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار، ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه.
3- أن يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم…؛ [فـ]ـمَنْ ضَعُفتْ دوابُّه كان على القوم أن يسيروا بسيره.
4- أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها.
5- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعتْ، والمراعي إذا قلّتْ.
6- أن يحرسهم إذا نزلوا، ويَحُوطهم إذا رحلوا، حتى لا يتخطَّفهم (= يسلبهم) داعر (= المُؤذِي الفاجِر)، ولا يطمع فيهم متلصص.
7- أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه، أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه، ولا يسعه أن يُجْبر أحدا على بذل الخفارة (= رسوم التأمين) إن امتنع منها، حتى يكون باذلا لها عفوا، ومجيبا إليها طوعا.
8- أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا، إلا أن يفوَّض الحكم إليه.
9- أن يقوِّم زائغهم ويؤدِّب خائنهم، ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يُؤْذَن له فيه [ممن ولّاه].
10- أن يراعي اتساع الوقت حتى يُؤْمَن الفوات، ولا يُلْجِئهم ضيقُه إلى الحث في السير”.
وقد يكون قائد الركب أعلى الناس فيه منصبا أو مكانة ولو كان امرأة؛ فالرحالة ابن جبير يقصّ علينا مسيره ضمن قافلة للحجاج المشرقيين تضم “خاتونين” (أميرتين) سلجوقيتين، فيقول: “وهاتان الخاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه”.

آليات وتجهيزات
والآلية المعتمدة في إعلام قيادة القافلة للمسافرين فيها بقرارات الانطلاقة والتوقف للراحة هي “طبل الرحيل” أو “طبول المحمل”، والنفخ في أبواق معدّة لذلك، على النحو الذي يصف به ابن جبير إحدى قوافل الحج السلطانية، فيقول: “ومن عجيب هذه المحلة (= المعسكر المتنقل) أيضا -على عِظَمها وكبرها وكونها وجود دنيا بأسرها- أنها إذا حطت رحالها ونزلت منزلها، ثم ضرب الأمير طبله للإنذار بالرحيل… لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارها (= أحمالها) ورحالها وركابها إلا كـ«لا ولا» (= مدة نطق الحرفين)، فلا يكاد يفرغ الناقر من الضربة الثالثة إلا والركائب قد أخذت سبيلها” منطلقة!!
ويحدثنا الأديب الحجازي محمد كِبْرِيت الحسيني المولوي (ت 1070هـ/1659م) -في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘- عن تجهيزات “المحامل السلطانية” (قوافل الحج الرسمية) وترتيباتها في أسفارها، ومما يذكره في ذلك أن “الركب المصري” كان من عادتهم -في عصره- أنهم “إذا نزلوا منزلا أو رحلوا منه تُدَقّ الكوسات (= الطبول) وينفر النفير ليُؤْذَن بالنزول والرحيل”.
ويبدو أن تقليد استخدام الطبل لم يكن مقتصرا على القوافل، بل استخدمه المسافرون عموما حتى ولو كانوا جماعات من البدو الرُّحَّل، وهو ما كان معروفا مثلا لدى سكان صحراء بلاد شنقيط (موريتانيا اليوم) ويسمونه “طبل الرحيل”، وفي شأنه يقول الشاعر محمد يَقْوَى بن مَيْلُود الدَّيْمَاني الفاضلي الشنقيطي (ت 1304هـ/1886م) مبينا دلالات ضربه عندهم لحظة السفر وأثناءه:
ضَربوا الطبلَ للرحيل ثلاثا * واستمروا يُقَوِّضُون الأثاثا
ثم شَدُّوا رحالَهم فــوق بُزْلٍ * من بنات الجَدِيلِ لَسْنَ غِرَاثا
فإذا ضَلَّ أو تَخَـلَّفَ رَكْبٌ * ضَربوا الطبلَ عند ذاك ثلاثا
وأحيانا تكون لرئيس القافلة -مع الطبول والأبواق- أعلامٌ ترفع إيذانا بوقت المسير، ولعل الأصل في ذلك تقليد كان متبعا في سفر السلاطين خاصة ولاسيما عند خروجهم للحرب، ولذلك كان من تدابير التعبئة الحربية أن الأمراء أو قادة الجيوش إذا أراد أحدهم أن يفاجئ عدوه “ركب سرا وَلَمْ يَضْرِبْ طَبْلًا، وَلَمْ يَنْشُرْ عَلَمًا، وأمر الناس بالسكوت وجَدَّ في السَّيْر” حتى يأخذ جيش خصمه على حين غِرَّة؛ كما جاء في قصة أوردها الإمام المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) في كتابه ‘الكامل‘.
وبعد تلك الواقعة بخمسة قرون؛ كان هذا التقليد سائدا في الدولة المملوكية طبقا للمؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1441م)، الذي يذكر -في كتابه ‘السلوك لمعرفة الملوك‘- أنه في يوم 25 ذي القعدة 791هـ/1389م عزم السلطان المملوكي برقوق (ت 801هـ/1398م) على السفر إلى الشام “فرسم السلطان بتعليق الجاليش (= الشاليش: راية كبيرة في أعلاها قطعة من شعر الخيل) بالطبلخاناة (= مقر فرقة الموسيقى العسكرية) ليعلم الناس بالسفر إلى الشام”.
والظاهر أن هذا التقليد السَّفَري استخدمه أمراء القوافل عموما؛ فالوزير الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب يخبرنا -في ‘الإحاطة في أخبار غرناطة‘- أن أبناء أسرة آل المَقّري التلمسانية -التي ينتمي إليها مؤلف كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»- أسّسوا شركة عائلية للتجارة في منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى، وكانوا يسيّرون قوافل التجارة بينها وبين أقطار المغرب “فمهّدوا طريق الصحراء بحفر الآبار، وتأمين التّجار، واتخذوا طبل الرّحيل وراية التّقدم عند المسير”.
ومن التجهيزات الأخرى التي كانت تصاحب القوافل: المصابيحُ التي تنير لها الطريق ليلا في دياجير الليالي المظلمة، والتي يحدثنا ابن جبير عنها بقوله: “وإسراؤها (= القافلة) بالليل بمشاعيل موقدة يمسكها الرجّالة بأيديهم، فلا تبصر قَشاوة (= تعريب «كَجَاوة»: لفظة فارسية معناها تابوت مجوَّف كالهودج يحمل المسافر) من القَشاوات (= الكَجَاوات) إلا وأمامها مشعل، فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة توضح غسق الظلماء، وتباهي بها الأرضُ أنجمَ السماء”!!
ومن تجهيزات القوافل الطريفة تعليق الأجراس في بعض دوابها لأنها فيها “منفعة جَمَّة، منها: إذا ضَلَّ واحد من القافلة يلتحق بها بصوت الجرس، ومنها أن صوت الجرس يُبْعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره، ومنها أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب، وهو نظير الحَدْو (= الحُداء)… لأنه يزيد في نشاط الدواب”؛ حسب الفقيه برهان الدين ابن مازَة البخاري الحنفي (ت 616هـ/1219م) في ‘المحيط البرهاني في الفقه النعماني‘.
ومن مسؤوليات رئيس القافلة الحرص على تطبيق التقاليد والعوائد المرعية في حياة السفر، ومنها أن العادة جرت بأن “القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج” بعد أن يكون المسافرون على علم بموعد انطلاقة رحلتها؛ حسب المؤرخ اليمني بهاء الدين الجَنَدي (ت 732هـ/1332م) في ‘السلوك في طبقات العلماء والملوك‘. ومن تلك التقاليد السفرية أنه عند الرحيل تكون “العادة في القافلة تقديم الضعيف والرجّالة”؛ وفقا للإمام جلال الدين السيوطي (ت 911هـ/1505م) في ‘معترك الأقران‘.
ويفيدنا الرحالة ناصر خُسْرَوْ البَلْخي (ت 481هـ/1087م) بأن أهل مصر كان لهم موعد سنوي محدد لانطلاق قافلة الحج الرسمية، وتحديدات ثابتة لما ستستغرقه في رحلتها ذهابا وعودة؛ فيقول: “ويبدأ الناس في السفر ابتداء من أول ذي القعدة، وينزلون في موضع معين، ثم يسيرون في منتصف هذا الشهر…، ويبلغون مكة في خمسة وعشرين يوما، ويمكثون بها عشرة أيام، ثم يعودون إلى مصر في خمسة وعشرين يوما”.
وعن اتباع تقليد الجدولة الزمنية للرحلات في السفر البحري؛ يقول ابن بطوطة إن ربابنة السفن في جنوبي الهند كانوا “يختارون للسفر من أيام الشهر: ثانيه، أو سابعه، أو الثاني عشر، أو السابع عشر، أو الثاني والعشرين، أو السابع والعشرين”.
ويُفهم من قصة لأحد القادة العسكريين في أيام الخليفة العباسي المعتصم (ت 227هـ/842م) أنه ربما كان للمسافرين لباس خاص يعرفون به، على الأقل في بعض المناطق؛ فقد ورد في قصة هذا القائد أنه حين أراد الخروج “تزيّا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل”؛ حسب ابن عبد المنعم الحِمْيري (ت بعد 710هـ/1310م) في ‘الرَّوْض المِعْطار في خبر الأقطار‘.
ومن مسؤوليات شيخ القافلة أيضا تفقد المسافرين قبل انطلاق القافلة وإرجاع الضائع منهم إلى رفقته فيها؛ خاصة أن المسافرين في بعض القوافل يكثرون بحيث “لا يُحصَى عددهم، تموج بهم الأرض موجا ويسيرون سير السحاب المتراكم، فمن خرج عن الركب لحاجة -ولم تكن له علامة يَستدِلّ بها على موضعه- ضلَّ عنه لكثرة الناس”؛ وفقا للرحالة ابن بطوطة الذي يخبرنا بضياع أحد رفقائه في قافلة بعد أن دخل مع مسافر آخر في “منازعة ومشاتمة، فتأخَّر عن الرفقة فضلّ، فلما نزل الناس لم يظهر له خبر…، وانتَدب (= بادر) في اليوم الثاني رجل من مَسّوفة (= قبيلة صنهاجية) -دون أجرة- لطلبه، فوَجد أثَرَه وهو يسلك الجادة طورا ويخرج عنها تارة، ولم يقع له على خبر”!
ومن قصص ذلك أيضا ما يحكيه ابن جبير في معرض حديثه عن ضخامة قافلة الحج العراقي ودقة تنظيمها حسب بلدان المسافرين، فيقول عمن يضيع في القافلة: “وربما اضطرته الحال إلى الوصول إلى مضرب الأمير (= أمير القافلة) ورَفَع مسألته (= قصته) إليه، فيأمر أحد المنشِدين (= مبلّغي أوامر القيادة للقافلة)… ممن قد أعِدّ لذلك أنْ يردفه خلفه على جمل، ويطوف به المحلة العَجّاجة (= الضخمة)، وهو قد ذَكر له اسمه واسم جمّاله واسم البلد الذي هو منه، فيرفع عقيرته بذلك معرِّفا بهذا الضال ومناديا باسم الجمّال وبلده، إلى أن يقع عليه فيؤديه إليه. ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه، إلا أن يلتقطه التقاطا أو يقع عليه اتفاقا” بسبب حجم القافلة الهائل!
ويبدو أن هذا النظام الدقيق في ضبط مخيمات القوافل -مهما تضخمت أحجامها- ظل قائما حتى مطالع القرن العشرين؛ فالعلامة اللبناني محسن الأمين الحسيني العاملي (ت 1371هـ/1952م) يحدثنا -في كتابه ‘معادن الجواهر ونزهة الخواطر‘- عن رحلته في الركب الشامي إلى موسم الحج سنة 1321هـ/1903م أواخر الدولة العثمانية؛ فيقول:
“وخِيّام كل قافلة لها جِمال مخصوصة وأناس مخصوصون يُسمَّوْن «المَهاتِرة»، يسبقون الحاج وينصبونها أول يوم على ترتيب خاص لا يتعدونه إلى آخر السفر، وخيام كل قافلة في مكان مخصوص لا تتعداه: هذه أولاً وتلك بعدها وهكذا، وكذلك كل خيمة لها مكان مخصوص لا تتعداه، وخيام كل قافلة كأنها بلد بنفسها بأزقتها وبيوتها لا تتغير، فلو ضلَّ إنسان -في حال السير أو النزول- يهتدي إلى مكانه بأيسر ما يكون”!!
ومما يتصل بتلك المسؤولية دور أمير القافلة في رد المفقودات من ممتلكات المسافرين، وربما رصد مكافأة لمن يأتي بها منهم؛ فالقاضي التَّنُوخي يروي لنا -في كتابه ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة سقوط جمل من قافلة في مستنقع مائي، وكان “على الجمل أكثر من عشرة آلاف دينار” من القماش الحريري، فاهتمّ أمير القافلة بأمر الجمل “فنادى في القافلة: مَنْ ينزل ويخلّص الجمل ويرده إلى صاحبه وله ما يشاء؟”، فابتدر لذلك أحد المسافرين في القافلة حتى استعاد بعض المال.

السفر البحري
أما عن السفر البحري والنهري؛ فقد وفرت الأساطيل البحرية الإسلامية خيارات متنوعة ووافرة في وسائله ومتطلباته، وبأعداد سفن هائلة في البلد الواحد، حتى إن الإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) يذكر -في ‘تاريخ بغداد‘- أنه أحصيت سفن نهر دجلة “فكانت ثلاثين ألفا” في اليوم الواحد أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي! وحين سجّل الرحالة ابن بطوطة مشاهداته بمصر قال “إن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية، تمرُّ صاعدةً إلى الصعيد ومنحدِرةً إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق”!!
وفي منطقة الغرب الإسلامي؛ يقول مؤرخ الحضارات الأميركي وِلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في كتابه ’قصة الحضارة’- إنه كان للمسلمين في الأندلس وحدها “أسطول تجاري يزيد على ألف سفينة يحمل غلّات الأندلس ومصنوعاتها إلى إفريقية وآسية، وكانت السفائن القادمة من مئة ثغر وثغر تزدحم بها”!!
وقد تنوعت فئات السفن التي استخدمها المسلمون في أساطيلهم الحربية والتجارية وحتى في مجالات السياحة والمواصلات، فخصصوا لكل طبقة من الناس ما يلائمها من المراكب البحرية، وأفردوا لكل ميدان ما يناسبه من السفن المتعددة الأشكال والأحجام، والمختلفة الأهداف والوظائف، والمتفاوتة السرعات والقدرات والتجهيزات.
وكما كان لعامة الناس سفنٌ لأسفارهم وتنقلاتهم؛ فقد خُصّص لعلية القوم من الأمراء والوزراء والولاة وكبار التجار سفنهم المجهزة بما يناسب مراتبهم من الأبهة ومرافق الراحة، ولذلك يحدثنا ابن بطوطة -في رحلته- عن وجود أنواع من السفن مخصصة “للسلطان والرعية”، ويذكر أنه انتقى لنفسه في إحدى رحلاته الدبلوماسية “مركبا حسنا من المراكب المعدة لركوب الأمراء”.
وكان نشاط النقل بالسفن -تجارةً وسياحةً- ذا أرباح طائلة؛ فقد كان الناس يستخدمونها في التحرك خلال مناشطهم اليومية وفي متنزهاتهم الخاصة، فحين تعرض أبو الحسن الشابُشْتي (ت 388هـ/999م) -في كتابه ‘الديارات‘- للحديث عن “عيد دَيْرِ أشموني” المسيحي بالعراق وصفه بأنه “من الأيام العظيمة ببغداد، [إذ] يجتمع أهلها إليه كاجتماعهم إلى بعض أعيادهم، ولا يبقى أحد من أهل التطرب واللعب إلا خرج إليه، فمنهم في [سفن] الطيارات ومنهم في الزبازب والسُّميريات، كل إنسان بحسب قدرته”!
ويورد الحافظ الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) -في ‘تاريخ بغداد‘- معطيات عن مداخيل خدمات النقل البحري بالعراق؛ فيقول إنه “أحصِيت السُّمَيْرِيّات (= نوع من السفن) المَعْبَرانِيّات (= العبّارات/المُعديات) بدجلة في أيام.. [الأمير العباسي] طلحة الموفَّق (ت 278هـ/891م) فكانت ثلاثين ألفا، قُدِّر مِن كسب ملّاحيها في كل يوم تسعون ألف درهم (= اليوم 180 ألف دولار أميركي تقريبا)”!
وكان من أنواع المراكب المستخدمة في السفر النهري -في بلد أنهار مثل العراق- مركب يدعى “السُّمَيْرية”، وهو وسيلة مناسبة للتنقل في نهر دجلة بين مدن بغداد وواسط والبصرة وغيرها، وهناك أيضا “الزلال” و”الطيار” وهما سفينتان أنيقتان صغيرتا الحجم، ويركبهما في الغالب أصحاب المكانة من الأمراء والوزراء وكبار التجار.
وربما جُهِّز المركب النهري بأدوات لتبريد الجو؛ فقد سافر الوزير العباسي عمرو بن مسعدة الصُّولي (ت 217هـ/832م) فوصف سيره -كما يرويه التنوخي في ‘الفرج بعد الشدة‘- قائلا: “وسرت حَتَّى قدمت بَغْدَاد وَلم أقِم بهَا إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام، وانحدرت مِنْهَا فِي «زلال» أُرِيد الْبَصْرَة، وجُعل لي فِيهِ خَيْش (= قماش مبلَّل للتبريد)، واستكثرت من الثَّلج لشدَّة الْحر”.
ونظرًا لطول زمن الأسفار والرحلات في البحار حتى إنها كانت تبلغ أحيانا عدة أشهر؛ فقد صمم المسلمون سفنًا عملاقة للتجارة والنقل، وزوّدوها بكل ما يضمن راحة ركابها وحاجياتهم التموينية، فكانت تحتوي على مرافق للنوم وأخرى للطبخ والاستحمام، وكان يخُصّص فيها قسم كبير لتخزين الطعام بما يكفي مئات الركاب أو آلافهم؛ كما سنرى في نص لابن جبير. بل إن بعض السفن يكون متعدد الطبقات والأدوار فتصبح إحداها أشبه بمدينة عائمة، كما تتعدد البضائع والسلع المعروضة فيها للبيع إلى الركاب فكأنها سوق جامعة متنقلة!
ويحدثنا الرحالة ابن جبير الأندلسي عن مشاهداته للحياة على هذه السفن العملاقة؛ فيقول إنه أثناء عودته من المشرق إلى الأندلس سنة 581هـ/1185م سافر في سفينة كبيرة، وأثناء الرحلة “قلَّ الزادُ بأيدي الناس، لكنهم [كانوا] مِن هذا المركب -بمنة الله- في مدينة جامعة للمرافق، فكلُّ ما يُحتاج شراؤه يوجد: من خبز وماء، ومن جميع الفواكه والأُدْم (= جمع إدامٍ)، كالرمان والسفرجل والبطيخ السندي والكمثرى..، والجوز والحمص والباقلاء -نَــيْئاً ومطبوخا- والبصل والثوم والتين والجبن والحوت، وغير ذلك مما يطول ذكره؛ عاينّا جميع ذلك يُباع” داخل السفينة!!
ويصف ابن بطوطة -في رحلته- سعة السفن في بحار الهند الإسلامية والصين؛ فيقول إن بعضها يتكون من “أربعة ظهور (= طوابق)، ويكون فيه البيوت والمَصاري (= جمع مصرية: جناح مفرد بمرافقه) والغرف للتجار، و«المصرية» منها يكون فيها البيوت والسنداس (= الحمّام)، وعليها المفتاح يسدها صاحبها ويحمل معه الجواري والنساء، وربما كان الرجل في مصريته فلا يَعرف به غيرُه ممن يكون بالمركب..، و[رجال] البحرية يُسْكِنون فيها أولادهم ويزدرعون (= يزرعون) الخُضَر والبقول والزنجبيل في أحواض خشب”!
ومن الترتيبات المتبعة في تنظيم الركاب في السفينة أنه إذا تعددت ديانات المسافرين عليها حصل فصل بينهم “وحاز المسلمون مواضعهم بانفراد عن الإفرنج” أي الأوروبيين، وذلك بعد أن “صعده من النصارى المعروفين بالبلغريين -وهم حجاج بيت المقدس (= لعل «البلغريين» هي أصل كلمة pilgrim أي: الحاجّ)- عالَمٌ لا يُحصَى ينتهي إلى أزيد من ألفي إنسان”!! وربما يرجع ذلك الفصل إلى اختلاف الشعائر وقواعد الحلال والحرام في المطعم والمشارب، وقد احتفل المسيحيون بالكريسماس في السفينة أثناء سفرهم.
ومن غرائب قواعد السفر البحري قديما -وخاصة في الجوار الأوروبي- أنه إذا مات المسافر في البحر ورثه ربّان السفينة، بغض النظر عن ديانة الميت؛ ومن أمثلة ذلك ما يذكره الرحالة ابن جبير قائلا: “ومات فيه (= المركب) رجلان من المسلمين… فقُذفا في البحر، ومن البلغريين اثنان أيضا، ومات منهم بعد ذلك خَلْقٌ…، وورث هؤلاء الأمواتَ -من المسلمين والنصارى البلغريين- رئيسُ المركب، لأنها سُنَّة (= عادة) عندهم في كل من يموت في البحر، ولا سبيل لوارث الميت إلى ميراثه، فطال عجبنا من ذلك”!!

درجات وتسهيلات
رغم أن الكل يتساوى في ركوب الدواب المستخدمة في السفر البري؛ فإن التفاوت كان يحصل في التسهيلات ووسائل الإيواء المرافقة للقافلة، وكما نجد اليوم حافلات النقل الجماعي ذات الخِدْمات الفاخرة، والحافلة المتوسطة الخدمة، فإن حضارتنا عرفت أنواعا مختلفة مشابهة لدرجات الرحلات هذه في تفاوتها.
فالرحالة ابن جبير يقدم لنا وصفا طريفا ودقيقا لما يمكن تسميته «درجات الرحلة» وتسهيلات الراحة فيها، مما شاهده في موكب الحج العراقي الذي هو أضخم المواكب التي رآها في تطوافه في المشرق الإسلامي؛ فيقول إن “لهم… في مراكبهم على الإبل قباب تُظِلُّهم بديعة المنظر عجيبة الشكل، قد نُصبت على محامل (= هوادج) من الأعواد يسمونها «القشاوات» وهي كالتوابيت المجوَّفة، هي لركابها من الرجال والنساء كالأمهدة (= جمع مِهاد) للأطفال، تُملأ بالفُرُش الوثيرة، ويقعد الراكب فيها مستريحا كأنه في مهاد ليّن فسيح، وبإزائه مُعادِلُه (= عديله في المحمل) أو مُعادِلتُه في مثل ذلك من الشُّقّة (= الجانب) الأخرى، والقبة مضروبة عليهما، فيُسارُ بهما وهما نائمان لا يشعران أو كيفما أحبا”!!
ولا تقتصر التسهيلات الفائقة الراحة على أوقات المسير، بل تتعداها إلى محطات التوقف “فعندما يصلان (= راكبا القشاوة) إلى المرحلة (= محطة الاستراحة) التي يحطّان بها يضرب سرادقهما (= خيمتهما) للحين -إن كانا من أهل الترفّه والنِّعم- فيدخل بهما راكبين وينصب لهما كرسيّ ينزلان عليه، فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما، وناهيك من هذا الترفيه! فهؤلاء لا يَلْقَوْن لسفرهم -وإن بَعُدت شُقّته- نَصَباً، ولا يجدون على طول الحَلّ والتَّرحال تعباً”!! وكأن ابن جبير هنا يصف تنقُّل المسافر اليوم من وسط الطائرة إلى قاعة المطار عبر القناة الرابطة بينهما دون أن يشعر حتى بالهواء الخارجي!!
ويشير رحالتنا الأندلسي إلى المستويين الأوسط والأدنى من درجات الرحلة في القوافل؛ فيقول: “ودون هؤلاء في الراحة راكبو «المحارات» وهي شبيهة بـ «الشقادف» (= جمع شُقْدُف: مَحْمِل حِجَازِي أَوْسَعُ مِن العمارِية)، لكن الشقادف أبسط وأوسع وهذه أضمّ وأضيق، وعليها أيضا ظلائل تقي [الراكبَ] حَرَّ الشمس. ومن قصّرت حاله عنها في هذه الأسفار فقد حصل على نَصَب السفر الذي هو قطعة من العذاب”!!
ويفصّل ابن جبير -بقلمه السيال وعباراته الرشيقة- في وصف هوادج “الخواتين”، وهن بنات أحد ملوك السلاجقة كُنَّ في قافلة الحج العراقي التي رافقها من مكة إلى بغداد؛ فيوضح أن كلا منها عبارة عن “هودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطيتين الواحدة أمام الأخرى، وعليهما الجِلال المذهبة، وهما تسيران بها (= إحدى الخواتين) سيرَ النسيم سرعة ولِيناً، وقد فُتح لها أمام الهودج وخلفه بابان، وهي ظاهرة في وسطه متنقبة وعصابة ذهب على رأسها”.
أما الرحالة المغربي ابن بطوطة فيسجل لنا تجربته مع بعض محامل السفر بمنطقة جنوبي روسيا؛ فيذكر أنه عندما أراد زيارة سلطانها محمد أوزبك خان سافر إليه راكبا عربة تجرها الخيول، وكان “على العربة شبه قُبّة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق، وهي خفيفة الحمل وتُكسَى باللِّبْد (= صوف مقوَّى) أو بالمِلَفّ (= نوع من القماش)، ويكون فيها طيقان (= نوافذ) مشبَّكة”.
ثم يصف ما توفره هذه المحامل من رفاهية لراكبيها؛ فيقول إنه “يَرَى الذي بداخلها الناسَ ولا يرونه، ويتقلّب فيها كما يحبّ وينام، ويأكل ويقرأ ويكتب وهو في حال سَيْره، والتي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من هذه العربات يكون عليها [محمل] شبه البيت…، وعليه قُفْلٌ”. ويضيف متحدثا عن نفسه: “وجهّزتُ لمّا أردت السفر عربة لركوبي مغشّاة باللّبد، ومعي بها جارية لي، وعربة صغيرة لرفيقي عفيف الدين التوزري (ت بعد 742هـ/1341م)، وعجلة كبيرة لسائر الأصحاب، يجرّها ثلاثة من الجمال، يركب أحدها خادم العربة”.
كما عرف المسافرون نوعا من الهوادج يسمى «العمّارية» كان يمكن للسيدات المسافرات البقاء داخله حتى في حالة وضعه على الأرض، لكنه لم يكن مهيأ للمبيت فيه كما توحي به قصة لأحد الأمراء الحمْدانيين “حطّ «العمارية» في الصحراء ثم ضُربت له خِيَم ولأصحابه”؛ وفقا لكتاب ‘نشوار المحاضرة‘ للقاضي التنوخي الذي يُفهم مما أورده عن استخدامات «العمارية» أنها كانت مركبا فخما لكونها ترد ضمن أثاث الطبقة الراقية فحسب، كما كانت تسع شخصين معا خاصة إن كانا رجلا وزوجته.
وفيما يتعلق بعُدة إقامة المسافرين في محطات الاستراحة أثناء الرحلة؛ فقد كانت الخيام والمصابيح وترتيبات الإقامة مثيرة للدهشة ولاسيما لدى الطبقات العليا، فالتنوخي يحدثنا عن أن الخليفة العباسي هارون الرشيد (ت 193هـ/809م) مثلا “جلسَ… جُلُوسًا عَاما فِي مضرب (= سرادق) خَزّ (= قماش ناعم) أسود، استدارتُه (= محيط دائرته) أَربعمئَة ذِرَاع (= 200 متر تقريبا)، فِي أَرْكَانه أَربع قباب مغشّاة بخَزّ أسود، وَهُوَ جَالس فِي فازةِ (= مِظلَّة تُبنى بعمودين في المعسكرات) خَزٍّ أسود فِي وسط المضرب، والعَمَد كلهَا سود”. وقد تكون غلبة السواد على الأثاث راجعة إلى أن السفر كان في فصل الشتاء، كما يشير السواد إلى شعار الدولة العباسية.
أما قافلة أمير الحج العراقي فقد تنوعت فيها أشكال الخيام بين القباب الدائرية والسُّرادق حتى بدت كالمنازل لا الخيام، هذا عدا عن زخرفتها وتطريزها المتنوع الألوان، ولها أبواب ضخمة يدخل منها الداخل في دهاليز وممرات مظلَّلة، والأبواب من الضخامة بحيث يدخل منها الفارس بجواده دون أن يطأطئ رأسه، وتُفضي بالداخل إلى الساحات التي فيها الخيام وقد “أُدِيرَ ذلك كلُّه بتدبيرهندسي غريب”، حتى لـ”كأن هذا الأمير ساكن في مدينة قد أحدَق بها سورُها، تنتقل بانتقاله وتنزل بنزوله، وهي من الأبّهات الملوكية المعهودة التي لم يُعهَد مثلها عند ملوك المغرب” والأندلس؛ طبقا لابن جبير.
وربما كانت قوافل المسؤولين الرسميين مجهَّزة بما يكفل إنجاز الأعمال الإدارية العظيمة التي يكلفون بها أثناء رحلاتهم؛ كما يفيدنا إياه الكاتب العباسي المعلَّي بن أيوب (ت نحو 247هـ/861م) بقوله: “أعْنَتَني (= أرهَقني) الفضل بن مروان (الوزير العباسي المتوفى 250هـ/864م) ونحن في بعض الأسفار، وطالبني بعمل طويل يُعمَل في مدة بعيدة…؛ فقعدت في ثيابي، وجاء الليل فجعلت بين يديّ نفّاطة (= مشعل كبير)، وطرح غلماني (= المساعدين) أنفسَهم حولي”؛ طبقا لما نقله عنه التنوخي في ‘الفرج بعد الشدة‘.
وقد ورد في إشادة ابن جبير بتجهيزات قافلة حج رافقها من مكة المكرمة إلى العراق، وكانت فيها “خاتونان” (أميرتان) من أسرة زنكي الحاكمة في الموصل أيامها؛ فقال إن “المرافق الصناعية وغيرها من المصالح الدينية والمنافع الحيوانية كلها موجودة بهذه المحلة غير معدومة، ووصفها يطول والأخبار عنها لا تنحصر”!!
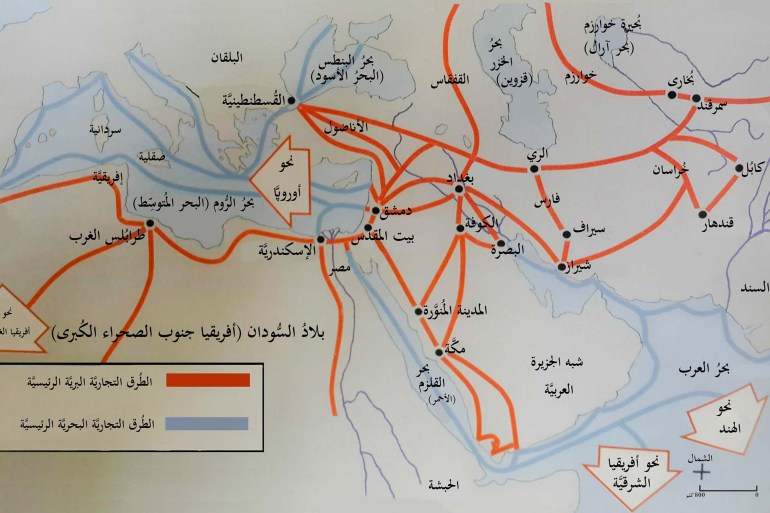
خدمات طرقية
كانت طرق السفر في العادة معتمدة على مدى الخِدْمات العمرانية المتوافرة على خطوطها ومن حولها، ولهذا يندر عبور الصحاري المقفرة إلا في حالة الاضطرار؛ كما يؤكد ذلك الرحالتان: ناصر خُسْرَوْ البَلْخي وابن جبير الأندلسي.
وتعتمد طرق المسافرين أيضا على عُقَد الاتصال المركزية بين المناطق المختلفة والطرق الرسمية المتنوعة، كمدينة قُوص مثلا -التي تربط في طرق التجارة والحج- بين مصر والسودان ثم الحبشة واليمن، فكان الجميع -قُبيل الانطلاق للسفر بحرا من قوص نحو عَيْذاب جنوبا- يجتمعون في موضع يسمى “المَبْرَز” خارج البلدة، فتوزن الأحمال على الجمالين وتكمل تجهيزات السفر وصولا إلى الحظة الانطلاقة.
ومن التجهيزات التي كانت تزود بها خطوط المسالك علامات الطريق المرشدة للقوافل والمسافرين عموما حتى لا يضلوا سبيلهم؛ وهو تقليد حضاري قديم عُرف قبل الإسلام بقرون عديدة كما يفهم من أحد تفاسير قوله تعالى ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾؛ (سورة الشعراء/الآية: 128)، فالآية تشير إلى أن قوم عادٍ “كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم، فبنوْا على الطريق أميالًا طوالًا عبثًا ليهتدوا بها، يدل عليه قوله: {آيَةً} أي علامة”؛ حسبما جاء في ‘الكشف والبيان عن تفسير القرآن‘ للإمام أبي إسحق الثعلبي (ت 427هـ/1037م).
ويخبرنا الجغرافي الأندلسي ابن عبد المنعم الحِمْيري -في ‘الرَّوْض المِعْطار في خبر الأقطار‘- أنه كانت في الجنوب التونسي “أرض… سِبَاخ وملّاحات لا يُهتدى للطريق لها إلا بخشب قد نُصبت في دَهَس يشبه الصابون في الرطوبة، فمن أخطأ طريق تلك الخشب المنصوبة على الطريق هلك في تلك السباخ، وقد هلكت العساكر والجماعات في قديم الزمان ممن دخلها ولم يعرف أمرها”.
ويذكر ناصر خُسْرَوْ -في “سَفَر نامه” وهو كتاب رحلته التي بدأها سنة 437هـ/1028م من مسقط رأسه مَرْو إلى مصر- أن أهل مدينة خِلاط/أَخْلاط الواقعة اليوم جنوب شرقي تركيا “غرسوا فِي جُزْء من الطَّرِيق عَمَداً ليسير المسافرون على هديها أَيَّامَ الثَّلج والضَّباب”، وذلك بسبب كثرة الجليد ورداءة الطقس في تلك المنطقة.
كما سجّل ناصر خُسْرَوْ آثار وأعمال ولاة السلاجقة في منطقة صحراء طبس وسط إيران؛ فيقول في وصف الطريق الصحراوي من أصفهان مرورا بمدينة نائين: “وقد بُنيت في هذا الطريق الصحراوي بين كل فرسخين (الفرسخ = 5كم تقريبا) -في المواضع غير المالحة- قِبابٌ صغيرة وخزانات يتجمع فيها ماء المطر، وقد شُيدت القباب حتى لا يضل المسافرون الطريق، ولكي يأووا إليها ساعات في الحر والبرد. وقد رأينا في الطريق الرمل المتحرك، وكل من يتحول عن العلامات التي وُضعت في الطريق للإرشاد فإنه لا يستطيع الخروج من وسط هذا الرمل ويهلك”.
وبعد عصر ناصر خُسْرَوْ بسبعة قرون؛ رصد العلامة والأديب العراقي عبد الله بن حسين السويدي (ت 1174هـ/1760م) -في كتابه ‘النفحة المسكية في الرحلة المكية‘ الذي سجل فيه وقائع رحلته إلى الحج سنة 1157هـ/1760م- وجود تلك العلامات -التي قال إنها تسمى “الأميال”- على مقطع طريق الحج الواقع بين المدينة ومكة؛ فأشار إليها قائلا: “ومررنا في طريقنا على سبعة «أميال» مبنية بالحَجَر والجِصّ، كلُّ واحد قَدْر قامة ونصف [و] بين كل مِيل [وآخر] مسافة ميل (= 1850 مترا تقريبا)، بناها… أحد أمراء الحاج المصري، وذلك لأن تلك الأرض رملها كثير فيحصل من تراكمه تلال عظام فيتيه ركب الحاج، فبناها لتكون علامة ونُصْباً على الطريق”.
أما عن تجهيزات المياه للمسافرين لدرء أحد أعظم الأخطار التي يواجهونها عادة أثناء رحلاتهم وهو العطش الشديد؛ فقد كانت هناك خزانات لحفظ مياه الأمطار عُرِفت بـ”المصانع” في بعض المناطق الإسلامية، إلى جانب الآبار التي كانت السلطات أو المحسنون يحفرونها على شبكات الطرق في جميع أنحاء الجغرافيا الإسلامية، ولاسيما على دروب ركاب الحج.
وقد ظهر الاعتناء بهذه الخدمات المائية منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ كما يدل عليه تسجيل الرحالة ابن جبير معاينتَه لآبار في طريق الحج العراقي قال إنها تعود إلى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (ت 35هـ/656م).
ومن أقدم مرافق الخدمات المائية المخصصة للمسافرين وأشهرها تلك التي كانت مقامة على “درب زبيدة” التاريخي، وهو طريق شقته -تسهيلا على الحجاج القادمين من العراق وما وراءه من أقطار الإسلام- زوجة الخليفة هارون الرشيد: زبيدة بنت جعفر العباسية (ت 216هـ/831م)، وقد قارب طوله 1300 كيلومتر، وكان عليه 45 محطة تضم موارد مياه وتحصينات لتأمين المياه للحجاج.
وقد أنفقت زبيدة مبالغ طائلة على دربها وعلى العيون المائية التي سقت بها أهل مكة المكرمة من الحجاج والمقيمين بها؛ فالقاضي المؤرخ شمس الدين ابن خلّكان يروي -في ‘وفيات الأعيان‘- أن زبيدة “سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية (= قِرْبة الماء) عندهم بدينار (= اليوم 200 دولار أميركي تقريبا)، وإنها أسالت الماء عشرة أميال بحطّ الجبال ونُحُوت الصخر حتى غلغلته من الحِلّ إلى الحَرَم…، فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمئة ألف دينار (1.7 مليون دينار = اليوم 340 مليون دولار أميركي تقريبا)…، ولها آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- من مصانع وبِرَك أحدثتها”!!
ويبدو أن خدمات “درب زبيدة” ظلت متاحة بوفرة للمسافرين طوال أربعة قرون على الأقل؛ ففي منتصف القرن الخامس الهجري/الـ11م نجد الرحالة ناصر خُسْرَوْ يتحدث عن إحدى محطات الاستراحة المقامة على هذا الدرب قائلا: “وَمن هُنَاكَ ذَهَبْنَا عَن طَرِيق «رِبَاط زبيدة» المُسَمَّى «رِبَاط المرامي»، وَهُوَ يحتوي على خمس آبار، وَلَوْلَا هَذَا الرِّبَاط وَالمَاء الَّذِي بِهِ لما اسْتَطَاعَ أحد اجتياز هَذِه الصَّحرَاء”.
وفي نهاية القرن السادس الهجري/الـ12م كتب الرحالة ابن جبير عن القيمة العظيمة لتلك الخدمات لدى قوافل الحجاج قائلا: “وهذه المصانع والبِرَك والآبار والمنازل -التي من بغداد إلى مكة- هي آثار زبيدة… زوج هارون الرشيد وابنة عمه؛ انتدبت لذلك مدة حياتها فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعمّ وَفْدَ اللهِ تعالى كلَّ سنة من لدن وفاتها إلى الآن! ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل بمجازاتها والرضا عنها”.

عيادات متنقلة
كما رصد هذا الرحالة الأندلسي العديد من الخزانات المائية الأخرى في مختلف محطات طريق الحج، ومن أعظمها وأغربها ذاك الذي وصفه بقوله مشيرا إلى بعض أنشطة الحجاج اليومية في استخدام الماء: “نزلنا بموضع يُعرف بالشّقوق وفيه مصنعان ألفيناهما مملوءين ماء عذبا صافيا، فأراق الناس مياههم وجدّدوا مياها طيبة، واستبشروا بكثرة الماء، وجدّدوا شكر الله على ذلك. وأحد هذين المصنعين صهريج عظيم الدائرة كبيرُها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة، وكان الماء قد علا فيه أزيدَ من قامتين (= 360سم)!! فتنعّم الناس من مائه سباحة واغتسالا وتنظيف أثواب، وكان يومهم فيه من أيام راحة السفر”!!
كما أثنى ابن جبير على المرافق الخِدْمية التي أقامها للمسافرين الوزير الزنكي محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجَوَاد الأصفهاني (ت 559هـ/1164م)؛ فقال عن اتساعها وتغطيتها لشبكة هائلة من الطرق الواصلة بين عدة أقاليم مركزية: “حسبك أنه اتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرق المسلمين بجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى الحجاز…، واستنبط (= استخرج) المياه وبنَى الجِبَاب (= خزانات مياه المطر)، واختطّ المنازل (= محطات الاستراحة) في المفازات، وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين”!!
وإضافة إلى مرافق المياه الثابتة على محطات طرق السفر؛ كانت ثمة الأوعيةُ المائية المرافقة للقوافل في سيرها، وربما يبلغ حجمها أن تكون على شكل خزانات كبيرة محمولة على ظهور الإبل، فابن جبير يحدثنا عن مبرّات للأميرتيْن الزنكيتيْن (الخاتونيْن) قائلا: “ولهؤلاء النسوة الخواتين في كل عام -إذا لم يحججن بأنفسهن- نواضح (= جمال/نوق يُستقى عليها) مسبّلة مع الحاج، يرسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع المعروف فيها الماء، وفي الطريق كله، وبعرفات وبالمسجد الحرام، في كل يوم وليلة…، فتسمع المنادي على النواضح يرفع صوته بـ: «الماء للسبيل»، فيُهْطِع (= يُسْرع) إليه المُرْمِلون (= من لا زاد معهم) من الزاد والماء بقِرَبهم وأباريقهم فيملؤونها”!
وبعد ابن جبير بنحو قرن ونصف؛ يحدثنا ابن بطوطة عن الخدمات المرافقة للقافلة الرسمية للحجاج العراقيين أيام السلطان المغولي أبي سعيد محمد بن خَرْبَنْدا (ت 736هـ/1335م)، فيقول: “وفي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء، وجمال لرفع (= حمْل) الماء للصدقة، ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه مرض، وإذا نزل الركب طبخ الطعام في قدور نحاس عظيمة تسمى الدسوت، وأطعم منها أبناء السبيل ومن لا زاد معه، وفي الركب جُمْلةُ من الجمال يُحمل عليها من لا قدرة له على المشي”!!
وإنه لأمر مدهش حقا ما ذكره هذا الرحالة عن احتواء قافلة الحجاج على المستلزمات الطبية لتوفير الإسعافات الأولية للحالات الصحية الطارئة في تلك الأزمنة، والحال أن ذلك كان من خواص قوافل السفر السلطانية على نحو ما يخبرنا به المؤرخ المقريزي في وصفه لتجهيزات أسفار سلاطين المماليك.
فقد قال إنه جرت العادة في هذه القوافل السلطانية على أنه “يصحب السلطانَ في السفر غالبُ ما تدعو الحاجة إليه، حتى يكاد يكون معهم مارستان (= مستشفى) لكثرة من معه من الأطباء وأرباب الكحل (= أطباء العيون) والجرّاح والأشربة والعقاقير، وما يجري مجرى ذلك، وكلُّ من عاده طبيبٌ ووصف له ما يناسبه (= من الدواء) يُصرف له من «الشراب خاناه» (= الصيدلية) أو «الدواء خاناه» المحموليْن في الصحبة” السلطانية!!
وقد تواصل تقليد مرافقة الخدمات الطبية لقوافل الحج الرسمية إلى جانب بقية المستلزمات التموينية، وما يعززها من فرق شؤون دينية وأمنية وإدارية؛ كما نجده موثقا في هذا النص الذي أورده محمد كِبْرِيت الحسيني -في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘- قائلا: “فيخرج الركب المصري بالمَحْمل السلطاني، والسبيل (= الوقف) المسبل للفقراء بالماء والزاد، والأدوية والكحالين (= أطباء العيون)، والأئمة والمؤذنين، والأمراء والجند، والقاضي والشهود والأمناء”.
وعندما تضطر القوافل إلى قطع مجابات صحراوية قاحلة ليس فيها سوى “رمال جُرْد لا ماء فيها ولا نبت؛ [فإنه] يَتزود الرفاقُ الماءَ والحطبَ فيها كما يُتزود الطعام والعلف”؛ وفقا للمؤرخ الجغرافي الأندلسي أبي عُبيد البكري (ت 487هـ/1094م) ضمن حديثه -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- عن المجابات الكبرى في صحراء الغرب الأفريقي مما يلي المغرب الأقصى.
أما عن الميزانيات الرسمية المخصصة لتجهيزات خدمات الطرق؛ فقد كان صاحب الإمارة الحَسْنَويّة الكردية -بشمال غربي إيران وشمال شرقي العراق- الأمير بدر بن حَسْنَوَيْهِ الكردي (ت 405هـ/1015م) “يُنْفذ (= يصرف) كل سنة -في الصدقات على أهل الحرمين، وخَفْر الطريق ومصالحها- مئة ألف دينار (= اليوم 20 مليون دولار تقريبا)، وكان ينفق على عمارة المصانع (= خزانات المياه) وتنقية الآبار، وجمع العلوفة في الطريق، وكان يعطى سكان المنازل رسوما لقيامها (= إدارتها)”؛ وفقا للإمام ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في كتابه ‘المنتظم‘.
وفي هذا العصر نفسه؛ شاعت أخبار السفرة التاريخية للأميرة التغلبية جميلة بنت ناصر الدولة الحَمْداني (ت نحو 370هـ/981م)، والتي خرجت فيها إلى مكة المكرمة سنة 366هـ/967م تتزعم قافلة أدهشت الناس بضخامتها “فضُرِب بحَجّها المَثَل، فإنها استصحبت أربعمئة جمل عليها محامل عدة، ولم يُعْلَم في أيها كانت”؛ وفقا لابن الجوزي.
وقد حضرت موسمَ الحَج “فسقت أهل الموسم كلّهم السويق (= طعامٌ من دقيق الحنطة أو الشعير) بالطَّبَرْزَد (= السكر الأسمر) والثلج، واستصحبت البقول المزروعة في المَراكِن (= جمع مِرْكَن: وعاءٌ تُغْسَل فيه الثياب) على الجِمال، وأعدت خمسمئة راحلة للمنقطعين” في الطريق من المسافرين إلى الحج؛ طبقا لما جاء في كتاب ‘التذكرة الحمدونية‘ للأديب بهاء الدين محمد بن الحسن البغدادي (ت 562هـ/1167م)، الذي يضيف أن ما صنعته هذه الأميرة العربية خلّد سفرتها حتى “صارت تاريخا مذكورا”!!

حراسات منظمة
من أهم الجوانب المركزية في حياة السفر وترتيباته قديما موضوع تأمين المسافرين الذي بلغ من أهميته أنه كان يتم النص عليه في وثائق عهود تولية الخلفاء لأمراء النواحي والأقاليم؛ فمؤرخ النُّظُم السلطانية الإسلامية شهاب القَلْقَشَنْدي (ت 821هـ/1418م) يورد -في كتابه ‘صبح الأعشى في صناعة الإنشا‘- ما قال إنه نص تولية الخليفة العباسي لأمير دولة المرابطين بالغرب الإسلامي يوسف بن تاشفين (ت 500هـ/1106م)، فكان مما جاء فيه تكليفُه بأن “يَأمر بحفظ السابلة (= المسافرون) واختصاصهم بالحراسة السابغة الشاملة، وحماية القوافل واردةً وصادرةً، واعتمادُها (= تزويدها) بما تغدو به إلى السلامة مُفْضِيةً صائرةً، لتُحرس الدماءُ مما يُبيحها ويُريقها، والأموالُ مما يُقصد فيه سبيلُ الإضاعة وطريقُها”.
والتأمين للمسافرين كان يتم عبر مستوييْن: متحرك وثابت؛ فأما الحماية المتحركة فهي تلك التي تواكب قوافل السفر طوال رحلاتها بشكل دائم من بداية الطريق إلى نهايته، أو على نحو مؤقت من محطة إلى أخرى يتبدل فيها طاقم الحماية من منطقة إلى أخرى.
وهذا النوع من حماية القوافل الأصل فيه أن يكون بإجراءات رسمية تتخذها السلطات، ولذا كانت تخصَّص له فرق كبيرة من الجنود النظاميين، حتى إنه “كان في القوافل الذين يُبَذْرِقُون (= يحرسون) الحاج ستة آلاف رجل” أمن مسلح؛ وفقا للإمام الطبري (ت 310هـ/922م) في تاريخه.
كما يحدثنا الإمام سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) -في ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‘- أنه في سنة 476هـ/1083م “حصل… من الأمن والرُّخص ما لم يُعْهَد: تسير القوافل من جَيحون (= نهر آمُو دَرْيا بآسيا الوسطى) إلى الشام والتجارُ بالأموال العظيمة والأمتعة، بلا خفير ولا رفيق، على الاجتماع والانفراد، ولا يُؤخذ لأحد عِقال” بعير!!
ولعل هذه العناية البالغة بحماية المسافرين تفسر لنا قول المؤرخ المغربي عبد الواحد بن علي المَرَّاكُشي (ت 647هـ/1249م) -في ‘المُعجِب في تلخيص أخبار المغرب‘- إنه “كانت العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان تمشي فيها القوافل ليلاً ونهاراً” وهي آمنة من قُطّاع الطرق، رغم أن المسافة بين المدينتين تبلغ 2500كم!!
لكن اختلال السيطرة الأمنية المركزية للخلافة العباسية وما صاحبه من انفلات أمني بدءاً من مطلع القرن الرابع الهجري/الـ10م؛ أدى إلى ما يشبه الخصخصة لقطاع أمن الطرق الخارجية، فكان من نتائج ذلك ظهور وظيفة «تقلُّد الطريق» التي تعني إسناد حماية الطريق بمنطقة محددة إلى أحد القادة العسكريين الأقوياء، بحيث يتولى تأمين المسافرين فيها من قطّاع الطرق. وقد تولى هذه المسؤولية مثلا أحد القادة العسكريين الأتراك عندما “طلب «تقليد طريق» الفرات فقُلّد” حمايتها حوالي سنة 327هـ/939م؛ وفقا لابن خلدون في تاريخه.
وإضافة إلى تلك الحماية الرسمية لقوافل المسافرين؛ كانت حراستها أيضا مهنة توفِّر موردَ رزقٍ حيويا لبعض العوائل أو القبائل، وخاصة منذ تعمَّق الاختلال الأمني في أرجاء جغرافيا الإسلام؛ فالقاضي التنوخي يروي -في ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة أخوين يُسمّيان: عاد وشدّاد، ويقول فيها أحدهما عن عائلته: “كنا نُبَذْرٍقُ القوافلَ من قريتنا إلى مواضع كثيرة ولا نستعين بأحد، وتَخْرُجُ علينا الرجال الكثيرة فألقاهم أنا وأخي فقط فنهزمهم، فاشتهر أمرنا حتى كان إذا قيل: [هذه] «قافلة عاد وشداد» لم يعرض لها أحد! فمكثنا كذلك سنين كثيرة”.
ويخبرنا التنوخي أن موفَدا رسميا خرج من بغداد في مهمة بالشام لأحد وزراء الدولة البويهية، فسلك طريقا بريا غير آمن مما ألجأه إلى الحاجة لطلب الحماية؛ فيروي التنوخي -بسنده عن ذلك الموفد- قوله: “وكتب [الوزير] إلى عامل (= الوالي) هِيت بإنفاذي مع خِفَارة (= حراسة)، فلما حصلتُ بهِيت استدعى العامل جماعة من عدة من أحياء العرب وسلمني إليهم، وأعطاهم مالا على ذلك، وأشهد عليهم بتسلُّمي، واحتاط في أمري. وكانت هناك قافلة تريد الخروج منذ مدة وتتوقى البرية، فأنِسُوا بي وسألوني أن آخذ منهم لنفسي مالا، وللخُفَراء الأعراب مالا، وأدخِلهم في الخفارة ويسيرون معي، ففعلت ذلك فصرنا قافلة عظيمة”.
وفي القرن التالي؛ كان الوضع الأمني صعبا بالنسبة للمسافرين في شرقي شبه الجزيرة العربية طبقا للرحالة ناصر خُسْرَوْ، الذي يروي لنا تجربته مع ذلك الوضع في رحلة عودته إلى بلاده؛ فيقول: “ولبثنا هناك خمسة عشر يوما إذْ لم يكن معنا خفير يهدينا الطريق، ولكل قوم من عرب هذا المكان أرض محددة ترعى بها ماشيتهم ولا يستطيع أجنبي أن يدخلها، فهم يمسكون كل من يدخل بغير خفير ويجردونه مما معه، فيلزم استصحاب خفير من كل جماعة حتى يتيسر المرور من أرضهم، فهو وقاية للمسافر ويسمونه أيضا «مرشد الطريق» (قلاوز)” باللغة الفارسية.
ومن القبائل العربية وغيرها من تجعل مهنة تأمين القوافل مقابل رسوم مالية حقا حصريا لها في مجالها الجغرافي، ويمدنا ابن بطوطة بنموذجين لهذا الاحتكار أحدهما عربي في جنوبي العراق والثاني بربري/أمازيغي في صحراء أفريقيا الغربية.
فعن النموذج الأول يذكر أنه سافر إلى البصرة “صحبة رفقة كبيرة من عرب خَفَاجَة، وهم أهل تلك البلاد ولهم شوكة عظيمة وبأس شديد، ولا سبيل للسفر في تلك الأقطار إلّا في صحبتهم”. وعن النموذج الثاني يقول مشيرا إلى الدور النسوي في ممارسة هذه المهنة: “ثم وصلنا إلى بلاد بَرْدامَة (= الطوارق) وهي قبيلة من البربر…، ولا تسير القوافل إلّا في خفارتهم، والمرأة عندهم في ذلك أعظم شأنا من الرجل”!!
مراصد أمنية
وأما الحماية الأمنية الثابتة لطرق القوافل فكانت تتولاها السلطات الرسمية في البلد أو الإقليم الذي تمر به تلك الطرق؛ فقد كان من أوائل الترتيبات التي اتخذتها الدولة العباسية لحظة إقامتها -كما جاء في ‘أخبار الدولة العباسية‘ وهو لمؤلف مجهول عاش في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي- تعيين مسؤولين أمنيين على معاقد طرق المواصلات، وكان كل منهم مكلفا بأن “يحتفظ بالطرق ويضع المسالح (= نقاط تفتيش أمنية)… لتأمن بها الرُّسُل، ويُبَذْرق القوافل”.
ويشير الطبري إلى بناء العباسيين سلسلة محطات حراسة في بعض المناطق المضطربة أمنيا، وأنه كان المسؤول الأمني في كل منها يسلم مهمة الحماية إلى مسؤول المحطة التي تليه “فكانت السابلة والقوافل تخرج من أردبيل (= تقع اليوم شمال غرب إيران) معها من يُبَذْرِقها حتى تصل إلى حصن النهر، ثم يُبَذْرِقها صاحب حصن النهر” إلى المحطة التي تليه، وهكذا دواليك حتى تبلغ القوافل مأمنها.
ويذكر الرحالة الجغرافي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الإصْطَخْري (ت 346هـ/957م) -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- أنه في عهد الدولة الصفارية -ببلاد فارس ونواحيها- وُضع نظام أمني لحماية الطرق في مناطق الجبال الكردية، وبموجب هذا النظام “ضمِن خراجَ (= جباية) كل ناحية منها رئيسٌ من الأكراد، وألزِموا إقامة رجال لبذرقة القوافل وحفظ الطرق”.
وكان من تلك الإجراءات الأمنية أيضا ما اتفق عليه البيزنطيون مع أمير الدولة الحَمْدانية في حلب ونواحيها من أنه “إنْ قَطَعَ [الطريقَ] على القافلة أعرابٌ أو مسلمون في بلد الأمير فعلى الأمير غرامة ذلك”؛ طبقا للمؤرخ كمال الدين ابن العَديم (ت 660هـ/1260م) في ‘زبدة الحلب في تاريخ حلب‘.
ومن ترتيبات حماية طرق القوافل منشآت كانت تسمى بـ”المناظر”، ويعرّفها ياقوت الحموي -في ‘معجم البلدان‘- بأنها “المواضع العالية التي يُشْرَف منها على الطريق” لحراسته من أخطار قطّاع الطرق. ومن نماذج تلك المنشآت الأمنية ما يذكره السويدي -في كتابه ‘النفحة المسكية في الرحلة المكية‘- من أن من ضمن طرق الحج في الحجاز “الطريق السلطاني وهو طريق سهل فيه قرى كثيرة…، وماؤه كثير، وفيه القلاع المهيأة لذخيرة الحاج وحراسة الماء”.
ويستعرض المستشرق الفرنسي هنري تِرّاس (Henri Terrasse المتوفى 1391هـ/1971م) -ضمن مقالته عن مادة “الحصن” في كتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘ الاستشراقية الصادرة عن مؤسسة “بريل” الهولندية- جوانبَ من تلك الإجراءات الأمنية الثابتة لحماية الطرق وفقا للتجربة الإسلامية الأندلسية؛ فيقول إنه “بُنيت قلاع كثيرة لحماية الطرق التجارية الرئيسية وتأمينها، ولإيواء المسافرين في الليل بعد عناء رحلة اليوم، ولتزوِّد أحيانا حاملي البريد الحكومي -في المراحل المتتابعة- بما يحتاجون إليه، وكان لذلك نظام بعينه…، وكانت الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين كل قلعة منها والأخرى مرحلة من السفر تستغرق يوما واحدا (= ما بين 35-50كم)، وكُلفت القلاع الثانوية وأبراج المراقبة في بعض الأحيان بحراسة الدروب الجبلية”.
وكان السلاطين يتفاوتون في اهتمامهم أو قدرتهم على توفير تلك الخدمات الأمنية، ولذا ظل المؤرخون يثنون على كل من استطاع منهم أن يضبط الحالة الأمنية في مسالك مملكته، ويشيرون إلى ذلك بعبارات متعددة من قبيل ما وصف به المقريزي -في ‘المواعظ والاعتبار‘- أميرَ الدولة الأغلبية في تونس إبراهيم بن أحمد ابن الأغلب (ت 289هـ/902م)؛ فقد قال إنه: “حسنت سيرته فكانت القوافل والتجار تسير في الطرق وهي آمنة”!!
ومثل ذلك إشادة الإمام سبط ابن الجوزي -في ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‘- بإجراءات والي الموصل وجوارها آقْسُنْقُر البُرْسُقي (ت 520هـ/1126م)؛ فقال إنه “أحسن السيرة فيها وبسط العدل، وحَمَى السابلة… فتواترت القوافل، ودَرَّ الارتفاع (= الجباية المالية) أضعافَ ما كان”.
ويصف ابن بطوطة طرق السفر في بلاد إمبراطورية مالي الإسلامية غربي أفريقيا بالأمن المطلق في أيام تجواله فيها منتصف القرن الثامن/الـ14م؛ فيقول إنه “لا حاجة إلى السفر في رفقة لأمن تلك الطريق” هناك. بل إن المقريزي يتحدث -في ‘المواعظ والاعتبار‘- عن درجة عالية من الأمن وتوفر الخدمات في طرق الشام في بعض فترات عصره؛ فيقول عنه: “ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركنا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تحمل زادا ولا ماء”!!
وبعد ذلك بأربعة قرون؛ أشاد المؤرخ المصري عبد الرحمن الجَبَرْتي (ت 1240هـ/1824م) -في ‘عجائب الآثار في التراجم والأخبار‘ـ باستتباب أمن الطرق في عهد الأمير المملوكي محمد بك أبو الذهب (ت 1189هـ/1775م)، مشيرا إلى انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والحياة التجارية، فقال إنه “هابته العُرْبان وقطَاع الطريق وأولاد الحرام، وأمِنَتْ السُّبُل وسُلِكتْ الطرقُ بالقوافل والبضائع، ووصلتْ المجلوباتُ من الجهات القِبْلية والبحرية بالتجارات والمبيعات” الواسعة.
وكانت المرافقة العسكرية متاحة للوفود الرسمية تأمينا لهم من الأعداء ومخاطر الطريق؛ فابن فضلان يفيدنا بأن ملِك الدولة السامانية كتب “إلى صاحبه بخُوَارزْم بتَرْك العَرْض (= التعرض/التفتيش) لنا، والكتاب بباب التُّرْك ببذرقتنا (= توفير مرافقة مسلحة) وتَرْك العرض لنا”. ويوثق ابن جبير وجود حماية أمنية خاصة للأميرتيْن الزنكيتيْن (الخاتونيْن) في رحلة حجهما؛ فيقول: “ولهما أجناد برسمهما (= مخصصون لهما)، وزادَهما الخليفةُ [العباسي] جندا يشيّعونهما مخافةَ العرب الخَفَاجيِّين (= قبيلة خَفَاجَة) المُضِرِّين بمدينة بغداد”!
وقد تحصل الشخصيات المهمة -غير الرسمية- من العلماء ونحوهم على حماية خاصة أثناء سفرهم؛ فابن بطوطة يحكي أنه هو ورفاقه نالوا هذه الحماية أثناء مرورهم قرب مدينة كوتاهية الواقعة اليوم غربي تركيا، وكان سكانها من المتمردين على السلاطين المحيطين بهم، فبعث معهم “السلطان فرسانا يبلغوننا إلى مدينة لاذق (تقع جنوب غربي تركيا وتُدعَى اليومَ: دَنيزلي)…؛ فعصمنا الله منهم” بتلك الحماية السلطانية التي رافقتهم طوال رحلة امتدت 260كم هي المسافة بين المدينتين.

أدلاء ومرشدون
كان أدلّاء الطرق من أهم الشخصيات التي تصاحب المسافرين فترشدهم إلى السبيل الأقوم والأسلم نحو غايتهم، ولذلك استأجر النبي ﷺ دليلا مرشدا هو عبد الله بن أُرَيْقِط الليثي (ت بعد 9هـ/631م)، الذي يصفه الإمام ابن القيم (ت 751هـ/1350م) بأنه “كان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمّناه على ذلك وسلّما إليه راحلتيهما”.
ويمكن القول إنه كانت هناك معايير مشترطة في الدليل بحكم خطورة مهنته، ولعلها لا تخرج عما اشترطه كتاب ‘التاج في أخلاق الملوك‘ -الذي يُنسب إلى الجاحظ (ت 255هـ/864م)- في كل من يرافق السلطان في رحلاته؛ فقد قال إنه “من حق الملك -إذا زامله (= رافقه في السفر) بعض بطانته- أن يكون عارفاً بمنازل الطريق، وقطْع المسافة، دليلاً بهدايته وأعلامه (= علامات الإرشاد) ومياهه، قليل التثاؤب والنعاس…، معتدل المزاج، صحيح البنية”.
وكثيرا ما أشارت كتب الجغرافيا التراثية -التي تهتم برسم مسالك الطرق بين الأقاليم حتى إنه صُنِّف منها عدد بعنوان موَّحد هو “المسالك والممالك”- إلى الأدلّاء، وذكرت أنه كانت لهم -في منطقة الثغور الإسلامية على الحدود مع البيزنطيين- رواتب مالية ثابتة وأعلاف لدوابهم.
وبعض هؤلاء المرشدين -في المناطق الثغرية الحدودية- كانوا غير مسلمين من الأرمن والروم (البيزنطيين)؛ فالمؤرخ كمال الدين ابن العديم يذكر -في كتابه ‘بُغْية الطلب في تاريخ حلب‘- أن ما يُجمع من الجباية بمدينة طَرَسُوس (تقع اليوم جنوبي تركيا) “يُفَضُّ منه على الأدلاء المؤلفة قلوبهم من الروم والأرمن وأولادهم بحسب ما يراه السلطان بطَرَسُوس من حُسن النظر لهم ولمن يتجدد منهم”.
كما اهتمت كتب الرحلات الشخصية -مشرقا ومغربا- بموضوع الأدلاء؛ فأفادنا ابن فضلان باتخاذهم في آسيا الوسطى بقوله: “واكْتَرْيْنا دليلًا” من مدينة الجرجانيّة التي توجد اليوم غربي أوزبكستان وكانت أيامها عاصمة مملكة خُوَارِزْم، كما يسجل الرحالة ابن حَوْقَل (ت 367هـ/978م) -في كتابه ‘صورة الأرض‘- معلومات عن الأدلاء ورؤسائهم في سِجِلْماسة التي هي اليوم مدينة الريصاني جنوبي المغرب، مشيدا بما امتلكوه من معرفة دقيقة بجغرافية أفريقيا الغربية وطرق الصحراء الكبرى.
وقد نوّه الجغرافي الشريف الإدريسي (ت 560هـ/1165م) -في كتابه ‘نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‘- بمهارة هؤلاء المرشدين الأفارقة في التعرف على المياه في الصحاري وقدرتهم على استخراجها؛ فنجده يصف قبائل الطوارق البربرية بأنهم “قوم رحالة وشربهم من عيون يحفرونها في تلك الأرض عن علم لهم بها وتجربة في ذلك صحيحة.
ولقد أخبر بعض السُّفّار (= المسافرين) الثقات -وكان قد تجوّل في بلاد السودان (= غربي أفريقيا) نحوا من عشرين سنة- أنه دخل هذه الأرض -أعني أرض بغامة (= وسط دولة مالي اليوم)- وعاين فيها رجلا من هؤلاء البربر، فكان يمشي معه في أرض خالية رملة ليس بها أثر للماء ولا لغيره، فأخذ البربري غرفة من ترابها وقرّبه من أنفه ثم اشتمّه وتبسّم! وقال لأهل القافلة: انزلوا فإن الماء معكم، فنزل أهل القافلة هناك وعرّسوا (= حطّوا) متاعهم، وقيدوا الجمال وتركوها ترعى. ثم عمد البربري إلى موضع وقال: احفروا هاهنا، فحفر الناس في ذاك الموضع أقل من نصف قامة (= القامة: 180سم)، فخرج إليهم الماء الكثير العذب، فعجب من ذلك أهل القافلة، وهذا مشهور معلوم يعلمه تجار أهل تلك البلاد ويحكونه عنهم”!!
وفي صحراء الغرب الأفريقي؛ اقترنت مهنة دِلالة القوافل بخدمة أخرى تسمى «التكشيف»، وفقا لابن بطوطة الذي يعرفها قائلا: “والتكشيف: اسم لكل رجل من مسوفة (= قبيلة صنهاجية) يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى إيوالاتن (= مدينة ولاتة شرقي موريتانيا) بكُتُب الناس إلى أصحابهم بها ليَكْتَرُوا لهم الدُّورَ ويخرجوا للقائهم بالماء مسيرة أربع (ليالٍ = مسافة 160كم تقريبا)…، وربما هلك «التكشيف» في هذه الصحراء فلا يعلم أهل إيوالاتن بالقافلة، فيهلك أهلها أو الكثير منهم”!!
مخاطر متنوعة
كان المسافرون برغم كل التجهيزات والترتيبات الأمنية المذكورة يقاسون العديد من أنواع المخاطر في الطريق، والتي تؤدي -أحيانا كثيرة- إلى خسارتهم لأموالهم بل وأرواحهم، ولذلك كانت الأسفار -في معظم الأزمنة- مغامرات شخصية احتفلت بقصصها المثيرة كتب التراث العربي فأطنبت في إيرادها واستعراضها.
وتاتي في طليعة تلك المخاطر الصراعات السياسية من حروبِ دولٍ متصارعة، وهجماتِ تنظيماتٍ مسلحة، وعدوان غزاة محتلين (صليبيين ومغول)؛ فالرحالة ابن فضلان يقول إنه لقي في طريقه مشقة من الصراع بين الدولة السامانية -ذات الولاء العباسي- والإمارة العلوية بطبرستان في المنطقة الواقعة شمالي إيران اليوم.
وفي ذلك يقول: “ثم رحلنا إلى خُوَار الرَّيّ (= طهران بإيران) فأقمنا بها ثلاثة أيام، ثم رحلنا إلى سِمنان، ثم منها إلى الدامَغَان [التي] صادفنا بها ابن قارن (= شَرْوين بن رستم بن قارن المتوفى 318هـ/930م وهو أحد قادة الفرس التابعين للدولة العلوية الطبرية) من قبل الداعي (= الأمير العلوي أحمد بن حسن بن علي الأطروش الحسني المتوفى 311هـ/923م)، فتنكّرنا في القافلة” لتفادي الوقوع في قبضتهم. ويعني ذلك أن وفدا عباسيا رسميا اضطر إلى إخفاء هويته تجنبا للمخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها وهو يسير في منطقة يحكمها شخص مناهض سياسيا للعباسيين.
وقد تعطلت رحلات القوافل في منطقة ساحل فارس مما يلي العراق بسبب الحرب التي كانت دائرة بين الأمراء البويهيين؛ طبقا للرحالة ناصر خُسْرَوْ الذي يخبرنا قائلا: “وَقد لَبِثت بمَهْرُوبان (= ميناء إيراني على بحر الخليج) زمنا لأنه قيل إِن الطرق ليست آمنة لما بين أبناء أبي كاليجار (آخر الملوك البويهيين المتوفى 440هـ/1039م) من الحروب، فقد كَانَ كل مِنْهُم على رَأس جَيش”. وسرعان ما انتهت تلك الاضطرابات بسقوط الدولة البويهية في العراق وفارس سنة 447هـ/1056م، وحلت محلها دولة السلاجقة.
وفي ظل الاضطرابات السياسية التي عمت قلب العالم الإسلامي أواخر القرن الثالث ومعظم القرن الرابع الهجري/الـ9-10م؛ كان من الطبيعي أن تتأثر شعيرة الحج بتلك الظروف السياسية الأليمة، فهي أكثر أركان الإسلام تماسا مع الأمن والسلامة وتأثيرهما على السفر والترحال المرتبطيْن بأدائها.
ولذا فإن تاريخ تعطُّل مواسم الحج هو في الحقيقةً تاريخ المنازعات والثورات وإقلاب الدول وتداولها، وهو تاريخ الحروب الكبرى للغزاة مثل الحملات الصليبية والاجتياحات المغولية التي توقَّف بسببها الحج من بعض المناطق طوال عشر سنوات، وهو كذلك تاريخ اللصوص وقطّاع الطرق الغادرين بأمن الحجيج وأشواقهم الإيمانية، ولاسيما على أيدي تنظيم القرامطة الباطني (278-398هـ/892-1008م) ذي التاريخ الوحشي في استباحة الآمّين البيتَ الحرام، بعد أن أسّس له كيانا سياسيا جعل عاصمته بلدة هَجَر التي كانت بمنطقة الأحساء شرقيّ السعوديّة اليوم.
فقد دأب قادة الكيان القِرْمِطِيّ -وخاصة زعيمهم الأخطر والأشهر أبا طاهر الجَنّابي (ت 332هـ/944م)- على مهاجمة المناطق التابعة للعباسيين في جنوبي العراق ويتمدد منها صولا إلى قلب الشام، إضافة إلى المناطق الخاضعة لهم رسميا والممتدة من الساحل الغربي لبحر الخليج وحتى قلب الحجاز، مما جعلهم كابوسا مرعبا لجميع المسافرين السالكين للطرق الواقعة في هذه النواحي، ولاسيما قوافل الحجيج بما فيها تلك الرسمية المحمية بحراسات شديدة.
فقد قطع القرامطة الطريق على الحجاج وروّعوهم في عمليات سطو ونهب وقتل وحشية نفذوها ما بين أواخر القرن الثالث ومعظم القرن الرابع الهجري/الـ9-10م، وكان من أوائل أفعالهم الشنيعة ما يرويه الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) -في ‘تاريخ الإسلام‘- في اعتراضهم قافلة الحجاج سنة 294هـ/907م؛ فيقول:
“وفي المحرم خرج زَكْرَوَيْهِ بن مَهْرَوَيْه القِرْمِطِي (ت 294هـ/907م) من بلاد القطيف يريد قافلة الحاج…، ثم اعترض قافلة خراسان… فحاربوه وترجلوا، فقال لهم: أمَعكم من عساكر السلطان أحد؟ قالوا: لا. قال: فامضوا لشأنكم فلست أريدكم. فساروا، فأوقع بهم وقتل الرجال وسبى الحريم، وحاز على القافلة! وكانت نساء القرامطة يُجْهِزْنَ على الجرحى، فيقال: قتلوا عشرين ألفا، وأخذوا ما قيمته ألف ألف دينار (= اليوم 200 مليون دولار أميركي تقريبا)”!!
وورد عند الإمام الطبري أن قيمة الأموال المصادرة كانت ضعف ما ورد في نص الذهبي؛ فقال إنه “ذُكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمة ألفيْ ألفِ دينارٍ”!! كما ينص المؤرخ المسعودي (ت 346هـ/957م) -في ‘التنبيه والإشراف‘- على أن القرامطة استهدفوا في تلك السنة ثلاث قوافل للحجاج القادمين من العراق وما وراءه من الأقاليم، وأنه كان عدد القتلى في واحدة منها فقط “أكثر من خمسين ألفا، دون من قُتل قبلها من أهل القوافل”!!
ويذكر المؤرخ شهاب الدين النويري (ت 733هـ/1333م) -في ‘نهاية الأرب في فنون الأدب‘- إرهاق القرامطة للقوافل بإفسادهم مصادر المياه: “ثم رحل زَكْرَوَيْهِ يريد القافلة الثالثة فلم يدع ماء في طريقه إلا طرح فيه جيف الموتى”! وبهذا تصل القوافل عطشى لا تستطيع مقاومته إذا هاجمتها قواته.
وعلى غرار القرامطة؛ كانت عصابات قطع الطريق من أعراب البادية تهديدا ماحقا لقوافل المسافرين من الحجاج وغيرهم، وخاصة في أوقات تراخي قبضة السلطات في العواصم المركزية. ولذا كان هؤلاء اللصوص من أبرز عوامل انقطاع الحج، سواء للقادمين من وسط آسيا إلى بغداد للانضمام للركب العراقي، أو الآتين من الأناضول وما حولها للالتحاق بالركب الشامي، أو أولئك الوافدين من الأندلس والمغرب والبلاد الأفريقية لمرافقة الركب المصري، بل وحتى القادمين من محور الجنوب حيث يأتي الحجاج من اليمن وما وراءه من بلاد الإسلام بمنطقة القرن الأفريقي.
وهذه هي محاور شبكات طرق الحج الرسمية لأن “المحامل السلطانية وجماهير الركبان لا تخرج إلا من أربع جهات: مصر، ودمشق، وبغداد، واليمن”؛ طبقا لمحمد كِبْرِيت الحسيني في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘.
ورغم محاولات السلطات المركزية التي تتبعها منطقة الحجاز -سواء كانت في العراق أو مصر أو غيرهما- القضاءَ بالقوة العسكرية على عبث العربان بركاب الحجيج؛ فإن ذلك لم يردع المعتدين من قطاع الطرق وغيرهم، سواء داخل الجزيرة العربية أو في الطريق قبل الوصول إليها. فابن الجوزي يقول إنه في سنة 361هـ/972م “وردت كتب الحاج بأن بني هلال اعترضوهم فقتلوا خلقا كثيرا فتعطل الحج، ولم يَسْلم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي (ت 400هـ/1010م) على طريق المدينة وتمّ حجهم”.

إتاوات مالية
ولم يَجِد العباسيون وغيرهم أمام هذه المصائب السنوية المتكررة إلا الرضوخ لمطالب قطاع الطريق؛ فكانوا يعطونهم أموالا معلومة على سبيل الإتاوة لتأمين طريق الحجاج بدلا من الاعتداء والسرقة والقتل، إلا أن تأخُّر أو تَلَف هذه الأموال -قبل وصولها إلى قادة هؤلاء القُطّاع- كان من الذرائع الكبرى التي بها يمنعون الحج. وكان من مشاهير قادة العربان الأُصَيْفِرُ المُنْتَفِقي (ت 410هـ/1020م) أو الأُصَيْفِر/الأصفر الأعرابي، الذي يصفه ابن الأثير المؤرخ بأنه “كان يؤذي الحاج في طريقهم”!!
ويذكر هذا المؤرخ أنه في سنة 384هـ/995م “عاد الحُجّاج من الثّعلبية (= بدع خضراء الواقعة اليوم بمنطقة حائل شمالي السعودية) ولم يحُجّ من العراق والشام أحدٌ، وسبب عودهم أن الأُصَيْفِر أمير العرب اعترضهم، وقال: إن الدراهم التي أرسلها السلطان عامَ أولَ كانت نُقْرة (= سبيكة) مَطْليّة (= مغشوشة)، وأُريد العوض، فطالت المخاطبة (= المفاوضات) والمراسلة، وضاق الوقتُ على الحُجّاج فرَجعوا” إلى بلادهم ولم يحجوا!!
وفي السنة الموالية، وحتى يتجنب العراقيون منعهم من الحج؛ اضطر أحد نبلاء الأمراء إلى تحمل ما فرضه عليهم هذا الأعرابي من مكوس جائرة؛ فقد ذكر المؤرخ جمال الدين ابن تَغْرْي بَرْدي (ت 874هـ/1470م) -في ‘النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة’- أنه في سنة 385هـ/996م “حج بالناس أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي (ت 389هـ/1000م) من العراق، وبعث بدر بن حَسْنَوَيْهِ الكردي خمسة آلاف دينار (= اليوم مليون دولار أميركي تقريبا) إلى الأصفر الأعرابي -الذي كان يقطع الطريق على الحاج- عوضاً عما كان يأخذه من الحاج، وجعل ذلك رسماً عليه (= ابن حَسْنَوَيْهِ) في كل سنة من ماله”، وبقي ذلك عادة لهذا الأمير طوال عشرين سنة كاملة حتى مات فانقطعت بوفاته!!
وكان زعيم العُرْبان في بادية شمال الجزيرة العربية ومناطق فلسطين والأردن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي (ت 404هـ/1014م) من أشهر المتمردين في أواخر القرن الرابع الهجري؛ فكان يقطع الطرق ويساوم الجميع على المال وإلا فالقتل بلا رحمة. فمما يرويه ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- أنه في 379هـ/990م “ورد الخبر في المحرّم بأن ابن الجراح الطائي خرج على الحاج بين سُمَيراء وفَيْد (تقعان اليوم في حائل السعودية) ونازلَهم، ثم صالحهم على ثلاثمئة ألف درهم وشيء من الثياب المصرية والأمتعة اليمنية، فأخذه وانصرف”!!
وقد تكررت اعتداءات الطائي هذا الذي أصبح مجرد ذكر اسمه لقوافل الحجيج القادمة من العرق والشام ومصر يمثل رُعبًا لهم لفترة طويلة؛ ففي سنة 397هـ/1007م “هبّت على الحُجّاج ريحٌ سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرضُ ولم يرَ الناسُ بعضهم بعضا، وأصابهم عطشٌ شديد، ومنعهم ابن الجراح الطائي من المسير ليأخذ منهم مالاً، فضاق الوقتُ عليهم فعادوا ولم يحجوا”؛ وفقا لابن الأثير.
وفي سنة 409هـ/1019م خرج حجيج العراق “فاعترضتهم العرب (= الأعراب) فيما بين القصر والحاجر (= اليوم بلدة البعائث بحائل السعودية)، والتمسوا منهم زيادة على رسومهم، فرجعوا من القصر وبطل الحج في هذه السنة”؛ حسبما يذكره الفاسي في ‘شفاء الغرام‘. وينقل الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- أنه في 424هـ/1034م “لم يحجّ العراقيّون ولا المصريّون أيضًا خوفًا من [أعراب] البادية، وحج أهلُ البصرة -مع من يخفرهم (= يحرسهم)- فغدروا بهم ونهبوهم”!!
ثم ظهرت الدولة الغزنوية فتجدد انقطاع رحلات ركب الحج العراقي طوال موسمين بسبب قطاع الطرق، وانحلت الأزمة بتدخل جماعة من الوجهاء حسبما يرويه ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- بقوله: “كان حاج العراق تأخر عن الحج سنة عشر وسنة إحدى عشرة (410-411هـ/1020-1021م)، فلما جاءت سنة اثنتي عشرة (412هـ/1022م) قصد جماعة من الناسُ يمينَ الدولة أبا القاسم محمود [بن سُبُكْتِكِيْن (الغزنوي مؤسس الدولة الغزنوية المتوفى 421هـ/1031م)] وقالوا له: أنت سلطان الإسلام وأعظم ملوك الأرض، وفي كل سنة تفتتح من بلاد الكفر قطعة، والثواب في فتح طريق الحج أعظم، والتشاغل به أوجب…؛ فانظر للَّه تعالى واجعل لهذا الأمر حظا من اهتمامك”. فما كان من هذا السلطان إلا أن وضع ترتيبات سياسية وأمنية لحماية الحجاج حتى “ساروا فحجّوا وعادوا سالمين”.
وربما استخدم قطاع الطرق هؤلاء أساليب تجسسية في رصد واستهداف قوافل المسافرين، فكانوا يرسلون إليها جواسيس ليتعرفوا على أخبارها من داخلها فيختاروا ضحاياهم بعناية، وخاصة إذا كانت القوافل كبيرة الحجم.
وفي ذلك يروي القاضي التنوخي -في ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة قاطع طريق تاب بسبب شجاعة تاجر حرير مسافر؛ فينقل بسنده عن هذا اللص التائب قوله: “وكان لنا عين (= جاسوس) في القافلة فعاد وعرّفنا أن في القافلة رجلا من أهل شاش (= طشقند) وفرغانة معه اثنا عشر حِمْلًا بَزًّا (= حرير)، وجارية في قبة عليها حلي ثقيل”.
وقد تمكن اللصوص -وكان عددهم سبعين شخصا- من اختطاف التاجر وجِماله بما عليها من متاع ثمين، فاحتال عليهم بالمفاوضة -مستعطفا إياهم بأنه ذاهب إلى الحجّ- حتى ردوا عليه بغلته، ثم فاوضهم حتى حصل منهم على قوسه وسهامها، فلما استعاد سلاحه قتل منهم ما يزيد على الثلاثين، ثم أخذ “جميع السلاح والدواب” والأموال ومضى لسبيله.
وفي الكتاب ذاته قصة أخرى تكشف بعض أساليب قطاع الطرق في الاحتيال على المسافرين؛ فقد كانوا يتوزعون إلى قسمين: قسم يتظاهر أصحابه بأنهم متخصصون في حراسة القوافل ليطمئن أهلها إليهم، فإذا اقتربوا من موضع معين انسحبوا بمجرد ظهور القسم الثاني من زملائهم في قطع الطريق، ويقولون للقافلة إنهم لا يستطيعون القتال بدعوى أن “هؤلاء قوم من بني فلان بيننا وبينهم شرّ وقتال، ونحن طَلِبَتُهم (= يطلبوننا) وَلَا ثبات لنا مَعَهم، وَلَا يمكننا خفارتُكم مَعَهم”!!
ثم ينقل التنوخي عن أحد المسافرين في القافلة قوله إن هؤلاء الحراس المفترضين “ركضوا منصرفين وَبَقينَا متحيرين، فَلم أَشك أَنهم كَانُوا من أهلهم (= اللصوص)، وَأَنَّهُمْ فعلوا ذَلِك بمواطأة (= مؤامرة) علينا” معهم!! ولكن القافلة تمكنت من النجاة بفضل حيلة من رئيسها.
حملات أمنية
وفي واقعة مماثلة؛ يحكي النويري -في ‘نهاية الأرب‘- أنه في سنة 312هـ/924م أرسل زعيم القرامطة جاسوسا رافق قوافل الحجاج أثناء عودتهم إلى العراق، وكان ينادي فيهم قائلا: “يا معشر الناس اُدْعُوا على القِرْمِطى عدوّ الله وعدوّ الإسلام”! ثم كان يسأل الحجاج عن هوية أمير قافلة الحج وأسماء من فيها من التجار وبلدانهم، وما إلى ذلك من معلومات مهمة تمكّنه من استهداف أصحابها وسلب ما معهم من مال ومتاع!!
وقد يكون الجمّالون وعمّال القافلة أسوأ من اللصوص حين يعترضون طريقها ويعتدون عليها؛ فبحُجّة السرقة التي تحدث من قطاع الطرق قد يختلس هؤلاء الجمالون والعمال أشياء من القافلة وينجون بها، حسب أبي بكر الخُوارِزْمي (ت 383هـ/994م) -في كتابه ‘الأمثال المولدة‘- في حديثه عن “الجمّالين والصعاليك الذين يصحبون العِير (= قافلة الطعام)؛ فربما قُطع عليها فيأخذون أكثر مما يأخذه اللصوص بعلّة القطع الواقع”!!
ويبدو أن تلك كانت إحدى أعظم مصائب المسافرين التي تنالهم من الجمّالين، الذين اشتهر معظمهم -وفقا للرحالة العراقي السويدي- بسوء السيرة والسلوك “لأنهم كلهم لا دين ولا مروءة ولا رَحِم ولا ديانة ولا أمانة [لهم]، بل إنهم يؤذون الحجاج ويسعون في أخذ أموالهم إما سرقة وإما استقراضا ولا يؤدونه”!!
وفي مقابل التهديد الدائم الذي شكلته عصابات قطاع الطرق على قوافل المسافرين والتجار؛ كانت سلطات الدول لا تدخر حيلة للقضاء عليهم وقطع دابرهم، بدءا بتجريد الحملات العسكرية لملاحقتهم وليس انتهاء بتدبير المكائد للإيقاع بهم بحوادث تسميم الطعام، كما في هذه القصة التي وقعت في عهد السلطان عضد الدولة البُوَيْهي (ت 372هـ/983م)، وحكاها شهاب الدين الأُبْشِيهي (ت 852هـ/1448م) -في كتابه ‘المستطرف في كل فن مستظرف‘- فقال:
“بلغ عضدَ الدولة أن قوما من الأكراد يقطعون الطريق، ويقيمون في جبال شامخة ولا يُقْدر عليهم، فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة، ودنانير وافرة، وأمره أن يسير مع القافلة ويُظهر أن هذه هدية لإحدى نساء الأمراء، ففعل التاجر ذلك، وسار أمام القافلة، فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال، وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به الجبل، فوجد به الحلوى فقبَّح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه، فاستدعاهم فأكلوا على مجاعة، فماتوا عن آخرهم، وأخذ أربابُ الأموال أموالَهم”!!
ولم تكن قوافل المسافرين بمنأى عن مخاطر تداعيات الصراع الإسلامي الصليبي خلال حقبة الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي (491-690هـ/1098-1261م) على تفاوت مراحلها في الاضطراب الأمني، رغم ما كان يتخللها من اتفاقات كفلت لقوافل الطرفين -وخاصة التجارية منها- الكثير من القدرة على الحركة والمرور الآمن في مناطق بين الإمارات الإسلامية والكيانات الاستيطانية الصليبية.
ومن أقدم وأعظم وقائع قطع الصليبيين لطرق القوافل الإسلامية ما ذكره ابن القَلانسي التميمي (ت 555هـ/1160م) -في كتابه ‘تاريخ دمشق‘- من أنه في سنة 506هـ/1112م علم الملك الصليبي بلدوين الأول (ت 512هـ/1118م) بأن “القافلة الدمشقية قد رحلت من بُصْرى إلى ديار مصر وفيها المال العظيم”، فنهض بجنوده في طلب القافلة حتى أدركوها في نواحي القدس “فاشتمل الإفرنج على ما فيها من الأمتعة والبضائع…، وحصل لبغدوين (= بلدوين) منها ما يزيد على خمسين ألف دينار (= اليوم دولار أميركي تقريبا) وثلاثمئة أسير…، ولم يبق بلد من البلاد [الإسلامية] إلا وقد أصيب بعض تجّاره في هذه القافلة”!!
ويسجل ابن جبير واقعة للصليبيين استهدفوا فيها المسافرين المسلمين برا وبحرا سنة 579هـ/1183م، فاستولوا -في عملية قطع طريق مركبة- على جميع قوافلهم البرية ومراكبهم البحرية؛ وذلك أنهم جهزوا سفنا في البحر الأحمر “وركبوها قاطعين بالحجاج… فأحرقوا فيه (= البحر) نحو ستة عشر مركبا. وانتهوا إلى عَيْذاب (= ميناء مصري كان على البحر الأحمر) فأخذوا فيها مركبا كان يأتي بالحجاج من جدة، وأخذوا أيضا في البر قافلة كبيرة تأتي من قُوص إلى عيذاب، وقتلوا الجميع ولم يُحْيُوا أحدا. وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن…، وأحدثوا حوادث شنيعة لم يُسمع مثلها في الإسلام”!! ثم لاحقتهم فرقة من الجيش الأيوبي بمصر حتى اعتقلتهم ولقوا جزاء فعلتهم النكراء.
وفي نهاية القرن نفسه؛ يؤرخ رجل الدولة الأيوبي عماد الدين الأصفهاني (ت 597هـ/1201م) -في ‘البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان‘- لحادثة أخرى وقعت سنة 587هـ/1191م، وفيها “أخذت الفرنج القافلة… وفَقَد المسلمون فيها من الأموال ما لا يُحَدّ، وهلك من البضائع ما لا يُحصى للتجار والجند، وكان الأمر عظيما”!!
ويبدو أن تلك الحوادث كانت استثناء -وإن لم يكن نادرا- من الحالة العامة التي لاحظها الرحالة ابن جبير، مقررا أن أمن الطرق كان مستتبا بين المسلمين والصليبيين في الفترة التي زار فيها الشام في الربع الأخير من القرن السادس الهجري/الـ12م، ولم تتعطل الحركة التجارية بين أقاليم المتحاربين حتى في أوقات احتدام المعارك بينهم.
ويلخص ابن جبير مشاهداته تلك بقوله إن “اختلاف (= تردد) القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج (= المستوطنات الصليبية) غير منقطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة (= عكّا) كذلك، وتجار النصارى أيضا لا يُمنع أحد منهم ولا يُعترَض…، والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية، والدنيا لمن غَلَبَ…، ولا تُعترَض الرعايا ولا التجار، فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سِلْمًا أو حربا”!!

صعوبات بيئية
ومن العقبات التي كثر تضرر المسافرين بها وتواترت شكواهم منها؛ ما كانوا يلاقونه في أسفارهم من صعوبات مناخية وجغرافية تتعلق بطبيعة الأرض وتضاريسها؛ فالفقيه الرحالة ابن فضلان يتحدث عن أنه اضطره البرد القارس إلى تأخير سفره أياما عديدة مقيما بمدينة الجُرْجانية التي توجد اليوم غربي أوزبكستان وكانت أيامَها عاصمة مملكة خُوَارِزْم، ويعلل ذلك بقوله في كتاب رحلته: “وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدّته”.
وشدة البرد لم تكن تدفع المسافرين إلى طلب ملاجئ حماية منها لأنفسهم فقط، وإنما لدوابهم أيضا حتى لا تهلك بالبرد؛ ولذا يحدثنا البكري الأندلسي بأن نواحي مدينة تبسة بالشرق الجزائري اليوم كانت “فيها أقْباء (= جمع قَبْو) يدخلها الرفاق (= القوافل) بدوابّهم في زمن الثلج والشتاء، يسع القبو الواحد ألفيْ دابّة وأكثر”!!
ويحدثنا الرحالة اليهودي الأندلسي بنيامين التُّطَيلي (ت 569هـ/1173م) -في كتاب رحلته- عن سلوك قوافل التجارة لطريق “درب الأربعين” الرابط بين مصر وغربي السودان اليوم وما وراءه من منطقة وسط وغرب أفريقيا. وقد سمي الطريق بهذا الاسم لأن القوافل كانت تجتازه في رحلة تمتد أربعين يوما، وإن كان هذا الرحالة يذكر أن “مسيرتها خمسون يوما”، ثم يصف العقبات البيئية في هذا الطريق قائلا: “وفي الصحراء كثبان الرمل التي إذا عصفت بها الرياح أثارتها وغطت القوافل السيارة فأهلكتها. وتحمل هذه القوافل السلع التجارية المتنوعة” في ذهابها وإيابها.
ولا تقلّ منغصات السفر بحرا عن نظائرها في البر إن لم تفقها كثرة وخطورة؛ فرغم ما تضمنته الأساطيل البحرية -مدنيةً وعسكريةً- من أسباب الراحة ووسائل الأمان فإن حياة البحر اشتُهرت بالمغامرات والأخطار وما يلاقيه أهلها من أهوال طبيعية تتصل بظروف البحر وتقلبات الطقس، أو مخاطر بشرية كظاهرة الخطف والقرصنة.
وقد دُوِّنت حوادث ذلك في قصص رحلات البحار وأساطيرها، ونشأ عنه في الثقافة العربية لون من “الأدب البحري” كانت بدايته من شواطئ مدينة سيراف على الساحل الغربي لإيران؛ إذْ كانت مركزًا لتلاقي البحارة والتجار من مختلف الأجناس والأقطار.
ونجد أقدم هذه القصص في كتاب «رحلة السيرافي» التي يرجع تاريخ جمعها إلى النصف الثاني من القرن الثالث/التاسع الميلادي، ويصف فيها رحالةٌ يسمى سليمان التاجر (ت بعد 237هـ/851م) رحلته إلى الصين ممزوجةً بحكايات المغامرات البحرية التي سمعها من الربابنة العرب المسافرين بين البصرة والصين، وقد وصلتنا هذه الرحلة مدوّنة ومزيدة بقلم معاصرٍ لصاحبها اشتهر بأبي زيد السِّيرافي (ت بعد 330هـ/942م).
وتحدثنا «رحلة السيرافي» هذه عن أساطير تتعلق بالأعاصير والزوابع التي كان يشاهدها الربابنة والنواخذة (مُلّاك السفن) آنذاك في بحر الهند؛ فيقول: “ذكر لي جماعة من النواخذة أنهم ربما رأوا في هذا البحر سحابا أبيض قِطعاً صغارا، يخرج منه لسان أبيض طويل حتى يتّصلَ بماء البحر، فإذا اتصل به غلا البحر لذلك وارتفعت منه زوابع عظيمة لا تمرّ زوبعة منها بشيء إلا أتلفته”!
ويقصّ علينا ابن جبير تجاربه مع أهوال السفر البحري من الأندلس إلى المشرق الإسلامي ذهابا وإيابا؛ فيروي من ذلك المشهد التالي الذي عايشه في البحر الأبيض المتوسط: “وطرأ علينا -من مقابلة (= جهة) البَرّ- في الليل هوْلٌ عظيم عصم الله منه بريح أرسلها الله تعالى في الحين من تلقاء البر، فأخرجنا عنه…، وقام علينا نوْءٌ هالَ (= هاجَ) له البحر… فبقينا مترددين بسببه حول برّ سردانية (= جزيرة سردينيا الإيطالية)…، فأطلع الله علينا -في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا نميز شرقا من غرب- مركبا للروم قصَدَنا إلى أن حاذانا، فسُئل عن مقصده فأخبر أنه يريد جزيرة صقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية (= بإسبانيا)، وقد كنا استقبلنا طريقه التي جاء منها من غير علم، فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره…، فخرج علينا طرف من بَرّ سردانية المذكور، فأخذنا في الرجوع عودا على بدء”!!
أما الرحلة في البحر الأحمر من ميناء عَيْذاب بمصر إلى ميناء جدة؛ فخطورتها -عند ابن جبير- تكمن في استغلال أهل عيذاب للمسافرين: “ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت! وذلك أنهم يشحنون بهم الجُلّاب (= التجار) حتى يجلس بعضهم على بعض، وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المملوءة، يحمل أهلَها على ذلك الحرصُ والرغبة في الكراء حتى يستوفي صاحب الجلبة منهم ثمنها في طريق واحدة، ولا يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك! ويقولون: «علينا بالألواح، وعلى الحجاج بالأرواح»!! وهذا مثَل متعارَف بينهم! فأحق بلاد الله بحِسْبة يكون السيفُ دِرَّتَها (= أداة عقابها) هذه البلدة! والأولى بمن يمكنه ذلك ألا يراها، وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق”.
وربما شكّلت الحيوانات المستأنسة أيضا معضلة للمسافرين؛ فالتنوخي يروي -في ‘نشوار المحاضرة‘- حكاية طريفة وقعت لقطيع من القردة مع قافلة كانت تسير “في بعض طرقات اليمن، ومعهم رجل معه قفص فيه قَلَانِس (= جمع قَلَنْسُوَة)، فأصابتهم سماء (= مطر)، فابتلّت القلانس، فأخرجها الرجل فنشرها في الشمس لمّا نزلوا، وإذا بقطعة عظيمة من القرود قد أحاطوا بالقافلة”، فأخذ كل قرد منها قَلَنْسُوَة ووضعها على رأسه، فاستبد بتاجر القلانس الحزن على ضياع بضاعته حتى “تكرم” عليه القردة بإرجاعها كلها!
بل إن الحشرات -على ضعفها- قد تتسبب في كارثة لقوافل المسافرين؛ ومن صور ذلك ما يحكيه الجاحظ -في كتابه ‘الحيوان‘- عن أسراب الذباب قائلا: “والذّبان جند من جند الله شديد الأذى…، وربما أتت على القافلة بما فيها؛ وذلك أنّها تغشى الدوابَّ حتّى تضرب بأنفسها الأرض -وهي في المفاوز- وتسقط، فيهلك أهل القافلة لأنهم لا يخرجون من تلك المفاوز على دوابهم”.

ترتيبات وتجهيزات
كان الاتفاق على مبلغ الكراء بين المسافرين والجمّالين في القافلة يتم تبعا لموقع محطة الوصول الذي تُحدَّد مسافته بعدد الأيام أو بـ”المراحل”، و”المرحلة” هي المسافة التي تقطعها القافلة في اليوم الواحد، ويتفاوت تقديرها -حسب المتعارف عليه في مختلف الأقاليم الإسلامية- ما بين 35-50كم.
فيقول ابن جبير مثلا عند انتقاله إلى قافلة الركب العراقي: “وقد كمل اكتراؤنا إلى الموصل وهي وراء بغداد بعشرة أيام”، أي أنه قام بالاتفاق مع شخص ما ليوفر له الراحلة من بغداد إلى الموصل وحدد له المسافة بعشرة أيام، أي ما يعاد 350كم التي هي المسافة الفاصلة اليوم بين المدينتين، وبذلك يكون اليوم/المرحلة يساوي 35كم في مصطلح أهل العراق آنذاك. فإذا اتفق المسافر مع أحد الجمّالين على حمله؛ ركب “في أحد شِقّيْ المحْمل ووضع متاعه في الشق الآخر، ومضى مع الناس في القافلة”؛ طبقا للبكري.
وكانت مهنة الجمّالين تدر على أصحابها أموالا وفيرة ولاسيما إن كانوا يحملون للقوافل التجارية الكبيرة؛ فالكاتب العباسي أبو بكر الصُّولي (ت 335هـ/946م) يخبرنا -في كتابه ‘أخبار الراضي والمتقي‘- عن ضخامة إحدى هذه القوافل، فيذكر “أن تاجراً -من قطيعة الربيع (= منطقة ببغداد)- حمل أمتعة في هذه القافلة لزمه لكَرْي أحماله نحو ألفي دينار (= اليوم 400 ألف دولار أميركي تقريبا)؛ فما ظنك بمتاع هذا مبلغ كرائه؟!”.
وقد يمارس حرفة الجِمالة الحُجّاج أنفسُهم، وخاصة من عرب العراق إذا كانوا يمتلكون الجمال؛ فالرحالة ابن حوقل يفيدنا بأن “أكثر الحجاج يحجّون على جمالهم، لأنهم مع قُنْيتهم (= امتلاكهم) الجِمال جمّالون، فيحملون أهلَ ما وراء النهر (= منطقة آسيا الوسطى) إلى ما دون ذلك الى مكة”.
وربما أدت الحروب والأزمات السياسية والمجتمعية إلى الغلاء في الكراء بسبب زيادة الطلب جراء كثرة الفارين من منطقة الأزمة، كما حصل في الشام سنة 700هـ/1300م عندما “وصلت [الأخبار] بقصد التتار البلاد، والناس بدمشق مهتمون بأمر الهرب إلى الديار المصرية والكرك وغيرهما، والأراجيف يتبع بعضها بعضا…، وغلت الأكرية وبلغ كري المحارة (= محْمل الجمل) إلى مصر خمسمئة درهم (= اليوم 1000 دولار أميركي تقريبا)، وبلغ ثمن الجمل ألف درهم، وثمن الحمار خمسمئة درهم، وباع الناس الأمتعة بالثمن البخس”؛ طبقا للإمام المؤرخ عَلَم الدين البِرْزالي (ت 739هـ/1338م) في كتاب ‘تاريخ البرزالي المقتفي لتاريخ أبي شامة‘.
ولا تقلّ تلك الأرقام في اقتصاديات السفر البحري؛ فقد أورد إمام الأدب محمد بن يزيد المبرّد (ت 285هـ/898م) -في ‘الكامل في اللغة والأدب‘- أن عدد العاملين في النقل النهري ببغداد في عهد الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/833م) وصل إلى “نيف وسبعين ألف ملّاحٍ”. ويروي التنوخي بشأن إحصائيات حركة النقل في نهر دجلة -في عهد الخليفة المقتدر العباسي (ت 320هـ/922م)- أنه سُجّل “ما يصل إلى أصحاب المعابر (= موظفيها ببغداد)… من [رسوم] الملّاحين فكان في كلّ يوم أربعين ألفا أو ثلاثين ألفا”.
وسبق لنا إيراد ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي -في ‘تاريخ بغداد‘- من أنه في سبعينيات القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي “أحصِيتْ السُّمَيْرِيّات (= نوع من السفن) المَعْبَرانِيّات (= العبّارات/المُعديات) بدجلة… فكانت ثلاثين ألفا، قُدّر من كسْب ملاحيها في كل يوم تسعون ألف درهم (= اليوم 180 ألف دولار أميركي تقريبا)”.
أما تكاليف الخروج للمهام الرسمية والتنقلات لكبار الموظفين؛ فقد كانت تصل أحيانا إلى ثلاثين ألف درهم (= اليوم 60 ألف دولار أميركي تقريبا) لنقل الموظف من سامراء إلى الرقة شمالي وسط سوريا اليوم، حيث كان ذلك متضمنا تكلفة حمله هو وخدمه مع الأوراق والأغراض اللازمة للعمل؛ طبقا للتنوخي الذي أورد ذلك -في ‘الفرج بعد الشدة‘- على لسان رجل دولة عباسي كُلِّف بالخروج في مهمة رسمية، فقال: “أما خروجي فالسمع والطاعة لأمير المؤمنين، وأما الذي أحتاج إليه للنفقة فهو ثلاثون ألف درهم. فما برحتُ حتى دُفعت إليّ، وقالوا: اخرج الساعة”!
ويوثق المؤرخ الجغرافي والإداري عُبيد الله ابن خُرْداذِبَهْ (ت 300هـ/912م) -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- الميزانية السنوية لخدمات أسفار مؤسسة البريد ورواتب عمالها في الدولة العباسية؛ فيقول إن “نفقات الدوابّ وأثمانها وأرزاق البنادرة (= المقيمين بالبندر: الميناء) والفُرَانِقِين (= رُسُل البريد) لسنة مئة ألف دينار وتسعة وخمسون ألفا ومئة دينار (159100 دينار = اليوم 32 مليون دولار أميركي تقريبا)”.
أما توفير المؤن والأعلاف لسفريات الوفود الرسمية في الدولة المملوكية؛ فيروي القلقشندي -في كتابه ‘صبح الأعشى‘- أن إجراءات صرف الأعلاف من اختصاص المسؤول عن مخازن الغلال السلطانية الذي كان يُدعى “مباشر الأهراء” جمْع هُرْي وهو صومعة الحبوب، وذلك بالتنسيق مع إدارة حكومية كانت تسمى “ديوان التسفيرات”، أي تجهيزات أسفار الوفود الرسمية.
ومن إحصائيات الميزانيات السفرية لبعثات الحج الرسمية في الدول الإسلامية؛ ما يورده المؤرخ الأشهر للدولة الفاطمية ونُظُمها تقي الدين المقريزي، الذي يقول -في ‘المواعظ والاعتبار‘- إن “المُنْفَق على الموسم كان في كل سنة تسافر فيها القافلة (= قافلة الحج): مئة ألف وعشرين ألف دينار (120000 دينار = اليوم 24 مليون دولار أميركي تقريبا)، منها ثمن الطيب والحلواء والشمع راتبا في كل سنة: عشرة آلاف دينار، ومنها نفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة: أربعون ألف دينار، ومنها في ثمن الحِمَايات، والصدقات، وأجرة الجمال، ومعونة من يسير من العسكرية، وكبير الموسم، وخدم القافلة، وحفر الآبار، وغير ذلك: ستون ألف دينار”.
ويذكر المقريزي -في ‘اتّعاظ الحُنَفاء بأخبار الأئمة الخلفاء‘- أن تلك الميزانية ظلت تزيد سنويا -في أوْج ازدهار الدولة الفاطمية- حتى إذا كان منتصف القرن الخامس الهجري/الـ11م “بلغت إلى مئتيْ ألف دينار (= اليوم 40 مليون دولار أميركي تقريبا)، ولم تبلغ النفقة على موسم الحج مثل ذلك في دولة من دول الإسلام قط”!!

تموين متنوع
يتزود المسافرون عادة لأسفارهم قبل مغادرة محطات الانطلاق، حتى استقر عند الناس أن “زاد المسافر مقدَّم على رحيله”؛ طبقا لإمام ابن كثير (ت 774هـ/1372م) في ‘البداية والنهاية‘. ومع ذلك؛ فإنهم معرّضون لنفاد الزاد أثناء السفر مما يجعل من الضروري توافر خدمات وتسهيلات متعددة ومنوعة على طول الطريق، وفي محطاتها المختلفة من قرى وبلدات، وهو ما يتيح فرصا للانتفاع المادي والكسب التجاري لأبناء هذه التجمعات السكنية.
ويأتي التكافل المتبادل والشِّرْكة في الزاد بين أصحاب الرفقة الواحدة في مقدمة التسهيلات التي يتلقاها المسافرون، ولاسيما إن كان بينهم أحد أعيان المجتمع من المحسنين الموسرين. ومن النماذج المعبّرة لذلك ما رواه المؤرخ أبو الحسن البَلاذُري (ت 279هـ/892م) -في كتابه ‘أنساب الأشراف‘- من أن “عُبيد الله بن العباس (بن عبد المطّلب المتوفى 58هـ/679م) وَفَدَ على معاوية (بن أبي سفيان المتوفى 60هـ/681م) فصحبه بَشَر كثير في الرفقة، فكان يَمُونُهم (= ينفق عليهم)، ولم يَدَعْ أحدا منهم يوقد نارا ولا يتكلف شيئا حتى ورد الشام”!!
أما عن مرافق خدمات التموين على الطريق؛ فيخبرنا ياقوت الحموي -في ‘معجم البلدان‘- عن أن سكان مدينة الفَرَما -التي كانت تقع بين العريش وبورسعيد شمال شرقي مصر- كان “أكثر متاجرهم في النوى والشعير والعلف لكثرة اجتياز القوافل بهم”. وعرّف أيضا ببلدة العريش المصرية فقال إنها تقابلها بلدة في الناحية الشامية من الحدود، ثم وصف البلدتين بانهما “هما بئران عظيمتان ترد عليهما القوافل، وعند هما أخصاص (= عرائش) فيها باعة” يتاجرون مع أصحاب القوافل.
ويذكر المقريزي -في ‘المواعظ والاعتبار‘- أنه “كانت طُرُق الشام عامرة يوجد بها عند كل «بريد» (= 20كم تقريبا) ما يحتاج إليه المسافر من زاد وعلف وغيره”. وخيل السفر بالبريد مخصصة عادة لنقل ما يتعلق بالسلطات الرسمية من شخصيات حكومية وقرارات رسمية وتقارير إدارية، ولكن قد “يركبه من يريد السفر من الأعيان بمرسوم سلطانيّ”؛ طبقا للمقريزي.
ويصف ابن بطوطة محطة الثعلبية -التي كانت في آخر طريق الحج من جهة العراق- فيقول إنه “يجتمع من العرب بهذا الموضع جمع عظيم فيبيعون الجمال والغنم والسمن واللبن” إلى المسافرين، وبعدها مباشرة محطة بركة المرجوم التي يذكر أن أهلها “يقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى ذلك”. أما ابن جبير فيصف أثر ذلك النشاط التجاري الموسمي على أصحابه من عامة أهل البادية، قائلا إنهم “ينتعشون مع الحاج في التجارات والمبايعات وغير ذلك من المرافق”.
كما يخبرنا ابن بطوطة عن بعض خطوط السفر بمنطقة المليبار في جنوب الهند؛ فيقول إنه “في جميع المنازل بهذا الطريق ديار المسلمين ينزل عندهم المسلمون، فيبيعون منهم جميع ما يحتاجون إليه ويطبخون لهم الطعام، ولولاهم لما سافر فيه مسلم”!
وربما تعاطى تجارةَ الخدمات السفرية على الطريق بعضُ الموصوفين بالعلم والأدب، أو المنتسبين إلى بيوت الشرف والمكانة؛ فمن نماذج الفئة الأولى ما ذكره الإمام أبو سعيد السَّمْعاني (ت 562هـ/1167م) -في كتابه ‘الأنساب‘- من أن الأديب البارع أبا الحسن صافي بن عبد الله الصَّوّافي المُنَادي (ت بعد 538هـ/1143م) “كان شيخاً يحج كل سنة، ويبيع الأشياء في طريق مكة إذا نزلت القافلة بالدِّلالة (= السمسرة)، ويتعيّش بها”.
وأما الفئة الثانية؛ فمن أمثلتها ما شاهده ابن جبير في أنحاء جدة من وجود بعض الأشراف الهاشميين الذين “يستخدمون أنفسهم في كل مهنة من المهن: من إكراء جمال إن كانت لهم، أو مَبيعِ لبنٍ أو ماءٍ، إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حطب يَحْتَطِبُونَه، وربما تناول ذلك نساؤُهم الشريفاتُ بأنفسهن”!!
ويكثر أن يكون أهل قافلة ما موضع حفاوة من أهل المحطات الكبرى التي ينزلون بها في طريقهم، ولاسيما إذا كان في مسافريها شخصية علمية أو صوفية كبيرة؛ كما حصل للقافلة التي كان فيها الشيخ الصوفي نجم الدين الأصفهاني (ت بعد 730هـ/1330م) وأحدُ كبار أصحابه، فإنهم سافروا من الإسكندرية يريدون مكة المكرمة “فلما وصلوا إلى عَيْذاب تلقاهم الناس وأضافوهم كثيرا، فكان النجم يبعث بالطعام إلى أهل القافلة التي صحباها”؛ وفقا للسخاوي في ‘التحفة التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‘.
وقد يضطر المسافر للعمل خلال رحلته ليصرف على احتياجاته، حتى ولو وجد من يساعده ويشركه في زاده ومؤونته؛ فقد عمل الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م) مع الجمّالين ليوفر نفقة سفره إلى اليمن طلبا لرواية الحديث على الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ/826م).
وفي ذلك يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه ‘صفة الصفوة‘: “وعن إسحق بن راهَوَيْه (ت 238هـ/852م) قال: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة فأكرى نفسه من بعض الجمّالين إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة (= مشاركتهم زادهم) فلم يقبل من أحد شيئاً”!!
كما عمل الرحالة ناصر خُسْرَوْ في إحدى قلاع منطقة الأفلاج -الواقعة اليوم شرقي المملكة العربية السعودية- نقّاشا، ليحصّل نفقات بقية طريقه عائدا من مكة إلى بلاده؛ فقد نَقَشَ لأهل تلك القلعة في محراب مسجدهم نقوشا وكتابات بمقابل مالي. وعن ذلك يحدثنا قائلا: “وَكَانَ معي قَلِيل من اللونين القرمزي واللازَوَرْد فَكتبت على حَائِط الْمَسْجِد بَيت شعر وَوضعت فِي وَسطه ورق الشّجر، فرأوه وتعجبوا، وتجمّع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه، وقالوا لي: إِذا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك مئةَ «مَنٍّ» تَمْراً (= 80كغ تقريبا)”، فأنجز عمله وقبض مكافأته من التمر الذي يذكر أن له قيمة عالية عند سكان الأفلاج.

فنادق وخانات
ومن أبرز مرافق الخدمات للمسافرين ولاسيما التجار منهم: “الخانات” جمع خان، وهي نُزُل تشبه الفنادق وتُسمَّى باسمها فعلا في منطقة الغرب الإسلامي والأندلس، إلا أنها تتميز عنها بأنها تحتوي -إلى جانب غرف الإقامة- على مخازن للسلع التجارية ومرابط للدواب، وكانت تقام -في الغالب- على أطراف المدن وأحيانا داخلها.
وقد يطلق على الخانات في بعض الأقاليم اسم “الخانبارات” ومفردها “خانبار”، وهذه تشتمل على محلات لبعض الحرفيين مثل الصاغة والخياطين إضافة إلى مخازن السلع. وربما جاءت من ذلك لفظة “الأنبار” التي هي “بيت التاجر الذي ينضّد فيه المتاع، الواحد: نِبْرٌ بالكسر”؛ وفقا للإمام مرتضى الزَّبيدي (ت 1205هـ/1790م) في ‘تاج العروس من جواهر القاموس‘.
ويشير أبو البقاء الكَفَوي (ت 1094هـ/1683م) إلى اختصاص “الخان” بالمسافرين بقوله معرفا إياه في كتابه ‘الكليات‘: “والخان: مكانُ مَبِيتِ المسافرين”. أما المستشرق رينهارت دُوزي (ت 1300هـ/1883م) فيعرّف -في كتابه ‘تكملة المعاجم العربية‘- الخانات ووظيفتها التجارية للمسافرين بقوله: “والخان هو: محل النزلاء من التجار الغرباء وموضع إيداع بضائعهم، فالمخازن في الطابق السفلي، والسكن في الأعلى”.
ويبدو أن وجود الخانات في القرى الصغيرة على الطرق الخارجية قديم الوجود في حضارتنا، ويعود -على الأقل- إلى ما قبل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي؛ كما يُفهم من حديث الإمام إسحق بن منصور الكَوْسَج المَرْوَزي (ت 251هـ/865م) -في كتابه ‘مسائل الإمام أحمد وإسحق بن راهويه‘- عن “الخان الذي في القرية السابلة لمن يسكنه من المُنتابين (= الزُّوار)”.
على أن هذا الوجود صار -في القرون اللاحقة- واسع الانتشار ومجاني الخدمات في بعض الأقطار؛ فالجغرافي الفقيه زكرياء بن محمد القَزْوِيني (ت 682هـ/1281م) يورد -في كتابه ‘آثار البلاد وأخبار العباد‘- ضمن وصفه لبلاد الروم (تركيا الحالية) أن “بها الخانات على طرق القوافل: على كل فرسخ (= 5كم) خان، بنتها بَناتُ السلاطين للثواب، فإن البرد بالروم ثمانية أشهر والثلج كثير، والقَفْل (= القوافل) لا ينقطع في الثلج، فيمشون كل يوم فرسخا وينزلون في خان من الخانات”.
ثم وصف ما تحتوي عليه هذه الخانات من التجهيزات والتسهيلات المجانية المخصصة للمسافرين؛ فقال إنه “يكون فيه من الطعام والشعير والتِّبْن، والحطب والبِزْر (= التوابل)، والإكاف (= سرج الحمار/البغل) والنعال والْمَنْقَل (= الخُفّ)، وإنها خير عظيم لم يُبْنَ مثلُها في شيء من البلاد”!!
ويذكر ابن جبير اعتماد المسافرين على المرافق الخدمية التجارية التي تحتوي عليها خانات الشام بقوله عن مدينة حماة السورية: “ورَبَضُها (= ضاحيتها) كبير فيه الخانات والديار، وله حوانيت يَستعجل فيها المسافرُ حاجاتِه إلى أن يفرغ لدخول المدينة”.
وفي أواسط القرن الثامن الهجري/الـ14م؛ يسجل لنا ابن بطوطة مشاهداته عن الخدمات التي تقدمها محطات الاستراحات والفنادق في سيناء، وخاصة في مدينة العريش وما حولها؛ فيقول: “وبكل منزل (= محطة طريق) منها فندق -وهم يسمونه الخان- ينزله المسافرون بدوابهم، وبخارج كلِّ خانٍ سانيةٌ (= دَلْوٌ) للسبيل، وحانوت يشتري منها المسافر ما يحتاجه لنفسه ودابته”.
ويتحدث ابن حوقل عن فنادق نيسابور وارتباطها بالمِهَن والتجارات؛ فيقول -في كتابه ‘صورة الأرض‘- إن فيها “خانات وفنادق يسكنها التجّار بالتجارات، وفيها الخانْبَارات (= مخازن السلع/محلات الصاغة والخياطين) للبيع والشِّرَى، فيُقصد كلُّ فندق بما يعلم أنّه يغلب على أهله من أنواع التجارة، وقلّ فندق منها لا يضاهي أكابر أسواق ذوي جنسه! ويسكن هذه الفنادق أهل اليسار ممّن في ذلك الطريق من التجار وأهل البضائع الكبار والأموال الغِزار، ولغير المياسير فنادق وخانات يسكنها أهل المهن وأرباب الصنائع بالدكاكين المعمورة والحُجَر المسكونة والحوانيت المشحونة بالصنّاع”.
أما الأمير الكردي بدر بن حَسْنَوَيْهِ فيتحدث ابن الجوزي عن سيرته واستتباب الأمن في إمارته، وتوفيره مختلف التسهيلات للمسافرين في أراضيها؛ فيشير إلى عمله في إصلاح الطرق وتأمينها وتيسير الحركة فيها، وأنه في هذا الإطار “استحدث في أعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان للغرباء”! بل إنه بالغ في رعاية المسافرين من الحجاج حتى إنه كان “يصرف في كل سنة ثلاثة آلاف دينار إلى الأساكفة والحذّائين بين همذان (= تقع غربي إيران) وبغداد، ليقيموا للمنقطعين (= المحتاجين) من الحاجّ الأحذيةَ”!!
وكذلك يشير ناصر خُسْرَوْ -في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري/الـ11م- إلى الملاذات التي كانت تستقبل المسافرين في جنوب الأناضول؛ فيقول في كتابه ‘سفر نامه‘: “ونزلنا فِي «رِبَاط كَرَوَانْسَرَايْ» [فـ]ـكانت السماء تُمطر ثلجا والبرد قارسا”! و”َكَرَوَانْسَرَايْ” لفظة فارسية مركبة من مقطعيْن: “كَرَوان” وهي: القافلة، و”سراي” معناها: المنزل؛ فيكون معنى هذه اللفظة: “منزل القافلة”.
ويتحدث ابن جبير عن أوقاف وزير الزنكيين بالموصل جمال الدين الأصفهاني (ت 559هـ/1164م) فيقول إنه “ابتنى بالمدن المتصلة من العراق إلى الشام فنادق عيّنها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف أحدهم عن تأدية الأكرية (= الإيجار)، وأجرى على قَوَمَة (= المشرفين) تلك الفنادق والمنازل ما يقوم بمعيشتهم” من الرواتب الثابتة.
كما يشير ابن جبير إلى خانات حلب وبلاد الشام المخصصة لخدمة المسافرين؛ فيقول إن “خانات هذا الطريق كأنها القلاع امتناعا وحصانة، وأبوابها حديد وهي من الوثاقة في غاية”، ثم يُثْني على “سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدها”. ويبدو أن العامل الأمني كان مؤثرا جدا في ترتيب الخانات على هذا الوضع الذي اعتمدته الدولة الأيوبية في عهد السلطان الناصر صلاح الدين (ت 589هـ/1193م).
وقد يتخذ المسافرون من سطح الخان مكانا للمبيت مقابل أجرة أيضا؛ حسبما يحكيه التنوخي -في ‘الفرج بعد الشدة‘- ضمن قصة كشف جريمة، وفي بدايتها أنه “بات في سطح خان في بعض الأسفار”، ومن خدمات الخانات وجود “الخانيّ والسِّرَاجُ في يده يطوف به زوايا الخان” لحراسة مَنْ يكون فيه ليلا من النزلاء.
وإلى جانب الخانات؛ كانت الفنادق وسط المدن الكبرى تقدم خدمات الإقامة والإعاشة لنزلائها من المسافرين، فقد أدت مثلا حركة العابرين بين العدوة الأندلسية ومقابِلتها المغربية إلى ازدهار خدمات قِطاع الفنادق في مدينة سبتة الساحلية قُبيل احتلال البرتغاليين لها سنة 818هـ/1415م.
ولذا يرصد محمد بن القاسم السَّبْتي (ت 825هـ/1422م) -في كتابه ‘اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سَنِيّ الآثار‘- هذا الازدهار في الخدمات الفندقية، ويصف التميُّزَ العمرانيَّ في منشآتها ومرافقها؛ فيقول: “وعدد الفنادق حسبما استفاض على ألسنة أهل البلد: ثلاثمئة وستون فندقاً…، وجملة من هذه الفنادق مشتملة على العدد الكثير من سواري الرخام وأعمدته”!
ويذكر السبتي أن فنادق مدينته كانت تتيح للتجار المسافرين خدمات التخزين للبضائع إضافة إلى تسهيلات السكن؛ فيقول إن “أعظمها بناءً وأوسعها ساحةً الفندق الكبير المُعَدّ لاختزان الزرع…، يحتوي على اثنين وخمسين مخزناً ما بين هُرْي (= صومعة حبوب) وبيت”، مشيرا إلى أن من بين هذه “الفنادق المعدَّة لسُكْنَى الناس -من التجار وغيرهم- الفندق المعروف بـ«فندق ابن غانم»، ويشتمل على ثلاث طبقات وثمانين بيتا وتسع مصريات (= -شقق صغيرة)”!!

تنظيمات إدارية
تطورت إجراءات العبور في الأسفار بين الدول قديما، وبالتدريج تحولت من مجرد المكاتبات الخاصة بالوفود الرسمية لتيسير إجراءاتها وتأمينها حتى وصلت إلى مرحلة تقييد أسماء المسافرين ومطابقتها الأمنية، بل والعمل بأساليب التفتيش الذاتي كما يحدث اليوم في تحركاتنا في المطارات وعند منافذ الحدود.
وهكذا كانت الكتابة الرسمية بالسماح بالمرور بدون التعرض للمسافرين -وخاصة الوفود الرسمية- إجراء معتمدا؛ فقد حمل الفقيه أحمد بن فضلان من بلاط الخليفة العباسي المقتدر ببغداد كتابا رسميا يطالب سلطات البلاد التي سمير بها بتسهيل إجراءات رحلته حتى يؤدي مهمته، وكان يسلم هذا الخطاب إلى ولاة الأقاليم ويحصل في المقابل على تسهيلات المرور والحماية، حتى وصل إلى بلاد الأمير نصر بن أحمد الساماني (ت 331هـ/943م) الذي كتب لولاته في الحدود “بعدم العرض (= التعرض)” لوفده، وأعطاهم كتابا آخر بضمان الحراسة عند نقاط الحدود فكتب “بباب الترك (= منفذ حدودي) ببذرقتنا (= الحماية المرافقة) وترك العرض لنا”.
وعندما تسلَّم والي مصر العباسي أحمد بن خالد الصَّرِيفِيني (ت بعد 248هـ/862م) عملَه من الوالي السابق عليه سليمان بن وَهْب (ت 272هـ/885م) طلب منه الانتظار بمنطقة محددة، حتى يرتب له الحماية الأمنية -في عودته إلى بغداد- لكون الطريق غير آمن، فخاطبه قائلا: “تقيم في أول منزل (= منحطة طريق) على خمسة فراسخ (= 25كم تقريبا) إلى أن أزيح علةَ قائدٍ يصحبك… فإن الطريق فاسد”؛ وفقا للتنوخي في ‘الفرج بعد الشدة‘.
ثم تطورت لاحقا تلك الإجراءات فشملت أساليب معقدة ومتعددة من قبيل الاستعلام عن أسماء المسافرين، وتفتيش مقتنياهم وفرض رسوم عبور عليها، وإن كان قد يتسنى لبعض المسافرين الحصول على إعفاء من تلك الرسوم ولاسيما من كان منهم صاحب مكانة علمية.
فقد نجح مثلا الرحالة ناصر خُسْرَوْ في الحصول على إعفاء من رسم العبور من والي جدة، وفي ذلك يقول في كتاب رحلته ‘سَفَرْ نامَه‘: “وقد ذهبت إلى أمير جدة فأكرم وفادتي وأعفاني مما كان يجب عليّ من المَكْس (= الرسوم الضريبية) ولم يطلبه، وهكذا خرجت من البوابة في سلام، وقد كتب إلى مكة يقول عني: هذا رجل عالم فلا يجوز أن يُؤخذ منه” أي رسم. ومعنى ذلك أنه حصل -بتعبيرنا الحاضر- على إعفاء جمركي كامل وإيصال بالإعفاء!
ويبدو أن ظروف الصراع مع الصليبيين والعلاقة غير الودية مع سلاطين الدولة الموحدية بمنطقة الغرب الإسلامي والأندلس قد دفعت الدولة الأيوبية إلى تشديد إجراءات العبور البحري في موانئ الإسكندرية بمصر، فكانوا يقومون بالاستفسار عن أسماء الأشخاص وأنواع السلع والمراكب، ثم تُكتب “أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم، وسُئل كل واحد عما لديه من سلع أو ناضّ (= نقود الدنانير والدراهم) ليؤدي زكاة ذلك كله”؛ وفقا لابن جبير.
ويضيف هذا الرحالة أن السلطان صلاح الدين ألغى عددا كبيرا من أنواع الرسوم الجائرة “فإنه رفع ضرائب المكوس عن الحاج، وجعل عوض ذلك مالا وطعاما يأمر بتوصيلهما إلى… أمير مكة”. وقد قدّر الإمام المؤرخ ابن أيْبَك الصفدي الشافعي (ت 764هـ/1362م) -في ‘الوافي بالوفيات‘- ما ألغاه صلاح الدين من ذلك؛ فقال إن “مَكْس البضائع والقوافل وعمالتها: تسعة آلاف وثلثمئة وخمسون دينارا (9350 دينارا = اليوم 1.9 مليون دولار أميركي تقريبا)”.
وتشمل تلك الإجراءات جمع البضائع لفحصها وتفتيشها في أماكن معينة كما يحدث اليوم في نقاط التفتيش الجمركي. ولكن ظاهرة ضياع الأمتعة أو تعرُّضها للسرقة كانت مألوفة أيضا، ناهيك عن أنه خلال تفتيش البضائع والمقتنيات الشخصية قد يَتلف “كثير من أسباب (= ممتلكات) الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر الزحام”، ثم يطلقون “بعد موقف من الذل والخزي عظيم” من جراء الأسلوب القاسي المتبع في معاملة المسافرين.
كما يلاحظ ابن جبير تراتبية مرور المسافر على الموظفين الأمنيين والإداريين؛ فكان يمر أولا بالمسؤول الإداري الأعلى في الميناء، ثم يُذهب به إلى القاضي المكلف بالإجراءات القانونية المتعلقة بالزكاة وغيرها، ثم يصار به إلى “أهل الديوان” الذين هم موظفو الإدارة الجمركية لاستيفاء رسوم العبور.
وكان يتم تقييد إفادات المسافر بشأن المعطيات الكاملة لرحلته: محطة الانطلاق، ووجهة الوصول، وتفاصيل محتويات الأمتعة التي معه، وفي كلّ محطة تفتيش “يُستفهَم (= يُستجوَب) ثم يقيَّد قوله” قبل أن يخلى سبيله؛ بل إن المسافرين ربما “أدخِلت الأيدي إلى أوساطهم بحثا عما عسى أن يكون [مخفيا] فيها، ثم استُحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وَجدوا لهم أم لا؟”!!
وقد لاحظ ابن بطوطة أن الحواجز الجمركية في معبر قَطْيا/قطية بين مصر والشام كانت لها وظائف تفتيشية أمنية ومالية معا في أيام الدولة المملوكية، ويصف هذا المعبر قائلا إنه كان يضم جهازا إداريا متكامل من ديوان وكَتَبة وشهود، وفيه كانت “تُؤخذ الزكاة من التجار، وتُفتش أمتعتهم، ويُبحث عما لديهم أشدَّ البحث”!
وربما أدت الخشية من تخفي الجواسيس في أزياء التجار المسافرين -وهو أمر تشيع قصصه في كتب التاريخ وغيرها- إلى فرض بعض الدول إجراءات أمنية تحد من تلك المخاطر الأمنية، كان في طليعتها أحيانا ما يمكن تشبيهه بفكرة “جواز السفر/المرور” أو “التأشيرة”.
ومن العجيب أن يطالعنا في هذا الصدد أثر يُروَى عن النبي ﷺ أخرجه عدد من أئمة الحديث في مصنفاتهم، وفي مقدمتهم الإمامُ المحدّث سليمان بن أحمد الطَّبَراني (ت 360هـ/971م) الذي أورده في كتابيْه ‘المعجم الكبير‘ والمعجم الأوسط‘، ونصه: “عن سلمان الفارسي (ت 33هـ/655م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل أحدٌ الجنةَ إلا بِجَوَازِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، أَدْخِلُوهُ جَنَّةً عَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ»”!!
ورغم حكم علماء الحديث على هذا الأثر ببطلان صحة نسبته إلى النبي ﷺ؛ فإن ما يهمنا هنا هو الحضور الذهني وربما العملي لفكرة “جواز المرور” في تلك العصور المتقدمة! وقريب من ذلك الأثر في الغرابة والدلالة ما نسبه الإمام المحدِّث ابن كثير -في تفسيره- إلى بعض كبار أئمة التابعين في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾؛ (سورة النبأ/الآية: 21)، فقد قالوا فيها: “يعني: أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه «جواز» نجا وإلا احتُبس” في جهنم!!

جوازات وتفتيش
وعلى كل حال؛ فإننا نجد تطبيقات تاريخية عديدة لتلك الفكرة في أقاليم الإسلام المختلفة شرقا ومغربا؛ ومن تلك التطبيقات المبكرة ما ذكره الإمام الطبري -في تاريخه- من أن القائد الأموي قُتيبة بن مسلم الباهِلي (ت 96هـ/716م) توجه سنة وفاته إلى الصين لفتحها “فلما عبر النهر (= نهر سَيْحُون) استعمل رجلا من مواليه -يقال له الخوارزمي- على مقطع النهر، وقال: لا يجوزنَّ أحد إلا بجواز” يُسمح له فيه بالعبور!
ويروي القاضي التنوخي -في ‘نشوار المحاضرة‘- أن الخليفة العباسي المعتضد بالله (ت 289هـ/902م) رفعت إليه أجهزة الاستخبارات في دولته تقريرا يفيد بأن أحد رجال أعدائه من الديلم دخل إلى حدود أراضيه، فكتب إلى رجال الإدارة والأمن في تلك المنطقة يأمرهم بأن “لا يدخل البلدَ مستأنَفا (= مستقبلا) أحدٌ ولا يخرج إلا بجواز، حتى لا تتم حيلة لأحد من الديلم في الدخول سرًّا”!
ويحكي معاصره الرحالة المقدسي البشاري (ت نحو 380هـ/991م) -في كتابه ‘أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم’- أن إقليم فارس “مُنِع الخارج منه إلا بجواز، وحُبس الداخل والمجتاز”!!
وبعدهما بثلاثة قرون؛ نجد تطبيقا لنظام الجواز والإقامة بكفالة ولكن هذه المرة في منطقة الغرب الإسلامى، وتحديدا في إمارة صغيرة كانت في مدينة سبتة المغربية وأنحائها؛ فقد ترجم الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- لأميرها العالم أبي القاسم محمد بن أحمد اللخْمي العَزَفي (ت نحو 680هـ/1281م) فوصفه بأنه “لم يؤدِّ طاعة لأحد من ملوك المغرب، وساس بلده أحسن سياسة بحيث لم… يدخل سبتة غريب إلا بضامن، ولا يخرج إلا بإذن”!!
ويحدثنا ابن بطوطة أن معبر قطية/قَطْيا بين مصر والشام لم يمكن يُسمح للتجار بالعبور منه إلى مصر أو إلى الشام إلا “ببراءة” أي تأشيرة/جواز من بلد المغادرة، وذلك حرصا “على أموال الناس وتوقيا من جواسيس العراقيين”، والمقصود بذلك جواسيس أعداء المماليك من ملوك المغول.
واشتهرت الهند الإسلامية بأنها كانت دقيقة في إجراءات تفتيش المسافرين إليها عند معابر حدودها؛ فابن بطوطة يصف خدمات البريد الهندي وترتيباته الدقيقة وسرعة توصيله الفائقة، ويذكر -مما هو متعلق بموضوعنا- أنه كان للسلطة عناية تامة بمن يدخل البلاد، ولها جواسيس مكلَّفون برصد حركة المسافرين والتبليغ عنهم وتسجيل كل المعطيات المتعلقة بهم، ولذلك فإنه “إذا كَتَبَ المخبرون إلى السلطان بخبر مَنْ يصل إلى بلاده استوعبوا الكتابَ (= التفاصيل) وأمعنوا في ذلك، وعرّفوه أنه ورد رجل صورته كذا، ولباسه كذا، وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدّامه ودوابّه، وترتيب حاله في حركته وسكونه، وجميع تصرفاته لا يغادرون من ذلك كلّه شيئا”!!
ويبدو أن هذا النظام الأمني الصارم الذي كان متبعا في الهند إنما هو انعكاس لنظيره الذي كان مطبقا في الصين منذ قديم الزمان، ولاحظه الرحالة المسلم حسن بن يزيد السيرافي -الذي سبق ذكره- وسجله ضمن مشاهداته في جولاته داخل المدن الصينية، ثم رصده ابن بطوطة بعده بنحو خمسة قرون.
فقد لاحظ التاجر السيرافي أنه في الصين “من أراد سَفَراً… أخذ كتابيْن من المَلِك ومن «الخصىّ» (= موظف الضرائب/الجمارك)؛ أما كتابُ المَلك فللطريق [ويختص] باسم الرجل واسم من معه، وكم عمره وعمر من معه، ومن أي قبيلة هو، وجميع من ببلاد الصين من أهلها ومن العرب وغيرهم لا بد لهم أن ينتموا إلى شيء يُعرفون به. وأما كتاب «الخصىّ» فبالمال وما معه من المتاع، وذلك لأنّ في طريقهم مسالح (= نقاط تفتيش أمنية) ينظرون في الكتابين، فإذا ورد عليهم الوارد كتبوا: ورد علينا فلان بن فلان الفلاني، في يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا، ومعه كذا، لئلا يذهب من مال الرجل ولا من متاعه شيء ضياعا، فمتى ما ذهب منه شيء أو مات، عُلم كيف ذهب ورُدّ عليه أو على ورثته من بعده”!
أما ابن بطوطة فقد خضع شخصيا لتلك الإجراءات الأمنية الصينية المشددة التي تشبه اليوم نظام تصوير المسافرين في المطارات والمنافذ الحدودية، وخلّد لنا تجربته معها قائلا: “وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات…، وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا مِن سواهم، فإن لهم فيه اقتدارا عظيما. ومن عجيب ما شاهدتُ لهم من ذلك أني ما دخلتُ قَطّ مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق!!
ولقد دخلتُ إلى مدينة السلطان فمررت على سوق النّقاشين، ووصلتُ إلى قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زيّ العراقيين، فلما عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط، فجعل كل واحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئا من شبهه! وذُكر لي أن السلطان أمرهم بذلك وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا ينظرون إلينا ويصورون صورنا، ونحن لم نشعر بذلك! وتلك عادة لهم في تصوير كل من يمر بهم، وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعثوا صورته إلى البلاد، وبُحِث عنه فحيثما وُجد شبه تلك الصورة أخِذ”!!
وعن خرائط شبكة طرق حركة الناس وموظفي مؤسسة البريد؛ يرسم الجغرافي ابن خُرْداذِبَهْ خرائط هذه الشبكة الطرقية في دولة الخلافة العباسية في عصره، والتي كانت تمتد على طول 7000كم تقريبا من خط الحدود الأفغانية الطاجيكية الحالية وحتى خط الحدود الجزائرية المغربية اليوم، فيعدّد طرق البريد الكبرى المعبَّدة في هذه الجغرافيا المترامية الأطراف ذاكرا أن “سكك البريد في المملكة: تسعمئة وثلاثون سكّة”.
و«السكة» هي الطريق الرئيسية المعبَّدة لأن “السِّكَّة: الطَّرِيقُ الْمُسْتَوِي، وَبِهِ سُمِّيَتْ سِكَكُ البَرِيدِ”؛ كما يقول الإمام ابن منظور (ت 711هـ/1311م) في ‘لسان العرب‘. ويزيدنا ياقوت الحموي في تعريفها قائلا: “أما «السكة»: فهي الطريق المسكوكة التي تمرّ فيها القوافل من بلد إلى آخر؛ فإذا قيل في الكتب: «من بلد كذا إلى بلد كذا: كذا سكّةً»، فإنما يَعْنُون: الطريقَ”.
كما يقدّم ابن خُرْداذِبَهْ خريطة أولية لشبكات هذه الطرق في جميع الاتجاهات انطلاقا من بغداد عاصمة الخلافة حينها، ويحدد المحطات الرئيسية على هذه الشبكات الطرقية موضحا أن متوسط المسافات فيما بين تلك المحطات لا يزيد على ثمانية فراسخ. ويذكر الحموي -في ‘معجم البلدان‘- أنه كان ما “بين مَرْو… إلى بلخ مئة واثنان وعشرون فرسخا، واثنان وعشرون منزلا (= محطة)”. أي أنه كان بين كل محطة والتي تليها مسافة نحو 30كم تقريبا.
وتفيد المعطيات التي زودنا بها هذان المصدران أنه كان في كل 30-40كم توجد محطة يمكن للمسافرين الاستراحة فيها، وهو معدل قريب مما تقضي به -في المتوسط- المعايير المعاصرة في المسافات بين محطات خدمات الطرق في العديد من الدول، وهو 20-50كم بين كل محطتين.
ولكن يبدو أن كثرة المحطات وقلّتها مما يتغير حسب العصور وازدهارها؛ فالحموي يذكر -في ‘معجم البلدان‘- أنه كان ما “بين مَرْو… إلى بلخ مئة واثنان وعشرون فرسخا، واثنان وعشرون منزلا (= محطة)”. أي أنه كان بين كل محطة والتي تليها مسافة نحو 30كم.
وقد أورد لنا الأديب العراقي السويدي -في رحلته- أسماء جميع محطات الطريق التي سلكها إلى الحج، بدءا من بغداد ومرورا بالموصل ثم حلب ودمشق (55 محطة من بغداد إلى دمشق)، ثم المدينة النبوية (30 محطة من دمشق إلى المدينة)، وانتهاء بمكة المكرمة (14 محطة من المدينة إلى مكة)؛ فكانت تتضمن نحو 80 مرحلة وتمر بنحو مئة محطة ما بين مدينة وبلدة وقرية وحصن.
كما يرسم الرحالة الجغرافي الإصطخري -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- خريطة مماثلة لحركة السفر في العالم الإسلامي في عصره، محددا مسافاتها بالفراسخ أو بالمراحل والأيام؛ فيقول مثلا مبينا مسافات بلاد الشام طولا وعرضا: “أمّا المسافات بالشام فإن طولها من مَلَطْية (= تقع اليوم جنوبي تركيا) إلى رفح… 25 مرحلة (= 1150 كيلومترا تقريبا)…، وعرضها في بعض المواضع أكثر من بعض”، مبينا أن عرض بلاد الشام يتراوح بين 6-10 مراحل. وبما أن مقدار “المرحلة” يدور بين 35-50كم يوميا؛ فهذا يعني أن الدواب كانت تسير 46-50 كيلومترا في اليوم الواحد، وقد تزيد أو تنقص حسب احتياجات القوافل إلى التوقف للراحة والصلوات والتزود وما شابه ذلك.
وأما المعايير الخدمية والأمنية التي كانت تخضع لها إقامة محطات الطريق تلك؛ فتُجْمِلُها لنا ‘دائرة المعارف الإسلامية‘ الاستشراقية -الصادرة عن مؤسسة «بريل» الهولندية- بقولها: “وعند تشييد المنازل على الطرق يؤخَذ في الاعتبار: تضاريس وفواصل المسافة بين المنازل، ووجود مورد ماء كنبع أو بئر أو بِرْكة، ووجود الكلأ (مرعى) للأنعام، ووجود مكان يعسكر فيه الرجال …، وكان يُراعَى في المنزل أن يكون في موضع آمن” من عصابات اللصوص.
ثم تضيف ملخصة تطور هذه المحطات عبر القرون وتعاقب الدول: “وفي العصر المملوكي كان هناك مكان للمأوى يقال له «منزلة» عند كل «منزل» من منازل شبكة بريد…، وفى نهاية العصر المملوكي -عند مراحل معيّنة- كانت هناك قوافل مزوَّدة بمطابخ وملحقات بيطرية لإقامة الكتائب الحربية…؛ وفى نهاية العصر العثماني كان هناك نوعان من المضافات هما: المضافة وكانت عامة، والمنزل وكان خاصا. ففي الأولى يقدم المأوى والمأكل للمسافرين على نفقة الأعيان (= وجهاء المجتمع) بالتناوب، وفي الثاني يقدِّم أصحابُها استضافةً متشابهة في بيوت، ويستخدمها المسافرون باستمرار نظير أجور مخفضة”.
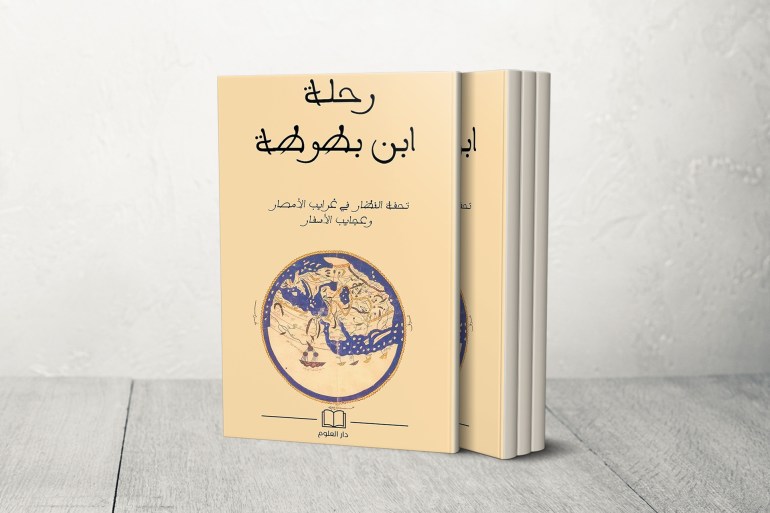
تكافل وضيافة
كانت الأسفار -كظاهرة بشرية- وما تشهده من علاقات إنسانية، وما يحفّها من صعوبات ومكاره، مجالا رحبا لتشكُّل منظومة واسعة من القيم والآداب النابعة من شتى روافد الثقافة الإسلامية والتقاليد المجتمعية، وهو ما حفلت به كتب الأدب شعرا ونثرا وأمثالا عربية وغيرها، بيانا لمناقب السفر أو كشفا لمثالبه.
ولعل أقدم ما قيل في ذلك ما يُنسب إلى الإمام الشافعي (ت 204هـ/819م) ملخِّصا أهم فوائد السفر ومنغصاته؛ فقد روى المؤرخ اليمني بهاء الدين الجَنَدي -في ‘السلوك في طبقات العلماء والملوك‘- أن الشافعي كان “كثير الذِّكر للسَّفر فعوتب في ذلك، فقال لمعاتبه:
تغرّبْ عن الأوطان في طلب العُلا * وسافرْ ففي الأسفار خمسُ فوائد:ِ
تفرُّجُ هَمٍّ، واكتسابُ معيشةٍ، * وعِلْمٌ، وآدابٌ، وصُحبةُ ماجدِ
فإن قِيلَ: في الْأَسْفَار: قُلٌّ، وغُربةٌ، * وقَطعُ فيافٍ، وارتكابُ شدائدِ
فمَوتُ الفتى خيرٌ له من مُقَامه * بدارِ هَوَانٍ بين واشٍ وحاسدِ”!!
ومما يورده مؤرخ الأدب أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ/1039م) -في كتابه ‘اللطائف والظرائف‘- من مأثورات في مدح السفر وفوائده؛ قولُ: “أحد الحكماء: السفر أحد أسباب المعاش التي بها قوامُه ونظامه، لأن الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرض بل فرّقها وأحْوَجَ بعضَها إلى بعض، ومِن فضله أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يَزيده علما، ويُفيده فهما بقدرة الله وحكمته، ويدعوه إلى شكر نعمته، ويُسمِع العجائب ويُكسٍب التجارب، ويَفتح المذاهب ويَجلب المكاسب، ويَشُدّ الأبدان ويُنشّط الكسلان ويُسلي الأحزان، ويَطرد الأسقام ويُشهِّي الطعام، ويَحط سَوْرةَ (= شدة) الكِبْر، ويَبعث على طلب الذِّكر”!
ويسرد الراغب الأصفهاني (ت 502هـ/1108م) -في ‘محاضرات الأدباء‘- طائفة من المقولات والحِكَم المتداولة في أدب السفر؛ فكان منها: “قيل: لا تَحمدنّ امْرَأً حتّى تجربه في معاملة أو سفر. وقيل: السفر ميزان القوم، وقيل: سُمّي السفرُ سَفَرًا لأنه يُسْفر عن الأخلاق المحمودة والمذمومة” في الأشخاص المسافرين. وروى أبو بكر ابن المَرْزُبَان المُحَوَّلي (ت 309هـ/921م) -في كتابه ‘المروءة‘- عن الإمام التابعي ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي (ت 136هـ/754م) أنه “قال: المُرُوءَة سِتّ خِصَال: ثَلَاث فِي الْحَضَر، وَثَلَاث فِي السّفر…؛ فأما الَّتِي فِي السّفر: فبذل الزَّاد، وَحسن الْخلق، ومداعبة الرفيق”.
وانعكاسا لأريحية إنسانية في السفر كثيرا ما نفتقدها في مجتمعاتنا اليوم؛ فإن الإحسان إلى المسافرين والعناية بهم كان خُلُقا شائعا بين الناس امتدادا للثقافة العربية القاضية بالشِّرْكة في الزاد بين أصحاب الرفقة الواحدة، حتى إنهم أطلقوا على من يفعل ذلك لقبا خاصا به هو “«زاد الراكب»؛ لأنَّ رفيقه لا يحتاج معه في السفر إلى زاد. وأزواد الراكب من قريش ثلاثة” رجال في الجاهلية؛ طبقا للإمام سبط ابن الجوزي في ‘مرآة الزمان‘.
وقد زاد الإسلام ذلك الخلق الكريم رسوخا بحضه الشديد على إكرام “ابن السبيل” من المسافرين الغرباء، حتى إنه جعل له سهما ثابتا في مصارف الزكاة -التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام- تحت بند «ابن السبيل»؛ فقد قال العلماء إن “«ابن السبيل» هو المسافر المُنْقطَع به (= المحتاج في سفره)، يأخذ من الصدقة (= الزكاة) وإن كان له مال في بلده”؛ وفقا للإمام أبي بكر الجَصّاص الحنفي (ت 371هـ/982م) في كتابه ‘أحكام القرآن‘. ويروي الإمام الطبري في تفسيره قوله تعالى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾؛ (سورة النساء/الآية: 36) [النساء:36]) أن المقصود به “الرفيقُ في السفرِ: منزلُه منزلُك، وطعامُه طعامُك، ومسيرُه مسيرُك”.
وتطبيقا لتلك التعاليم؛ تفنن المسلمون -بمختلف الأمصار والأعصار- في أساليب العناية بالمسافرين ورعايتهم حتى يبلغوا مأمنهم ويحققوا غاياتهم من سفرهم، حتى إنه “كان كثيرٌ من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك”؛ طبقا للإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي الدمشقي (ت 795هـ/1393م) في كتابه ‘لطائف المعارف‘.
ومن النماذج التي أوردها المؤرخون لذلك ما سبقت حكايته عن كفالة عُبيد الله بن العباس بن عبد المطّلب لكل من يسافر معه في قافلته، وأيضا ما ذكره ابن رجب الحنبلي -في كتابه المذكور- من أنه “كان إبراهيم بن أدهم (ت 162هـ/780م) يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان”.
كما يذكر المؤرخ النسّابة البَلاذُري أن الإمام التابعي عامر بن عبد قيس التميمي (ت نحو 60هـ/680م) اشتهر ببالغ خدمته لرفاقه في السفر، وأنه “كان إذا فَصَلَ (= خرج) غازيا توخَّى (= تخيَّر) الرفاقَ، فإذا وافقته رفقة قال: يا هؤلاء إني أريد صحبتكم على أن أكون لكم خادما لا ينازعني أحد منكم الخدمة، وأكون مؤذنا لا ينازعني الأذانَ أحدٌ، وأنفِق فيكم بقدر طاقتي، فإن نازعه أحد في شيء من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم”!
وقد وصف لنا ابن بطوطة -الذي يعد نموذجا مثاليا للمسافر المتمتع بتلك الرعاية خلال رحلاته طوال ربع قرن- جانبا من تلك الرعاية في أكثر من إقليم إسلامي، ومن ذلك ما ذكره عن مشاهداته في منطقة تركيا الحالية قائلا: “متى نزلنا بهذه البلاد زاوية [صوفية] أو دارا يتفقّد أحوالَنا جيرانُنا من الرجال والنساء…، فإذا سافرنا عنهم ودّعونا كأنهم أقاربنا وأهلنا، وترى النساء باكيات لفراقنا متأسفات”!!
ويضيف أن من “عادتهم بتلك البلاد أن يخبزوا الخبز في يوم واحد من الجمعة (= الأسبوع) يعدّون فيه ما يقوتهم سائرها، فكان رجالهم يأتون إلينا بالخبز الحارّ في يوم خَبْزه ومعه الإدام الطيّب إطرافا (= إتحافا) لنا بذلك، ويقولون لنا: إنّ النساء بعثن هذا إليكم وهنّ يطلبن منكم الدعاء”!
ويشير هذا الرحالة إلى ظاهرة “الفتيان الآخية” الأتراك الذين اشتُقّ اسمهم هذا من مناداة بعضهم بعضا بلفظ “أخي/آخي”، وهم جماعات مكونة من الصناع الحِرفيين والشباب العزاب. ويصف ابن بطوطة دورهم الاجتماعي في رعاية الغرباء وعابري السبيل، حيث ينزل عندهم المسافر ويتكفلون تطوعا بكل احتياجاته من طعام وشراب ومسكن ونظافة، بل إنهم يبحثون عن الغرباء من المسافرين ويتنافسون في استضافتهم إلى درجة التنازع بينهم على ضيافتهم، وقد ذكر ابن بطوطة في ذلك قصة طريفة جرت له ولرفقائه؛ فقال:
“وعند دخولنا لهذه المدينة (= كوتاهية غربي تركيا) مررنا بسوق لها فنزل إلينا رجال من حوانيتهم وأخذوا بأعنّة خيلنا، ونازعهم في ذلك رجال آخرون، وطال بينهم النزاع حتى سَلَّ بعضهم السكاكين، ونحن لا نعلم ما يقولون، فخفنا منهم وظننا أنهم… يريدون نهبنا، ثم بعث الله لنا رجلا حاجا يعرف اللسان العربي فسألته عن مرادهم منا، فقال: إنهم من «الفتيان»، وإن الذين سبقوا إلينا أولاً هم أصحاب «الفتى أخي سنان» والآخرون أصحاب «الفتى أخي طومان»، وكل طائفة ترغب أن يكون نزولكم عندهم، فعجبنا من كرم نفوسهم، ثم وقع بينهم الصلح على المقارعة فمن كانت قرعته نزلنا عنده أولا، فوقعت قرعة «أخي سنان»، وبلغه ذلك فأتى إلينا في جماعة من أصحابه فسلّموا علينا ونزلنا بزاوية له، وأتى بأنواع الطعام ثم ذهب بنا إلى الحمام…، ثم خرجنا من الحمام فأتوا بطعام عظيم وحلواء وفاكهة كثيرة”!!
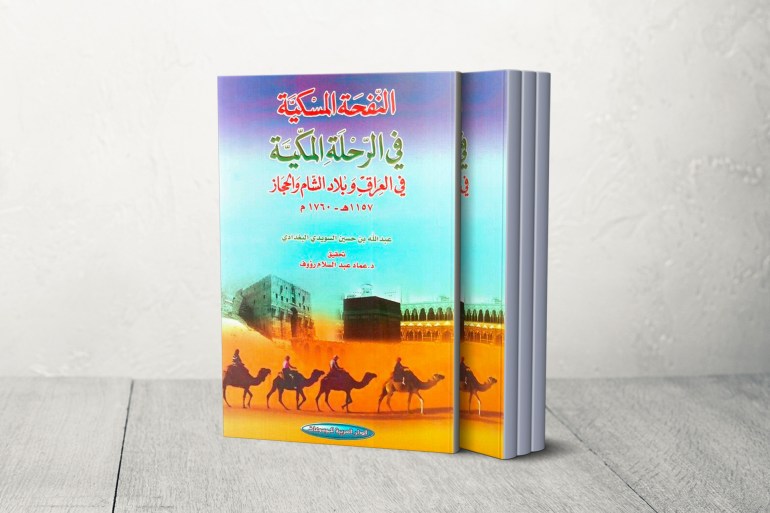
علوم ومعارف
بقدر ما كان العالم الإسلامي متصلا بالمئات من شبكات الطرق العابرة لأقطاره وأمصاره؛ كان أيضا متواصلا بسلاسل الرحالين في طلب العلوم والآداب والمعارف، فقد كانت “الرحلة في طلب العلم” قيمة كبرى في الحياة العلمية الإسلامية، وبالتالي كانت غرضا رئيسيا للسفر طوال القرون المتعاقبة.
كما كانت تجارة الكتب من أهم محمولات القوافل في تسيارها أينما اتجهت وحلت، حتى كان مما يوصف به انتشار كتاب ما وذيوع صبته أن يقال فيه إنه “سار في الآفاق، وبلغ مبلغ الرّفاق (= القوافل)”؛ على نحو ما وُصف به أحد هذه المصنفات في كتاب ‘إنْباه الرُّواة على أنْباه النُّحاة‘ للمؤرخ الوزير جمال الدين القِفْطِي (ت 646هـ/1248م).
وبالمثل كانت رحلات العلماء وتنقلات الأدباء من إقليم إلى آخر -على رقعة الجغرافيا الإسلامية الفسيحة- متواصلة بتواصل شغفهم المعرفي وألقهم الأدبي، حتى شاع الثناء العطر تقديرا لأصحاب هذه الرحلات والتنقلات، مثلما قيل في أحدهم عندما نُعٍتَ بأنه “طاف الآفاق، ورافق الرفاق (= القوافل)، ولقي الفضلاء، وروى لهم وعنهم”؛ وفقا للقِفْطِي.
لقد توثقت علاقة العلماء بالأسفار وامتزجت حياتهم العلمية فيها بالكثير من الملامح اللافتة، والمواقف الطريفة، بل والوقائع المؤسفة؛ فمن ذلك الملامح اللافتة فيها ذلك الشغف المعرفي الذي ارتبط بقوافل السفر، سواء منه ما كان يدفع طلاب العلم إلى الرحلة الواسعة في طلبه بين الأقاليم الإسلامية، كما مثلنا له في مطلع هذه المقالة بشرف الدين المرسي؛ أو كما وصفه لنا الرحالة ابن بطوطة بقوله: “وكان في القافلة التي وصلنا فيها جماعة من الناس أتوْا برسم (= لغاية) تجويد القرآن على من بها (= مدينة واسط العراقية) من الشيوخ”.
ومن أفضال القوافل على طلاب العلوم ما كانت تهديه إليهم من مزايا اللقاء بشيوخ العلم حين يقدمون فيها إلى المدن لأي سبب كان، أو حتى حين تضمهم قافلة واحدة في سفر مشترك؛ فمثلا كان الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ/1015م) شديد الحرص على اللقاء العلمي مع معاصره الإمام أبي مسلم عبد الرحمن ابن مِهْرَان (ت 375هـ/986م)، فكان لذلك بالغ التنقيب عنه في القوافل السيارة، حتى قال في ذلك: “دخلتُ مَرْو وما وراء النهر فلم نلتق، ولم أكن رأيته. وفي سنة خمس وستين (365هـ/977م) -في الموسم- طَلَبْتُه في القوافل فأخفى شخصَه، فحججتُ سنة سبع وستين وعندي أنه بمكة، فقالوا: هو ببغداد! فاستوحشتُ من ذلك، وتطلَّبْتُه فلم أظفر به”، ثم إنهما التقيا -في آخر الأمر- بلا ميعاد ببغداد؛ وفقا للذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.
ومن الوقائع المعبرة بقوة عن ذلك الشغف المعرفي ما يحدثنا به الخطيب البغدادي -في ‘تاريخ بغداد‘- من وحي تجاربه الشخصية ذات الارتباط بحياة السفر والقوافل؛ فيقول -في ترجمة شيخه إسماعيل بن أحمد الضرير الحِيري النيسابوري (ت 430هـ/1040م)- إنه قرأ عليه «صحيح البخاري» كاملا في ثلاثة مجالس فقط، ولم يكن الدافع وراء هذه “القراءة الماراثونية” سوى أن شيخه جاء إلى بغداد في قافلة توشك أن تغادرها في أي وقت حاملة معها هذا الإمام ومعه إسناده العالي والنادر لهذا الكتاب العظيم!
ولْنَدَعْ الخطيبَ يقصّ علينا كيف جرى هذا الإنجاز القياسي النادر: “ولما ورد (= الحِيري النيسابوري) بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازما على المجاورة بمكة، وكانت وِقْر (= حِمْل) بعير، وفي جملتها «صحيح البخاري»، وكان سمعه من أبي الهيثم الكُشْمِيهَني (= محمد بن المكي الكُشْمِيهَني المَرْوَزيّ المتوفى 389هـ/1000م)، عن الفِرَبْرِيِّ (= محمد بن يوسف الفِرَبْرِيِّ المتوفى 320هـ/922م)، فلم يقض لقافلة الحجيج النفوذ (= العبور إلى مكة) في تلك السنة لفساد الطريق، ورجع الناس فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور، ولما كان قبل خروجه بأيام، خاطبته في قراءة كتاب «الصحيح» فأجابني إلى ذلك، فقرأت جميعَه عليه في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين، كنت أبتدأ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر، وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عَبَر الشيخ [نهرَ دجلة] إلى الجانب الشرقي (= من بغداد) مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغتُ من الكتاب، ورحل الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة”!!
وكثيرا ما كانت أيام السفر ولياليه فرصة للنشاط العلمي والأدبي مدارسة ومناقشة وأسمارا أدبية ماتعة؛ فالمؤرخ أبو بكر المالكي القيرواني (ت 453هـ/1062م) يقصّ علينا -في كتابه ‘رياض النفوس‘- حكاية عن الإمام سُحنون بن سعيد التَّنُوخي المالكي (ت 240هـ/855م) أنه خرج من مصر في قافلة إلى الحج، وكان معه فيها ثلاثة من تلامذة الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ/795م) أحدهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم العُتَقي (ت 191هـ/807م)؛ فكان مما حدث به سحنون عن نشاطهم العلمي في رحلتهم تلك قولُه: “فكنت إذا نزلت ذهبت إلى ابن القاسم أسائله [قراءةً] من الكتب، وأقرأ عليه إلى قرب وقت الرحيل…، وكنا نمشي بالنهار ونُلقي المسائل ونحن مشاة، فإذا كان الليل -ونزلتْ الرفقة- قام كل واحد إلى حزبه من الصلاة”!!
ولم تكن مجالس السفر العلمية تلك حكرا على العلماء، وإنما كانت موردا مفتوحا لعامة المسافرين ينهلون فيها من العلم استفتاء وإفتاء؛ ويسجل لنا العلامة العراقي السويدي مشهدا من ذلك بقوله في كتاب رحلته: “ومن فضل الله أن خيمتي، وكذا في الطريق شق المحْمل، محيطة بهما الناس لكثرة ما يسألوني من أحكام الإحرام -حتى أهل الشام- مع كثرة الفقهاء في الركب”.
ويخبرنا الإمام أبو سعد السمعاني عن مطارحاته الأدبية في سفر له مع الأديب الصوّافي المُنادي الذي مر بنا ذكره من قبل؛ فيقول عن مرافقته له في إحدى القوافل التي كان يصحبها للمتاجرة مع أصحابها: “وكان يحضر عندي في منازل البادية وينشدني الأشعار المليحة من حفظه، وكان يحفظ منها شيئا كثيرا، كتبت عنه من الأشعار بالكوفة ووادي العروس وفَيْد”!!

فواجع علمائية
ويروي المؤرخ الأديب ابن أيبك الصفدي عن أحد الأئمة الكبار قوله عن أبي الفضل هبة الله بن عبد الرحمن الشيرازي (ت 640هـ/1242م): “اصطحبنا في القافلة من نيسابور إلى بغداد (= مسافة 1400كم تقريبا)، وكنتُ أكتب عنه من شعره وشعر غيره في المنازل (= محطات الطريق)، وكان شابا كيسا حسن الأخلاق ظريفا”!
بل إن مصاعب الطريق لم تكن تحول بين العلماء والمطالعة والكتابة والنسخ والتأليف أثناء أسفارهم، حتى وهم مستقرون على ظهور الإبل؛ فالإمام شمس الدين السَّخاوي (ت 902هـ/1497م) يقول -في كتابه ‘الجواهر والدرر‘- عن شيخه الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) ما نصه: “ومن الغريب أنه انتقى «فهرست» الحافظ السِّلَفي (= أبو طاهر السِّلَفي المتوفى 576هـ/1180م) وهو متوجِّةٌ إلى مكة حالَ ركوبه في المحارة (= محْمل الجمل) سائرًا؛ على ما رأيته بخطه! وكذا بلغني أنه كان يكتب وهو في الشُّقدف (= مَحْمِل حجازي) في رجوعه من اليمن إلى مكة”!!
وأما ارتباط القوافل بالمواقف الطريفة معرفيا؛ فمن أقدم نماذجه ما يرويه الخطيب البغدادي أيضا محدِّثا عن الإمام هُشَيْم بن بشير بن أبي خازم السُّلَمي الواسطي (ت 183هـ/799م) “كتب عن الزُّهْريّ (= الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى 124هـ/743م) نحوا من ثلاثمئة حديث فكانت في صحيفة، وإنما سَمِع منه بمكة، فكان يظن أن الصحيفة في المحْمل [في القافلة]، فجاءت الريح فرمت بالصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث” فقط! وقد ترتب على ضياع هذه الصحيفة في سفر لصاحبها تشكيك بعض المحدثين في كثير من مروياته عن الزهري!!
ومن تلك المواقف أيضا ما يحكيه ياقوت الحموي -في ‘معجم الأدباء‘- عن الحافظ المقرئ الأديب أبي العلاء الحسن بن أحمد ابن عَثْكَل الهمذاني (ت 569هـ/1173م) أنه قال: “لما حججتُ كنتُ أمشي في البادية راجلا قدّام القافلة أحيانا مع الدليل، وأحيانا أخلّف الدليل، حتى عرفني الدليل واستأنس بي ومال إليّ، وهو يسير على ناقة له تكاد تردّ الريح، وكنت أرى الدليل يتعجب من قوتي على السير، وكان أحيانا يضرب ناقته ويُمْعِن في السير! وكنت لا أخلّي الناقة تسبقني، فقال لي الدليل يوما: تَقْدِرُ أن تسابق ناقتي هذه؟ فقلت: نعم! فضربها وعدوتُ معها فسبقتها”!!
ومنها ما يذكره الحموي أيضا قائلا إن الأديب الشهير القاسم بن علي الحريري البصْريّ (ت 516هـ/1122م) -مؤلف «مقامات الحريري»- لم يسلم من تلك الطرائف المعلقة على محامل جمال القوافل؛ فقد نسبت إليها مقاماته الأدبية الرائعة عندما “اتهمه من يحسده بأن قال: ليست هذه (= المقامات) من عمله لأنها لا تناسب رسائله ولا تشاكل ألفاظه، وقالوا: هذا من صناعة رجل كان استضاف به ومات عنده فادعاها لنفسه، وقال آخرون: بل العرب (= أعراب البادية) أخذت بعض القوافل، وكان مما أخِذ جراب بعض المغاربة وباعه العرب بالبصرة، فاشتراه ابن الحريري وادّعاه”!!
وأما عن الوقائع المؤسفة للعلماء في حياة السفر؛ فمنها ما كان ينالهم مع رفاقهم في القافلة من منغصات السفر عموما، وخاصة أذى قطاع الطريق من سطْو ونهب بل وقتل، وما كان يدركهم في سفرهم من الأمراض أو حتى حوادث الوفاة الطبيعية.
ومن أفجع تلك الوقائع ما حصل للإمام أبي الليث أحمد بن عمر السمرقندي الحنفي (ت 552هـ/1157م) وكانت فيه خاتمة حياته؛ وذلك أنه لما أراد مغادرة بغداد “خرج الناس لوداعه… وخرج في قافلة؛ فلما ساروا قطع قوم الطريق على القافلة المذكورة وقتلوا منهم جماعة كبيرة من العلماء، فيهم صاحب الترجمة (= السمرقندي)، فقُتل الجميع شهداء”؛ وفقا للمؤرخ ابن تَغْري بَرْدي في ‘النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة’.
ولئن تعددت حوادث قتل العلماء في قوافل السفر على أيدي عصابات اللصوص؛ فقد كانت الحالة الغالبة هي نجاتهم بأنفسهم وإن لم يتمكنوا دائما من تفادي ضياع ما معهم من الكتب والمؤلفات في تلك الحوادث. ومن صور ذلك ما حكاه المؤرخ ابن العديم -في ‘بغية الطلب‘- عن واقعة حدثت لشيخه الإمام إسماعيل بن هبة الله ابن باطيش الموصلي الشافعي (ت 655هـ/1257م) سنة 622هـ/1225م؛ فقال إنه “أرسل إليه بلديُّه الأميرُ شمس الدين لؤلؤ الأميني (ت 648هـ/1250م)، وكان بينهما صحبة في الموصل…، فاستدعاه إلى حلب فخرج من الموصل متوجها إلى حلب، فخرج العرب (= أعراب البادية) على القافلة التي كان فيها فأخذوها فيما بين حَرّان ورأس عين، وأخذوا كتبه ومتاعه، وسلِم بنفسه”!!
ومن حوادث مرض العلماء في السفر ثم وفاتهم قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية؛ ما جاء في ‘كتاب الولاة‘ لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (ت 350هـ/961م) من أن محمد بن أحمد بن الحداد الكناني المصري (ت 344هـ/955م) خرج للحج، ثم إنه “لما رجع إلى مصر توعّك في الطريق، فاستمر في ضعفه إلى أن دخل من أبواب المدينة، فمات وهو سائر في المحْمل في الأرض التي بُنيت فيها القاهرة، فصُلِّي عليه في مصر ودُفن في القرافة”.
ويورد الإمام البِرْزالي -في تاريخه- أن المحدِّث المُسْنِد والتاجر العطار جمال الدين عبد الملك بن عبد الرحمن ابن صَدَقة الحَرّاني (ت 700هـ/1300م) “كان موته في المحارة بعد الرحيل من الصالحية [بدمشق] إلى العباسة [بالقاهرة] بالطريق، ووصل إلى العباسة ميتا، فأحضروه إلى الجامع -وكان يوم الجمعة- فصلى عليه الناس عقيب الصلاة، ودُفن هناك”.
ورغم كل تلك الفجائع؛ فقد كان وجود أحد العلماء في القافلة أحد أسباب نجاتها من جماعات قطع الطريق، والقصص في ذلك تكثر على نحو ما يحدثنا به الإمام المؤرخ أبو القاسم خلف ابن بَشْكُوَال الأندلسي (ت 578هـ/1182م) -في كتابه ‘الصلة في تاريخ أئمة الأندلس‘- من أن الإمام أصبغ بن الفَرَج الطائي القرطبي (ت 400هـ/1010م) “لما حَجَّ اعتَرَضَ القافلةَ لصوصُ العرب في أرض الحجاز، فناضل عن الرفقة ودافع عنها واحتمت به، ولم يرزأهم (= يخسروا) بسببه شيء”!!

أدب الرحلات
لم تقتصر المدونات الثقافية الإسلامية على ذكر ما كان يسود حياة السفر من تكافل المسافرين فيما بينهم، والخدمات التي كانوا يتلقونها من المجتمعات المسلمة أينما رحلوا وحلوا؛ بل إن كتب الشرع (من تفسير وحديث وفقه وآداب) قد أفردت أبوابا ومباحث خاصة ببيان الأحكام المتعلقة بحياة المسافرين أثناء ترحالهم من طهارة وصلاة وصيام، وعقود كراء الدواب والدليل والحراسة ونحوها، فبينت كل ذلك بالتفصيل مع مراعاة خصوصية وضع المسافر وما يحيط به من ظروف استثنائية وأحوال طارئة تستوجب التخفيف عنه والتسهيل عليه.
كما أن مصنفات البلدان والرحلات وثّقت لنا حياةَ هؤلاء المسافرين والمغامرات التي خاضها الرحالون المخاطرون بحُلْوها ومُرّها، وخلّدت لنا تجاربَ مصنفيها من الرحالين وما لاقوه فيها من متاعب ومصاعب، أو ما أقاموه خلالها من روابط وعلاقات وأفادوه من معارف ومشاهدات، ورسمت لنا أوضاع دول وحضارات وأحوال مجتمعات وثقافات في بقاع مختلفة وعصور متطاولة.
ومن أقدم ما وصلنا من مدونات أدب الرحلات التي تُعدّ بالعشرات في تراثنا: رحلة سلّام الترجمان (ت بعد 227هـ/842م) الذي يصفه ابن خُرْداذِبَهْ بأنه “كان يتكلّم بثلاثين لسانا” أي لغة!! ويخبرنا بأن ذلك هو ما أهّله وحده ليقوم برحلة جغرافية استكشافية رائدة، تمثلت مهمتها في محاولة التوصل إلى موقع سدّ يأجوج ومأجوج، وذلك بتكليف رسمي من الخليفة العباسي الواثق بالله (ت 232هـ/847م) الذي أرفق قائد الرحلة بـ”خمسين رجلا شبابا أقوياء”، وزودهم بـ”مئتي بغل لحمل الزاد والماء”!!
وفي مطلع القرن الرابع الهجري/الـ10م وتحديدا سنة 309هـ/921م؛ كانت رحلة الفقيه أحمد ابن فضلان إلى جنوبي روسيا اليوم، حيث زار تتارستان الحالية -التي كانت تدعى أيامَها “بلاد البلغار”- مُبتعثا إلى ملِكها المسلم على رأس وفد رسمي من الخليفة العباسي المقتدر بالله (ت 320هـ/922م).
وفي نهاية الثلث الأول من القرن نفسه؛ اكتمل تدوين «رحلة السيرافي» التي يرجع تاريخ جمعها إلى النصف الثاني من القرن الثالث/التاسع الميلادي، ويصف فيها رحالة يسمى سليمان التاجر (ت بعد 237هـ/851م) رحلته إلى الصين ممزوجةً بحكايات المغامرات البحرية التي سمعها من الربابنة العرب المسافرين بين البصرة والصين، وقد وصلتنا هذه الرحلة مدوّنة ومزيدة بقلم معاصرٍ لصاحبها اشتهر بأبي زيد السِّيرافي (ت بعد 330هـ/942م)، وقد مثّلت دليلا تجاريا حيويا للتاجر القديم خاصة وللمسافرين عامة.
وفي أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري/الـ11م؛ يطالعنا الرحالة الفارسي ناصر خُسْرَوْ برحلته الطويلة التي أودع تفاصيلَها كتابَه القيّم ‘سَفَرْ نامَه‘، وقد بدأ سَفَرَه فيها سنة 437هـ/1028م من مسقط رأسه مدينة بَلْخ -الواقعة اليوم بأفغانستان- متجها إلى مصر، ثم عاد إلى موطنه -مرورا بالحجاز والأحساء وجنوبي العراق- فوصل إليه سنة 444هـ/1053م.
وقد حدد لنا المسار العام لرحلته ذهابا وإيابا بقوله: “وتبلغ المسافة التي قطعناها من بلخ إلى مصر، ومن مصر إلى مكة، ومنها إلى فارس عن طريق البصرة، ثم إلى بلخ، عدا الأطراف التي زرناها في الطريق: ألفين ومئتين وعشرين فرسخا (= 11.1 ألف كم تقريبا)”!! وقد رسم خُسْرَوْ -في رحلته هذه- ملامح المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري في المنطقة العربية المركزية (العراق الشام ومصر والحجاز) خلال عصره الحافل بالتحولات الكبرى في تلك المنطقة.
ثم شهدت نهاية القرن السادس الهجري/الـ12م تطورا كبيرا في أدب الرحلات ممثلا في رحلة ابن جبير الغرناطي، الذي جال في ديار أقطار المشرق العربي خلال عصر بالغ الاضطراب صبغته الحروب الصليبية بأهوالها ومآسيها. وفي منتصف القرن الثامن الهجري/الـ14م؛ وصل هذا الأدب إلى قمة إحاطته وإثارته مع الفقيه الجوّال ابن بطوطة الطنجي “رحّال هذه المَلّة”؛ كما وصفه مدوّن رحلته الأديب الأندلسي محمد بن محمد ابن جزيّ الكلبي الغرناطي (ت 757هـ/1356م).
فقد استغرق تطواف هذا الرحالة المغربي 25 سنة، قطع خلالها -وفقا لمعطيات الموسوعة البريطانية الأميركية (Britannica)- ما مجموعه 120 ألف كيلومتر، موزعة على جميع القارات المعروفة في عصره، بما فيها أوروبا حيث كانت مدينة غرناطة إحدى أهم المحطات الختامية في تجواله العالمي، لكن رحلته الحافلة لم تكن هي الخاتمة لمدونات أدب الرحلة في ثقافتنا التراثية، بل تواصل تدبيجها في القرون اللاحقة حتى العصر الحديث.
أما على مستوى كتب الجغرافيا الطبيعية والبشرية التي ظلت دومًا بمثابة أدلة إرشادية للمسافرين؛ فقد ظهرت مبكرا فيما عُرف بمكتبة “المسالك والممالك” التي أنتجت لنا العديد من المصنفات بهذا العنوان، كان أقدم ما وصلنا منها كتاب ابن خُرْداذِبَهْ ثم معاصره الإصطخري، وكلا الكتابين مصمَّم لخدمة موظفي الدولة ومؤسسات البريد والاستخبارات وبيت المال، إضافة إلى رجال الأعمال ذوي التجارات العابرة للقارات.
أما كتاب «البلدان» لليعقوبي (ت 284هـ/897م) فهو أعم في مضمونه؛ إذْ يخاطب المسافر المعتاد على السفر لأسباب مختلفة، لكنه أيضا يهتم بموارد كل بلد وببضائعه. كما وضع الشريف الإدريسي كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الذي أودعه وصفا دقيقا للبلدان والأقاليم، ثم اقتفى أثره ياقوت الحموي بمصنفه القيم «معجم البلدان» الذي بلغ بفنّ البلدانيات قمته.
وقد اعتنى هذا اللون من التأليف -على تباين عصور مؤلفيه واختلاف مستويات تكوينهم العلمي وأدوارهم الوظيفية- ببيان شبكات الطرق (المسالك) بين المناطق المختلفة من العالم الإسلامي (الممالك)، وتحديد المسافات بين محطات الطرق والمراكز الحضرية، مع الإرشاد إلى ما في هذه الطرق من عقبات ومنغصات تقلق راحة المسافرين، وتوضيح الحدود بين الدول والأقاليم، والحديث عن خصائصها البيئية والبشرية والاقتصادية، والموارد المالية الخاصة بكل منها، كما تتطرق بشكل لافت إلى ما تعجّ به هذه الممالك من عادات وثقافات متعددة ومذاهب وتيارات فكرية متنوعة.