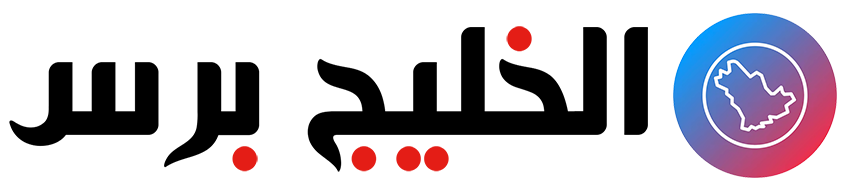عبد الله عيسى: الكلمة تواجه الطلقة والشعر الفلسطيني صوت المقاومة والهوية

يستحضر الشاعر عبد الله عيسى الفائز بجائزة فلسطين لعام 2024 في ديوانه “سماء غزة.. تلال جنين” المكان الغزي الذي يستيقظ على أهازيج الصيادين ونسمات بحرها المحملة برائحة الفيء، كما يصف “الغزيين” بصناع الفرح رغم الحصار والقتل والتجويع. يتقاسمون شريطًا ضيقًا ويتخذون من العزة والصمود والتحدي وضريبة الوطن عناوين بارزة.
للشاعر عدة دواوين منها “موتى يعدون الجنازة” و”حبر سماء أولى” و”حيث ظلال تئن” و”رعاة السماء رعاة الدفلى” و”أدنى من سماء” و”وصايا فوزية الحسن” ومؤلفات “قيامة الأسوار.. رؤيا في النص الجديد والكلمة والروح في الشعرية العربية” وأفلام وثائقية “الطريق إلى مكة” و”خارق الوقت” وسينمائية “اختبار الوقت” و”نحن نحب الحياة”.
وفاز الشاعر بجائزة الثقافة الإمبراطورية وهي أرفع جائزة لكتاب روسيا، أهداها للمبدعين الذين استشهدوا في حرب الإبادة في غزة وفي مقدمتهم الشاعر سليم النقار.
ويقدم الديوان 128 صفحة من القطع الصغير الصادر عن دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع في عمان تأريخا لمنطقتين تقودان النضال المسلح ضد المحتل الصهيوني باعتباره الطريق الصحيح للحرية. “حتى النوارس لا تموت من الشيخوخة” و”أصدق في المرآة أني ما زلت حيا” و”يوجعك أنين الورد في الحديقة بعد القصف” في إشارة واضحة لحرب الإبادة في غزة.
وبالنسبة لجنين فقد خص الشاعر مقاطع لحروف المدينة الأربعة التي عرفت بمقاومتها للاحتلال ففي قصيدة بعنوان “هناك جنين”:
جعلت شجرة لأسمائنا كلنا
كي نناديك يا أختنا كلنا
يشبهنا النهر لأن الغيم يتبعنا
عودي بنا إلى نبعك العالي أعالي الجبال
حتى نصدق أننا المجرى وأنا المصب
وعلى مدى 48 قصيدة، يوجه عبد الله عيسى رسائل مباشرة لأمتنا: “كلنا متورطون لأننا لم نفهم بعد أن البيوت التي تشتعل لن تنير غرفة نومنا المعتمة” و”أمهلوا غزة وقتا آخر كي تسمع أصوات قتلاها في أزقة المخيمات السمراء أو البيوت المعتمة تحت الأنفاق”. “أمهلوا غزة وقتًا إضافيًّا لتستعيد دمها من طاولة المفاوضات وتمشي على أرضها بقدمين عاريتين وعينين مفتوحتين على حجور مربي الأفاعي”.
وفي حوار “للجزيرة نت”، أكد عبد الله عيسى “الكلمة في مواجهة الطلقة” وحذر من مخططات لتدمير الثقافة الوطنية، ووجه صرخة لمن لم ينجدوا غزة واكتفوا ببيانات الإدانة.. وإلى التفاصيل:
-
في قراءة أولى لديوان “سماء غزة.. تلال جنين”، ثمة مؤاخاة أو توأمة نضالية بين غزة وجنين. ما الرسائل التي توحي بها للقارئ؟
ثمة دلالات عصية على التحايل عليها، فالمدينتان كنعانيتان بلا لبس ومن أقدم مدن الأرض المأهولة بسكانها الأصليين، ما يعزز تاريخهما في متن الرواية الفلسطينية. وكانتا تردان في مدونات وآثار وذاكرة الشعوب المجاورة أشبه بسورين يحميان المكان كله بما فيه من قداسات وحضارات.
كما أنهما، غزة وجنين، ملهمتان دائمًا ككل أخواتهما المدن الفلسطينية لفعل نضالي مبدع يحقق معادلة انتصار قوة الحق على حق القوة. وطالما أراد الاحتلال إيهام العالم بأن استفراده بغزة قتلا وتدميرا وحرب إبادة وجرائم حرب تحصينا -كما ادعى- لأمن دويلة الاحتلال، فإن عدوانه على جنين ومخيمها تأكيد على أن الحرب شاملة وستكون أشد وحشية على القدس الشريف وأكنافها. وهذا يجسد وحدة أرضنا المقدسة.
فأن يحقن المحتل سماء غزة بالطائرات والدخان والحرائق لن يغلق أبواب السماء، ولن يمنعنا من التدرب على مخادعة الموت كي لا يتنفس في ملامحنا. فلن يكون بمقدور هذا المحتل إعاقة دعوتنا لتلال جنين التي نطل منها على الأبدية إلى حلقة الرقص احتفالا بأن ثبتت الرؤيا في الحرية والعودة والاستقلال. فلا يمكن الفصل بين أي ذرة غبار فلسطينية وهواء فلسطين وسمائها ومائها وأسمائها.
-
خاطبت جنين: “يا أختنا كلنا.. عودي بنا إلى نبعك العالي أعالي الجبال”، هل تلمس دعوة صمود واستحضارا لتاريخ المدينة وقراها في مقارعة المحتلين منذ عام 1948 وحتى الآن؟
هي ذاتها عين الجنائن كما سميت قديمًا، وبتلالها تطل على مرج ابن عامر وتحمي أثر الفراشات في مراعيه وتصبح شجرة لأسمائنا ككل مدن فلسطين عبر التاريخ، كونها شجرة للحياة. لم يدرك قاتلونا أننا نفقد وطنا مع استشهاد أي منا كما نفقد أرواحنا كلما اجتث أشجارنا بفؤوسه العمياء أو جرافاته المدججة بالحقد المقدس.
وهكذا تغدو ككل مدينة فلسطينية شجرة أسمائنا كلها أو شجرة كل أسمائنا، ولهذا نناديها “يا أختنا كلنا” وندعوها لتصعد معنا أو بنا المنحدرات إلى نبعها فوق رؤوس التلال لندرك أننا نحن، الذين نحن “مجرد نحن”، المجرى والمصب.
وتجدد جنين خلق ذاتها أبدًا كي تفسد حياة المحتل طالما أنها الأدنى إلى مكان إقامته المؤقتة فوق أسرّتنا في بيوتنا القديمة، وهي التي مرّنته على مطاردة الخوف وإبعاد قلق وجودي ابتُلي به منذ عام 1948، وخاصة في عهد الانتفاضة الثانية.
-
توصف الكتابة بأنها رحلة جمال يضيء ولا يحترق، “جارة قوس قزح”، ماذا عن تجربتك الشعرية؟
في كل عمل إبداعي أتصدى له، أبحث فيه وربما معه أيضا عن جدوى ذاتي ومعنى وجودي شعرا ومسرحا وسردا وسينما وسوى ذلك. تتعمق جذور نفسي الفلسطينية في وطني فلسطين، فما الذي كان يمكن أن أنجزه من فعل إبداعي لو لم أكن فلسطينيا؟
أقصد، هل كان ثمة معنى لذلك طالما أنني بما أنجزت أقدم قضيتي الفلسطينية العادلة في مواجهة الآلة العدوة القتالة، “الجمال في مجابهة القبح”؟ ولأنك لا يمكن أن تصبح مبدعًا إلا إذا كنت معلما وتقدم بإبداعك قيما إنسانية تنقلها لقرائك، فإن نفسك الفلسطينية هي أم القيم، طالما أنك تحمل القيم السماوية والإنسانية كلها التي أنت وارثها من الأرض المقدسة.
وكيف لي أنا الفلسطيني، الذي أهديت البشرية القيم المقدسة أو قيم المقدس وعلّمتها على تقديس القيم السماوية، أن يعودوا بي مجددًا عضوا في العائلة الإنسانية وهي ذاتها التي غضت الطرف عن إبادتي وطالبت قاتلي بالإسراع في مهمته خشية أن تمس بألم لمشهد قتلي الموحش والفظيع؟ وعليك في مخيم لجوئك أن تكتب ذاكرة الوطن بأوصافه كاملة وأبطاله التراجيديين الذين سوف يشبهونك وأنت تكبر مع حلم العودة أو تؤرخ لها.
وفي منفاك عليك أن تحمي الذاكرة – الوطن من الوقوف طويلا في المطارات أو غرف التوقيف أو إشارات المرور في المدن الكبيرة، حتى لا تتأخر عن غدك الذي قد يعود بك إلى “الوطن – الذاكرة” أو “الوطن – الحلم”.
-
تضمن نص لك بعنوان “حين تداهمنا غزة”: نحن أشبه بشهود زور نتفرج على الدم المراق في أعيننا. وعلماء النفس يرون أن الفرجة موقف، فماذا ترى؟
انطلاقًا من الحديث النبوي الشريف: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”. ذهبنا إلى أضعف الإيمان منذ اللحظة الأولى. أما ألسنتنا فتأرجحت بين مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بما يجب القيام به وبيانات الإدانة محمرة الوجه من الخجل.
أما الفرجة التي تناولها علماء النفس، والتي تقترب من فعل الاكتفاء بالتفرج على الضحية النازفة المعذبة الوحيدة المستنجدة دون مساعدتها، فتتعلق بجملة من الآفات مثل النأي بالنفس عن تجليات فعل نجدة الضحية، والانكفاء على الذات في مدن كبرى تتزاحم فيها التموجات البشرية ونمو نزعة اللامبالاة بالغير.
وفي كل الأحوال، يجري فقدان الارتباط بـ”نحن” لمصلحة الارتداد إلى “أنا”. وكثيرًا ما يعود القاتل للتأكد من موت الضحية بتبريرات منطق القوة طالما لم يقم أحد بنجدتها. فهل كان يمكن أن تقام مآدب إبادتنا الجماعية في غزة لو لم تكن أرواحنا مصابة بكل هذا اليأس والعجز والوضاعة؟ “نحن لم نعد شهود زور فحسب، بل شياطين خرساء”.
-
الراحل محمود درويش يقول: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، وأنت تقول: “لا نموت كما الناس إلا لأننا نحب الحياة”. هل هذه مقاربة للعلاقة بين الأرض وثنائية الحياة والموت؟
يبقى سؤالا الحياة والموت أهم مشاغل المختبر الإبداعي منذ الطفولة الأولى للبشرية. ولأننا، ومنذ الجد الكنعاني الأول، كنا -وبشهادة المؤرخين والرواة- خالقي حياة لا صناع موت.
ومنذ بنى الملك اليبوسي الكنعاني ملكي صادق الذي سمي “كاهن الرب”، مدينة الله وسماها أورسالم أي مدينة السلام، والأراضي المقدسة مفتوحة لكل الأنبياء والأديان والإشعاعات الحضارية. وظلت كل الاحتلالات تتربص بها انطلاقا من نظرة “من يحكم أورساليم (القدس) يتحكم بالعالم”.
ولهذا فإن المحتل الذي لم يجل قدسية المكان والزمان الفلسطينيين المقدسين هو طارئ ومؤقت، طالما يناقض الروح القائمة على التسامح والتعايش والسلام التي شعت بها فلسطين وشعبها في أرجاء الأرض قاطبة والقلوب جمعاء.
وما ينبغي التأكيد عليه أننا لا نموت من أجل أن أرضنا محتلة فحسب، بل لكونها مقدسة. فنحن ندافع عن المقدس في ذات الإنسانية. ألسنا ورثة السيد المسيح عليه السلام؟ ولا نموت ككل الناس بل دفاعًا عن المقدس السماوي والإنساني، وضحايا حرب إبادة ومجازر ومقابر جماعية واغتيال وتصفية وتدمير واجتثاث واجتياح المقدسات من قبل احتلال هو الأطول والأكثر وحشية عبر التاريخ. وكأن الفلسطيني دريئة يتمرن عليها بالقتل الممنهج والأساسي.
لقد كتبت أواخر ثمانينيات القرن العشرين:
أنا لا أريد قيامة تطول/ وإنما حياة تليق بي/ أريد الذي يراد
أرضًا وبئرًا لا أموت لأجلها
ولكن عليها / لا سماء غطاء لنعشي/ أصدقاء بما لا أكتفي
لا عدوًا واحدًا/ نجمة الميعاد
لا درب آلام/ امرأة تصوغ في ماء أصلابي الطبيعة/ لا حورية لا أرى في جنة لا ترى
فمن حقنا أن نعيش على أرضنا ككل خلق الله، لا أن نموت من أجلها.
-
جاء في رسالتك لصديقك أبو أدونيس: “الكتابة تحت القصف ليست ترفا ولم تكن أعتى القصائد تخرج الشارع في تظاهرة”. فما دور القصيدة؟
الرحمة للشاعر أحمد يعقوب “أبي أدونيس” الرفيق والصديق في بيروت ودمشق. هكذا كنا نحن الشعراء الفلسطينيين نفكر في بيروت تحت القصف، أن الكتابة لا يمكن أن تكون فنا من أجل الفن وأن على الكلمة أن تكون معادلًا للطلقة في معركة المصير. لكن القصيدة التي جعلت من خروجنا من جنتنا – بيروت انتصارا، لا تزال تلوك مرارة الهزيمة. “تهزم القصيدة حين لا تمتلك مقومات انتصارها الفني الذي يتجدد دومًا”.
وطالما انشغل الشعراء بدور القصيدة ووظيفة الشاعر، فقد أكدوا بالمجمل على الفعالية الاجتماعية للقصيدة لا على فاعليتها الجمالية. وبقيت القصيدة الفلسطينية آنذاك تقدم ذاتها كفعل ثوري، تقوم بدورها المطلوب في تحفيز الهمم وشحن العواطف للتظاهر في عواصم عربية ضد اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجازر صبرا وشاتيلا.
وشخصيا، أرى أن القصيدة عملية خلق عالم إبداعي جديد بالضرورة وتقديم رؤيا جديدة للإنسان والعالم.
-
الغربة.. الاغتراب.. المنفى.. الحنين.. هل أغنت تجربتك الإبداعية؟
أن يبتسم لك القدر بأنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك قادر على خلق الحياة. فبمجرد ولادتك في مخيم تتسند حيطان بيوتاته على بعضها خشية الانهيار، ويتنازع أهله الحنين إلى الوطن المفقود الذي أورثوه لك لينمو معك كحلم العودة ذاته، عليك أن تظل تحن أيضًا إلى ذاكرات عجائز المخيم حيث يقطن وطنك المفقود ولهجتك الخصوصية كي لا تذوب في زحمة الأصوات الأخرى، وهويتك كاملة من غير سوء خشية أن تتهجّن وقد أرادوا لها ذلك مع الأخريات.
وعليك أن تحن لجسدك المهدد دائمًا بالتصفية في جريمة اغتيال أو اقتراف مجزرة، بعد أن أنهكه كل هذا الحنين في المطاردات وغرف التحقيق والتوقيف في المطارات والمدن الشقيقة والصديقة. وسوف تكتشف أنك الذي كنت غريبًا في مخيم أقيم لك في الشتات سوف تنشغل بالحنين إلى هذا المخيم في المنافي.
-
بعد ظهور وسائل الاتصال الجماهيري، قيل: يكثر الشعر النحيل الذي لا يرتقي بالذوق ولا يخدم قضية. ما رأيك؟
أعتقد أن الشعر الرديء نتاج أي زمن رديء. وانتشار الشعر بين العرب دومًا كان نتاج فكرة أن العرب أمة شاعرة تختص دون غيرها بالفصاحة والبلاغة، وهذا غير صحيح. وإبان انتشار قصيدة النثر التي ركب موجاتها كثيرون من أشباه الشعراء ودونهم، لا علاقة لهم بإيقاعات الشعر وتقاليده. “الشعر الرديء بقي في مقبرة الماضي كمن كتبوه”.
لكن الأكثر سوءًا من انتشار الشعر الرديء على وسائل التواصل الاجتماعي هو تقديم هذا اللاشعر وكتبته كنجوم “فاترينا” أو مثل نجوم شباك تذاكر في المهرجانات والمنابر لاعتبارات خاصة ورديئة أحيانًا.
وهنا أحذر من مخططات موضوعة بعناية لتدمير الثقافة الوطنية وتجلياتها الإبداعية، لا سيما الشعر. “الشعر الجيد سيبقى يتجدد في المستقبل وما دونه سيظل ماضيا شعريا لا صدى له”.
-
في مقولة مشهورة للدكتور إدوارد سعيد: “في العالم الثالث يقدر المثقف بمدى قدرته على التصفيق للنظام، بينما في الغرب بمدى قدرته على انتقاد النظام”. فماذا تقول لمن وصفوا بأبواق الأنظمة؟
علاقة السياسي بالثقافي في عالمنا العربي والمعاصر أيضًا هي بالضرورة علاقة تبعية المثقف للسياسي كما يراها الأخير. ففي العهود القديمة، فإن الشاعر لن يجد حظا له في الشهرة والغنى إلا إذا مدح أو أصبح بوقًا لسيد القبيلة أو الخليفة أو الأمير. وقلائل من الشعراء العرب الذين حققوا ذواتهم خارج بلاط الحاكم، والشعراء الأكثر انتشارًا هم أولئك الذين رهنوا أنفسهم بوقًا للبلاط الحاكم أو في جوقة مداحيه.
والأنكى أن شاعرا ما مدح طاغية دون أن يجتهد بالتفكير كيف ستنظر إليه وإلى شعره الأجيال المقبلة. فلو فكّر المتنبي قليلًا لَما مدح كافور، ولما مدح الجواهريُّ الأسدَ.
فالمثقف في الغرب يحوز على مكانة يستحقها بالقدر الذي يقدم نفسه صرخة إنسانية لا بوقًا للسياسي. فالمثقف بالضرورة انتصار للحق، والحق بلا محض لبس بعيد تمامًا عن قبة سادة العروش.
-
الشعر يطرح أسئلة لا أجوبة. بماذا ينشغل مشوارك الفني؟
الفن العظيم منشغل دائمًا بطرح أسئلة إبداعية تتعلق بحركته في عالم إبداعي تخلقه لغة ورؤية، ويتيح للمتلقي كشف أشياء وعناصر في هذا العالم الفني المقدم تتجسد فيها حركية عمليتي الإبداع والتلقي، وبهذا يصبح بمقدور القارئ إعادة كتابة النص الإبداعي.
إن قوة فعل التلقي والتأثير كامنة في مقدرة النص المبدع على جعل القضايا التي شكلت متن الرؤية أكثر عمقًا بما تحمله من إشعاعات ثقافات وحضارات وآلام وأحلام إنسانية. فكل نص مبدع وريث للطاقات الإنسانية جمعاء، تلك التي تتعمق وتتسع بالقدر الذي تتحرك بالأسئلة والقضايا الكبرى التي يتكثف فيها عالم الجمال والحب والحياة والموت والألم والأمل.
هذه عناوين انشغال تجربتي في مختبري الإبداعي، لهذا فإن أي حلول أو أجوبة أو لغة مبشرة بالتفاؤل والنصر المبين تقدمها قصيدة ما، هي أشبه بوصفات طبية يقدمها عطار.
-
الأدب الفلسطيني أدب منفى بعد 67 تغلب عليه نوستالجيا الحنين إلى الماضي؟
شكّل الحنين إلى الوطن مقترنا برفض الاحتلال والتأكيد على هوية الأرض والإنسان الفلسطينيين أهم عناوين القصيدة الفلسطينية بعد احتلال فلسطين عام 1948، كما تجسد في قصائد عبد الكريم الكرمي وهارون هاشم الرشيد وفدوى طوقان وسواهم من الرواد.
أما الشعر الفلسطيني بعد نكسة 1967 فقد اتخذ منحى آخر، حيث أسس شعراء الأرض المحتلة توفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش ما أطلقوا عليه “الشعر المقاوم” الذي أصّل لروح الصمود والمقاومة وثقافة البقاء على الأرض والقبض على الثابت الوطني، في الوقت الذي كان فيه الشعر العربي يهجو ذاته والعالم من حوله.
ولا بد أن هذا التيار أثر على شعر الشتات واللجوء وحركة الشعر العربي المعاصر، لا سيما أن الشعراء طالبوا كما تجلى في بيان درويش الشعري عام 1969 “أنقذونا من هذا الحب القاسي” بالتعاطي مع شعرهم على أسس فنية وليس أيديولوجية.
وبعد تجربة بيروت عام 1982، مست معمارية هذا الشعر وحركته الداخلية، وأخذ الشعر الفلسطيني يصب في مجرى آخر بعد العودة المجتزأة إلى الوطن المنقوص إثر اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث انقسم بشكل متعسف إلى شعر مقاوم تحت طائلة شعار “الثقافة مقاومة” وآخر تحت شعار “الإنساني الذات”، وفي أحيان كثيرة في مقابل العالم والنأي بالنص عن الهمّ العام تحت وطأة تصور ما أسموه “أنسنة الشعر”.