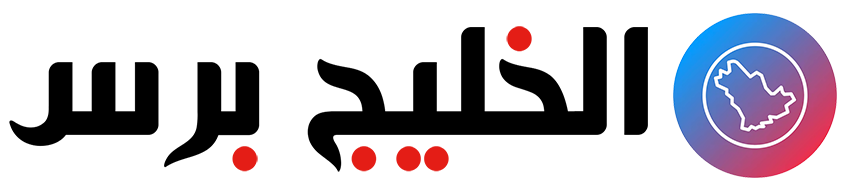الأدب وحروب الثقافة.. كيف يدافع فكر المقاومة عن القدس؟

تمتلك القدس –المدينة الأسيرة المحتلة- سحرها النادر الخاص، وتمتلك جاذبيتها وأسئلتها وتحدياتها، مستندة إلى رمزيتها المركبة، ووظيفتها الثقافية-الحضارية، وإلى “قدرها” المتكرر بوصفها مدينة الحرب والسلام معا. وبوصفها مطمحًا تطلّع إليه المحتلون وبنوا من أجله سردياتهم التي أسّست لاحتلالاتهم على مر التاريخ. إنها مدينة كنعانية عريقة القدم موغلة في التاريخ. وهي أيضا مدينة دينية، جلّلتها القداسة وارتبط بها الوجدان الإنساني كله.
وقد مثّلت قبلة أولى للمسلمين، كأنها الاتجاه المقدس الذي يتطلعون إليه لتجتمع فيه الأبصار والقلوب والنيات والآمال. ومثلت موقعا مؤثرا من خلال حضورها في حادثة “الإسراء والمعراج” بوصفها نقطة الرحيل إلى السماء. وباركها القرآن وما حولها في آية الإسراء “سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير” (الإسراء، الآية1).
وأما ارتباطها بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعهدته العمرية فمثلت دخولها في الإسلام صلحا، مع الاحتفاظ بطوابعها المسيحية وبحرّية كنائسها وعباداتها. ومذْ ذاك مثلت رمزا صادقا للتسامح والتآلف بين المسلمين والمسيحيين، وظل المسجد جارا للكنيسة يحيّي كل منهما الآخر كل يوم. إنها الزمان والمكان، التاريخ والجغرافيا، السماوي والأرضي، الحرية والانعتاق، الواقعي والمتخيل، الشعري والسردي، الممكن والمستحيل، الواضح والغامض. إنها مجمع الثنائيات وجوهر التقائها.. وهذا شيء من معنى القدس؛ إنها زمان ومكان معا، وشيء من معنى أنها موضع وموقع في آن.
المكان والزمان
وقد تنبه الأديب الراحل جبرا إبراهيم جبرا إلى بعض معاني القدس فكتب عام 1965 “مدينة القدس ليست مجرد مكان، إنها زمان أيضا. فهي لا يمكن أن ترى بوضوح ضمن نطاقها الجغرافي المحدود وحسب، لأنها حينئذ لن تفهم. إنها يجب أن ترى في منظورها التاريخي، وترى كأن التاريخ –تاريخ 4 آلاف من السنين-اجتمع في لحظة واحدة، هي اللحظة التي يراها المرء فيها. في هذه المدينة التاريخ حي، ينطق به كل حجر. إنه تاريخ مليء بالتناقض، مليء بالفجيعة. ولكنه أيضا تاريخ مدينة عشقتها البشرية جمعاء، لأنها لم تكن يوما مجرد مدينة مكانية من حجر وطين وتجارة وسياسية. لقد كانت دوما مدينة الحلم والتوق وتطلع النفس البشرية إلى الله. لقد وقفت شامخة على جبل، تنظر إلى البحر من جهة وإلى البادية من جهة أخرى. وبين جدرانها جمعت معاني البحر ومعاني البادية: قوتين حضاريتين في تفاعل أبدي. وفي هذا التفاعل سر مأساتها وسر عظمتها”.
وكتبت الباحثتان حذام قدورة وسهام ملكاوي عن شخصية القدس استنادا إلى مزيج من الرؤى من أبرزها رؤئ: جمال حمدان وعبد الوهاب المسيري وحسن فتحي لعل هذه الرؤى تعين في قراءة شخصية مدينة القدس التي تتجمع فيها تداخلات شتى وتفيض أو تزيد عن الأدوات المعهودة في قراءة المدن. وتنوه الباحثتان بقراءة جمال حمدان انطلاقا من ثنائية (الموضع والموقع). وتقول الباحثتان في ضوء ذلك “وتفلت المدن التي تمتلك مواضع خارقة من كل حتم جغرافي. ثمة أحداث ورؤى، معتقدات كانت أم خرافات، هي التي تحدد في نهاية المطاف انتخابها المكاني وفق عوامل عاطفية غير تعقلية؛ بمعنى أنها عوامل ميتافيزيقية. هي مدن لا تخضع للمنطق الجغرافي في نشأتها. أما مدينة القدس فهي تختلف عن غيرها من المدن الدينية التي تمتلك مواضع خارقة كمكة والمدينة. فانتخابها المكاني يتحدد وفقا لنقطة ما مقدسة في المدينة….وإذا كانت فلسطين في قلب عالم العرب، فإن القدس هي قلب فلسطين. وهنا يتقاطع الموقع مع الموضع لتتحدد شخصية المدينة. فللمدينة موقع فعال يحمل مغزى ودلالة بشرية ومدنية….ولتكون القدس مدينة موضعٍ وموقع معا”.
في عهدها القريب تعرضت القدس للاحتلال، الذي قلب حياتها وهدد وجودها، ولم يكتف الاحتلال البغيض بما يقوم به على الأرض فعليا، وإنما امتد الصراع إلى ذاكرة القدس وتاريخها وهويتها وثقافتها، فجرت عملية تزوير واسعة النطاق قادها الأدب والفكر الصهيوني وروج لها ترويجا واسعا من خلال علم آثار مزور ومن خلال سرديات أسطورية يجري تحويلها قسرا إلى واقع على الأرض، ومن خلال أشعار وروايات وسير وقصص ورسومات وفنون وأشكال “ثقافية” كثيرة يجري دعمها وترويجها تماما كما يدعم جيش الاحتلال. ولا نريد أن نتحدث عن صورة القدس في الثقافة الصهيونية فلهذا الموضوع مظانه ومتخصصوه ولكننا نلمّح إليه لنشير أن الصراع اللغوي والثقافي هو قسيم أساسي في معركة القدس وفي مواجهة الاحتلال.
وما تزال محاولات الاحتلال مستمرة في إيذاء المدينة والاعتداء عليها وتزوير حقيقتها، وهو لا يكتفي بتهويد المدينة والإمعان في اتخاذ خطوات تدريجية متسارعة في هذا السبيل، وإنما يقوم بذلك مترافقا مع احتلال تاريخها وثقافتها وسرقة هويتها، ويتم ذلك بأدوات لغوية وتاريخية وفكرية تشارك في الحرب على القدس. لقد منحت جائزة نوبل عام 1966 لأديب صهيوني (هو يوسف عجنون) الذي هاجر إلى القدس ضمن موجات الهجرة اليهودية عام 1924، وقبل سنوات غير بعيدة تصدّى عدد من حملة الثقافة الصهيونية للتحقق من صدق الصور التي نشرها إدوارد سعيد في سيرته (خارج المكان) وفزعوا من تأثير الصور وذكريات إدوارد عن قدسه وبيت طفولته في حي الطالبية المقدسي، فمضوا يثيرون الريبة فيها وفي صدقها بزعم أن سعيدًا لا صلة له بالقدس وليس له بيت وصور فيها.
حرب ثقافية
تدور المعركة الثقافية حول القدس بأسلحة متعددة خطرة، وهي مرافقة وموازية لما يدور على الأرض من حرب غير متكافئة تتفوق فيها الآلة العسكرية الظالمة على المدينة المقدسة العزلاء، وعلى حراسها القليلين الصامدين. ولكن أين نحن في هذه المعركة؟ أية ثقافة أقوى وأشد رسوخا؟ وهل يمكن أيضا أن ننهزم ثقافيا وفكريا امتدادا لهزيمتنا العسكرية والسياسية؟ ومن يدير تلك المعركة؟ هل هي معركة المقدسيين وحدهم؟ أم هي معركة الفلسطينيين منفردين؟ أم هي معركة تخص الأمة العربية والإسلامية أيضا؟ هل هذه استفسارات سياسية أم ثقافية وهل تنفصل الثقافة عن السياسة وعن الحرب الدائرة على كل شبر ومعلم ولون وخط وحرف وحجر وحبة رمل في القدس؟!
تمتلك الثقافة العربية في مسألة القدس فرصا لا حصر لها للمقاومة التي تفضي إلى تحقيق إنجازات كثيرة تُبقي الطريق مفتوحا للحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة، وتعيق ما يمارسه الاحتلال من محو وتهويد مستمرين، تمتلك الثقافة فرصا لتخوض معركتها بروح جديدة فتجدد مراحل من المقاومة الثقافية التي لم تتوقف. ولسنا نقصد ثقافة بكائية مهما تكن الغنائية مطلوبة أو قريبة من الروح. لا نريد لوتر الغناء الذي يسيطر على وعينا وصوتنا الشعري منذ القديم أن يتسيّد التعبير عن القدس كي لا تتحول القدس إلى أطلال جديدة نبكيها، ولا لتصير أندلُسا جديدة نوظفها في بكائياتنا…فالقدس ليست الأندلس وليست أي مكان حل فيه العرب والمسلمون ثم رحلوا.. ليست القدس مكانا قابلا للاستبدال أو للنسيان أو التنازل…إنها هوية جمعية بكل معنى.. مقدسيًا وفلسطينيا وعربيا. وبهذا الوعي نريد للثقافة أن تتعامل معها؛ بوصفها القدس الصامدة المقاومة، ولا نريد أن نجدد رثاء المدن، فالقدس حية مستقلة حرة كما يريد لها الضمير الثقافي الجمعي.
وحين نفكر في علاقة القدس بالثقافة من جهة، وفي دور الثقافة في خدمة القدس لا بأس أن نستعيد مفهوم الثقافة، ونقربها من معنى “الهوية” أي ما يطبع الجماعة بطابعه وما يجعل كل فرد من تلك الجماعة منتميا بدرجة ما إلى تلك الهوية. أما المبدعون أو المنتجون في مثل هذا الحال فهم لسان حال الجماعة، وسبيلها لتعريف نفسها والدفاع عن ذاتها، ومقاومة ما تتعرض له من محاولات “المحو” وإلغاء الهوية أو تضبيبها وإخفاء معالمها.
وفي ضوء ذلك يتحمل المثقف دورا مضاعفا، إذ مهما تكن صورة الواقع مهزومة وسيئة وقبيحة ومهما تكن معاناته الشخصية كإنسان يعيش ذلك الواقع فإن ما يميزه عن غيره إن كان مثقفا بالمعنى الجوهري إيمانه بدوره ورؤيته لجوهر الصراع الذي لا يتوقف عند مرحلة أو حدث أو معركة من المعارك. ولذلك فمع أهمية تقديم الصورة الراهنة أو الواقعية فإن عليه أن يقدم الصورة المأمولة ويقدم بريق الأمل لا ليكذب على مجتمعه، وإنما لأنه يرى حقا أطياف الأمل وبذور الانتصار وهي تولد من وسط الخراب. يراها في التاريخ ويقرأ استمرارها وحضورها. الأدب يقرأ الواقع ويعايش الهزائم ويصورها ويسجلها ولكنه أيضا يقدم في قراءته تلك الرؤية التي تتجاوز الواقع وقواعده وظروفه ليتجاوز كل ذلك مستندا إلى قوة الثقافة وقوة الحق، وإلى مسؤوليته الأخلاقية والجمالية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، بل سيدة المدائن وزهرتها بكل معنى.
للقدس أسماؤها، كل معلم منها مسمّى، ويختزن الاسم تاريخا وهوية-هويات..للمدينة أسماء، ولبواباتها أسماء، للأحياء أسماء، الشوارع، المساجد والأماكن الدينية، ولذلك يقوم الاحتلال بتهويد الأسماء في القدس، ويسارع إلى تبديلها وعَبْرَنتِها في صورة احتلال لغوي لا يخفى، ومعلوم أن التطور اللغوي الطبيعي في الأسماء وغيرها شيء مختلف تماما عن صور الاحتلال اللغوي والمحو العدواني الذي يقصد منه إخفاء الحقيقة. وإذا كانت الأجيال السابقة والمعاصرة تعرف الأسماء العربية وتستعملها فإن الأمر خطير في المرحلة القريبة القادمة، فللاسم سلطة الاستعمال وقوته، وينبغي مواجهة هذه الظاهرة اللغوية وتتبع ما جرى تغييره من أسماء بكل السبل، للمحافظة على قسم أصيل من هوية المدينة مما يختبئ في الأسماء وما يعكسه كل اسم من ذاكرة ثقافية تُضحي مفردة مقاومة بمجرد بقاء الاسم واستمرار حياته.
الأدب العربي
وحين ننظر في الأدب العربي الفلسطيني والعربي الحديث نجد جهودا جديرة بالتقدير والاهتمام تطوع أدباء وفنانون لتقديمها. ولكنها تظل جهودا غير منظّمة وغير مدعومة وفردية في معظم الأحيان. ولم يتشكل تيار فكري أدبي فني يتخصص في القدس ويجعل منها معركته الأساسية وهي بلا شك تمتلك مواصفات المكان الممتد الذي يتسع لكل حاجات الأدب والفن والفكر. ولقد لعب البعد عن المكان وعدم إمكانية التفاعل معه مباشرة دورا في صعوبة الكتابة عن القدس، فمعايشة المكان ولو مؤقتا تبدو مقدمة مهمة للكتابة عنه بالمعنى الإبداعي.
تحتاج ثقافة القدس واستمرار حضورها إلى مناهج دقيقة في التوثيق، أي تنظيم توثيق تراث القدس بكل تجلياته الدينية والمعمارية والشعبية والاجتماعية. فالقدس مهددة فعلا ولا مجال للتغاضي عن ذلك. ولا بد من توفير صورة دقيقة مفصلة عن كل وجه من وجوه القدس وثقافتها بكل أمانة وبكل الوسائل التوثيقية الممكنة، بالتصميم المعماري والتصميم الفني بالتصوير والنحت والكتابة باستخدام الحاسوب ووسائل التوثيق الإلكتروني.
كما تتطلب الثقافة المقدسية الحفاظ على “أرشيف” القدس بوصفها متحفا واسعا، ومدينة إسلامية وعالمية، ولا بد من تشجيع التأليف والبحث العلمي بحيث يتاح له إخضاع المادة المقدسية الموثقة للدراسة والبحث في مختلف المجالات التي تتصل بها تلك الجوانب. ولا بد من تشجيع الدراسات الأكاديمية والعلمية في مختلف المجالات: التاريخ والجغرافيا والآثار والدراسات الإنسانية والثقافية بعامة، لإنتاج دراسات جديدة بمناهج مستحدثة ترتفع إلى مستوى الصراع ومسؤوليته. وفي هذا السياق لا بد من الاهتمام بتحقيق المخطوطات والوثائق المقدسية وحفظها بالوسائل الحديثة، ودراسة أعلام القدس في المجالات الثقافية والعلمية والفنية.
وأما الإبداع الأدبي والفني فيقتضي تشجيع المبدعين الفلسطينيين والعرب للتفاعل مع القدس لإبداع أعمال جديدة تستوحي المدينة المقدسة. والأمر نفسه ينسحب على مجال الفنون؛ لا بد من التركيز على القدس في مختلف أشكال الفنون: الرسم والموسيقى والغناء والمسرح والدراما والأفلام؛ لما للفن من تأثير جماهيري متزايد. والعمل على دعم الفن الملتزم بعامة والفنون المرتبطة بالقدس على وجه الخصوص.
لقد كانت القدس حاضرة علمية وثقافية وفيها مكتبات مشهورة عامة وشخصية. فيها كُتُب ومخطوطات. ولقد تعرض أكثرها للسرقة والنهب. وبعضها توزع هنا وهناك في أماكن ومكتبات خارج فلسطين. فهل من سبيل لجمع هذه المكتبات والمطالبة بما تبقى منها، والمحافظة على ما يمكن جمعه والوصول إليه؟ ولا بد من بناء مكتبات للقدس تشمل مصادرها ووثائقها ويشمل ذلك بناء قواعد معلومات وبيانات وفق قواعد علمية حديثة.
وفي مجال اللغة والمعاجم، لا بد من الاهتمام بالدراسات اللغوية سواء التي تدرس اللهجة-اللهجات في القدس ومحيطها، والدراسات التي تدرس اللغة المعاصرة وأية تغييرات أو مخاطر عليها بتأثير العبرنة والتهويد فثم احتلال لغوي قادم وممارس. وفي مجال المعاجم نحن محتاجون إلى معجم شامل للثقافة المقدسية يضم المفردات والمصطلحات ذات الصلة لحصرها وبيان أصولها ونقدها لتسهيل إيصال المعلومات حول القدس وتعميق ثقافتها ونشرها.
ما مضى يؤدي بنا إلى نتيجة واضحة، فالقدس ليست شعارا سياسيا آنيا، وإنما هي عاصمة من عواصم ثقافتنا العربية والإسلامية المشتركة، وهي تنتظر من كل مثقف وكاتب وإعلامي أن ينهض بدور من الأدوار في الدفاع عنها، وفي إبقاء معالمها المادية والمعنوية خالدة باقية، حتى تحين لحظة التحرير والخلاص من الاحتلال الصهيوني الذي لا يخامرنا الشك في انتهائه واقتلاعه، فليس هو أول احتلال ولا أول غارة على المدينة المقدسة، ولقد صمدت القدس دوما أمام المحتلين واحتفظت دوما بهويتها وطوابعها، وهي ماضية اليوم في صمودها بانتظار اقتلاع هذا الاحتلال الأخير.
- الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.